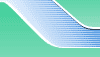(الصفحة221)
20 ـ العبد ، وقد ورد النهي عن الائتمام به مطلقاً أو بالنسبة إلى الأحرار فقط(1) .
21 ـ الصبي ، والأخبار الواردة فيه مختلفة ، حيث إنّ بعضها يدلّ على النهي عن الائتمام به مطلقاً ، وبعضها على جواز إمامته كذلك ، وبعضها على الجواز فيما إذا بلغ عشر سنين(2) .
22 ـ المتيمّم ، وقد ورد النهي عن الائتمام به لخصوص المتوضّئين، أو مطلقاً ، لكنّ الأقوى الجواز كما سيأتي(3) .
23 ـ الجالس ، وقد ورد النهي عن إمامته للقائمين ، لكنّ الأقوى الجواز كما سيمرّ عليك(4) .
24 ـ المسافر ، حيث إنّه نهي عن إمامته للحاضر المقيم ، والظاهر كون النهي تنزيهيّاً(5) .
25 ـ الأعمى ، والأخبار الواردة فيه مختلفة من حيث دلالة بعضها على النهي والبعض الآخر على الكراهة(6) .
26 ـ الخصي، والأخبار فيه مختلفة أيضاً كسابقه .
27 ـ الأمّي بالقارىء ، وكذا من يلحن في قرائته كالتمتام ونحوه .
28 ـ المرتد(7) .
(1) الوسائل 8 : 325 . أبواب صلاة الجماعة ب16 .
(2) الوسائل 8 : 321 ـ 323 . أبواب صلاة الجماعة ب14 .
(3) الوسائل 8 : 328 . أبواب صلاة الجماعة ب17 ح5 ـ 7 وص340 ب22 ح1 .
(4) الوسائل 8 : 345 . أبواب صلاة الجماعة ب25 ح1 .
(5) الوسائل 8 : 330 . أبواب صلاة الجماعة ب18 ح6 .
(6) الوسائل 8 : 338 ـ 339 . أبواب صلاة الجماعة ب21 ح2 و4 و7 .
(7) الوسائل 8 : 322 . أبواب صلاة الجماعة ب14 ح6 .
(الصفحة222)
29 ـ شارب الخمر أو النبيذ ، وهو من أفراد الفاسق(1) .
30 ـ الغالي(2) .
وهنا عناوين اُخر مذكورة في بعض الروايات أيضاً كالمجبرة ، والواقفة على موسى بن جعفر(عليهما السلام) ، وكذا الواقفة على الرضا(عليه السلام) ، والمجهول ، ومن يشهد عليك بالكفر ، ومن شهد عليه بالكفر ، ورجل يكذب بقدر الله عزّوجلّ ، ومن قال بالجسم ، ومن يقول بقول يونس ، ومن يزعم أنّ الله يكلّف عباده على ما لا يطيقون ، ومن يمسح على الخفّين ، وقد أورد الروايات الواردة في هذا الباب في الوسائل في أبواب كثيرة من أبواب صلاة الجماعة ربّما تبلغ أربعة عشر باباً(3) .
ولا يخفى أنّ جملة ممّا ورد فيه النهي ورد فيه التجويز أيضاً ، كالمجذوم والأبرص والعبد والصبي والأعمى والمرأة والمسافر والمتيمّم ، وجملة اُخرى لم يرد فيها الجواز . وهم ـ أي جميع من ورد النهي عن إمامته ـ بين من لا يجوز الائتمام به بلا إشكال ، لأجل الاختلاف في أصول المذهب ، أو لأجل كونه فاسقاً مع اعتبار العدالة كما سيأتي ، وبين من ورد النهي عن إمامته مع عدم المخالفة في شيء من الاُصول وعدم اتّصافه بالفسق أيضاً ، كولد الزنا والصبي والعبد والمرأة والمتيمّم والمسافر وغيرهم .
لكن قد عرفت أنّ المرأة يجوز لها الإمامة لطائفة النساء ، والمتيمّم يجوز له إمامة المتوضّئ ، والنهي عن الائتمام بالعبد يمكن أن يكون لأجل كونه ثقيلا على
(1) الوسائل 8 : 316 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح11 وص322 ب14 ح6 .
(2) الوسائل 8 : 310 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح6 .
(3) الوسائل 8 : 309 ـ 351 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ـ 28 .
(الصفحة223)
الناس، وكذا الصبي .
نعم، لا محيص عن الالتزام بعدم جواز الائتمام بولد الزنا من حيث ورود النهي فيه، وبعدم دلالة على الجواز في البين .
(الصفحة224)
اعتبار العدالة في إمام الجماعة وبيان مفهومها
المهمّ في هذا الباب التكلّم في اشتراط العدالة في الإمام وبيان مفهومها والأمارة عليها ، فنقول:
يظهر منهم اعتبار العدالة في موارد:
منها: الإمام في باب صلاة الجماعة .
ومنها: الشاهد الذي يعتبر قوله في باب القضاء ، وهذان الموردان قد ورد فيهما النصوص أو ما يكشف عنها(1) .
ومنها: المفتي الذي يرجع إليه المقلّد في أخذ الحكم .
ومنها: أصناف مستحقيّ الزكاة على ما ذكر بعضهم(2) وغير ذلك(3) .
(1) الغنية : 87; شرائع الإسلام 1: 114; المعتبر 2: 433; الخلاف 1: 560 مسألة 310; تذكرة الفقهاء 4: 280 مسألة 564; مستند الشيعة 8: 26; جواهر الكلام 13 : 275 ; الوسائل 8: 313 . أبواب صلاة الجماعة ب11 وج27 : 391 ب41 .
(2) المبسوط 1 : 247; الخلاف 4 : 224; الكافي في الفقه: 172; الوسيلة: 129; الغنية: 124; السرائر 1: 459 .
(3) منها : الشاهدين في الطلاق; ومنها: القاضي; راجع شرائع الإسلام 2: 12; جواهر الكلام 32: 109; مسالك الأفهام 9: 113; الروضة البهية 6: 131; الوسائل 27: 11 . أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ب1 .
(الصفحة225)
أمّا اعتبار العدالة في باب صلاة الجماعة ، فهو من متفردات علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين ، نعم حكي عن السيّد المرتضى(رحمه الله) إنّه حكى عن أبي عبدالله البصري أنّه وافق الإمامية وقال باشتراط العدالة(1) ، وحكي عن الشافعي أنّه كره الصلاة خلف الفاسق(2) .
وكيف كان، فأصل اعتبارها في إمام الجماعة ممّا لا شكّ فيه عندنا ، وإنّما المهمّ بيان معناها ومفهومها بحسب الاصطلاح ، فنقول:
العدالة لغة بمعنى الاستقامة وعدم الانحراف(3) ، ويقابلها الفسق ، فإنّه بمعنى الميل والانحراف بقرينة المقابلة ، وأمّا اصطلاحاً فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاث:
الأول: أنّ المراد بها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، يظهر ذلك من ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ، وكذا في المبسوط في باب الشهادات ، حيث قال في الثاني: العدالة في الدين أن يكون مسلماً ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وحكي هذا القول عن غيره من بعض القدماء أيضاً(4) .
الثاني: أنّ المراد بها معنى أخصّ من المعنى الأول وهو حسن الظاهر ، ومرجعه إلى كونه في الظاهر يعدّ رجلا صالحاً(5) .
الثالث: أنّ المراد بها ملكة نفسانية راسخة في النفس باعثة على ملازمة التقوى بحيث يتعسّر معها ارتكاب الكبيرة ، وكذا الإصرار على الصغيرة أو عليها
(1) نقله عنه في الخلاف 1: 560 مسألة 310; ولكن لم نجده في الإنتصار والناصريات والجمل .
(2) الأمّ 1: 166; المجموع 4 : 253; تذكرة الفقهاء 4 : 280 مسألة 564 .
(3) مقاييس اللغة 4 : 246 .
(4) الخلاف 6: 218; ونقله عن ابن الجنيد في مختلف الشعية 3: 88 ، المبسوط 8: 217; السرائر 2: 117; الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 25 .
(5) المقنعة : 725 ; النهاية : 105 ; المهذّب 2 : 556; الوسيلة: 230; الكافي في الفقه: 434; الذكرى 4: 389 .
(الصفحة226)
وعلى المروءة أيضاً ، وهذا المعنى هو المشهور بين المتأخّرين(1) .
ولا يخفى أنّ المعنيين الأوّلين ليسا بمعنى العدالة ، لأنّها من الأوصاف الواقعية والفضائل النفس الأمرية ، ومجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر ، لا يوجب أن يكون الشخص متّصفاً بهذه الصفة واقعاً ، فإنّه يمكن أن يكون في الواقع فاسقاً .
غاية الأمر إنّه لم يظهر فسقه بل كان ظاهره حسناً ، فلابدّ أن يقال: بأنّ مراد من فسّر العدالة بأحد هذين المعنيين ليس هو تفسير العدالة وبيان معناها ، بل مراده أنّ ما يترتّب عليه الأثر من الأحكام المترتّبة على العدالة هو هذا المعنى .
والدليل عليه أنّ الشيخ في الخلاف بعدما تمسّك لمذهبه في قبال الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ـ وهو عدم وجوب البحث عن الشاهد الذي عرف إسلامه ولم يعرف جرحه بإجماع الفرقة وأخبارهم ـ قال: وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة ، والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل ، وأيضاً نحن نعلم أنّه ما كان البحث في أيّام النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، ولا أيّام الصحابة ، ولا أيّام التابعين ، وإنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبدالله القاضي . . .(2) .
فإنّ تمسكه بالأصل وكذا بعدم ثبوت البحث في تلك الأيّام ظاهر في أنه ليس مراده من ذلك تفسير حقيقة العدالة وبيان معناها ، بل المراد بيان ما يكفي في حكم الحاكم بشهادة الشاهدين ، وأنّه هو معروفية إسلامهما وعدم معروفية جرحهما كما لا يخفى .
وأمّا المعنى الثالث فهو وإن لم تكن تجري فيه هذه المناقشة ، إلاّ أنّ اعتبار
(1) مختلف الشيعة 8 : 484 ; إرشاد الأذهان 2: 156 ; الدروس 2: 125 ; الروضة البهية 3: 128; مدارك الأحكام 4: 66; رياض المسائل 4 : 329; العروة الوثقى 1 : 630 مسألة 12 .
(2) الخلاف 6: 217 ـ 218 مسألة 10 .
(الصفحة227)
العدالة بهذا المعنى مشكل جدّاً ، ضرورة أنّ تحصّل الملكة الكذائية الباعثة على ملازمة التقوى أو مع المروّة في غاية الندرة ، لأنّ هذه الملكة حينئذ تصير من المراتب التالية للعصمة .
غاية الأمر أنّ العصمة عبارة عن الملكة التي تحصل للنفوس الشريفة ويمتنع معها صدور المعصية ، وأمّا ملكة العدالة فلا يمتنع معها صدور المعصية ، بل يمكن أن تصدر، ولكن يتعسّر ويصعب صدورها .
وبالجملة: فاعتبار العدالة بهذا المعنى ممّا لا سبيل إليه بعد ندرة تحققها وكثرة الأحكام التي يترتّب عليها .
ثمّ إنّ استعمال كلمة العدالة لا ينحصر بالفقهاء ، بل يستعملونها علماء الأخلاق أيضاً ، حيث قسّموا ذلك العلم إلى قوّتين: «علميّة وعمليّة» ، والعملية لها قوّتان: شهوة وغضب ، وكلّ منهما إمّا أن تكون بحدّ الإفراط ، أو بحدّ التفريط ، أو على التوسّط ، فالمتوسّط من كلّ منهما هو العدالة ، وكذا القوّة العلميّة ، وهذا الذي ذكروه في مورد العدالة قد ينطبق على موردها بحسب اصطلاح الفقهاء ، وقد يتخلّف عنه كما هو غير خفيّ .
ثمّ إنّ الكتاب العزيز قد استعملت فيه هذه اللفظة ومقابلها في موارد:
منها: قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}(1) .
ومنها: قوله تعالى: {إن جاءَكم فاسق بنبأ فتبيّنوا}(2) .
ومنها: قوله تعالى: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل}(3) .
(1) الطلاق: 2 .
(2) الحجرات: 6 .
(3) البقرة: 282 .
(الصفحة228)
ومنها: قوله تعالى: {حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم}(1) وقد اُشير إليه في قوله تعالى: {ممّن ترضون من الشهداء}(2) .
وكيف كان، فاعتبار العدالة بالمعنى الثالث في غاية الإشكال ، وعباراتهم قاصرة عن إفادة كونها نفس الملكة الكذائية ، فإنّهم متّفقون ظاهراً على أنّ العادل لو صدرت منه معصية لم يترتّب عليه حينئذ الأحكام المترتّبة على عدالته ، فلا يجوز الاقتداء به حينئذ ، ولا تقبل شهادته أيضاً .
نعم، لو تاب ورجع عنها يرجع إلى ما كان عليه قبل صدور تلك المعصية من جواز ترتيب أحكام العدالة عليه ، مع أنّه لو كانت حقيقة العدالة نفس تلك الحالة والهيئة الراسخة والملكة النفسانية ، فإمّا أن لا تزول بمجرّد صدور معصية واحدة فيجوز الاقتداء به قبل التوبة عنها أيضاً ، وإمّا أن لا تعود بمجرّد التوبة فلا يجوز الاقتداء به بعدها أيضاً ، اللّهم إلاّ أن يكون مرادهم أنّ العدالة هي الملكة الكذائية مع عدم صدور المعصية عنه خارجاً ، فتأمّل .
وكيف كان فلابدّ في هذا المقام من ملاحظة الأخبار الواردة فيه ، وهي كثيرة:
حول صحيحة عبدالله بن أبي يعفور
صحيحة عبدالله بن أبي يعفور التي رواها الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب وهي العمدة في هذا الباب .
أمّا الصدوق(رحمه الله) فقد روى في الفقيه باسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم
(1) المائدة : 106 .
(2) البقرة : 282 .
(الصفحة229)
وعليهم؟ فقال: «أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه ، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة ، فإذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلاّ خيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه ، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين .
وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزّوجلّ ومن رسوله(صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة» .
وأمّا الشيخ فقد رواها بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد ابن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، مثل ما روى الصدوق(رحمه الله) ، إلاّ أنّه أسقط ـ على ما
(الصفحة230)
حكاه في الوسائل ـ قوله: «فإذا كان كذلك لازماً لمصلاّه» ـ إلى قوله: ـ «ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع» ، وأسقط قوله : «فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق» ـ إلى قوله: ـ «بين المسلمين» .
وزاد: وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ، ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره ، وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين ، وإلاّ أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته بينهم»(1) .
والكلام في هذا الخبر يقع في مقامين:
المقام الأول: في سنده ، وقد حكي عن العلاّمة الطباطبائي(رحمه الله) أنّه حكم بصحّة هذه الرواية ، حيث قال في محكيّ ما صنّفه في مناسك الحجّ: الصحيح عندنا في الكبائر أنّها المعاصي التي أوجب الله تعالى سبحانه عليها النار ، وقد ورد تفسيرها بذلك في كثير من الأخبار المروية عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ، نحو صحيحة عبدالله بن أبي يعفور الواردة في صفة العدل . . . .
لكن في مفتاح الكرامة بعد نقل هذه العبارة قال: قلت: الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في الفقيه(2) ، انتهى .
والظاهر أنّ منشأ الإشكال في الصحّة هو اشتمال السند على أحمد بن محمد بن يحيى ، حيث لم يقع عنه ذكر في الكتب المصنّفة في الرجال حتّى يعدل أو يجرح ، مع انّ التحقيق يقضي بعدم الاحتياج إليه .
(1) الفقيه 3 : 24 ح65 ; التهذيب 6: 241 ح 596; الاستبصار 3: 12 ح 33; الوسائل 27: 391 ـ 392 . كتاب الشهادات ب41 ح1 و 2 .
(2) مفتاح الكرامة 3 : 91 .
(الصفحة231)
توضيح ذلك ، إنّ الكتب الموضوعة في هذا الباب لا تتجاوز عن عدّة كتب ككتاب رجال الشيخ ، ورجال الكشي ، وفهرست النجاشي ، وعدم التعرّض فيها لراو لا يوجب عدم الاعتناء بروايته ، لأنّ كتاب رجال الشيخ لا يكون مشتملا على جميع الرواة ، لأنّ الظاهر أنّه كان بصورة المسودّة ، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانياً لنظمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه ، كما يشهد لذلك الاقتصار في بعض الرواة على ذكر مجرّد إسمه وإسم أبيه من دون تعرّض لبيان حاله من حيث الوثاقة وغيرها ، وكذا ذكر بعض الرواة مكرّراً كما يتّفق فيه كثيراً على ما تتبّعنا .
فهذا وأمثاله ممّا يوجب الظنّ الغالب بكون الكتاب لم يبلغ إلى حدّ النظم والترتيب والخروج بصورة الكتاب ، وذلك كان مستنداً إلى كثرة اشتغال الشيخ بالتأليف والتصنيف في الفنون المختلفة الإسلاميّة من الفقه والأصول وجمع الأحاديث والتفسير والكلام ، وغير ذلك من العلوم ، بحيث لو قسّمت مدّة حياته على تأليفاته لا يقع في مقابل كتابه هذا إلاّ ساعات معيّنة محدودة(1) .
وكيف كان، فعدم الذكر في رجال الشيخ لا يدلّ على عدم الوثاقة .
وأمّا كتاب رجال الكشي ، فالظاهر كما يظهر لمن راجع إليه أنّه كان غرضه منها جمع الأشخاص الذين ورد في حقّهم رواية أو روايات مدحاً أو قدحاً أو غيرهما .
وأمّا كتاب النجاشي فغرضه فيه إيراد المصنّفين ومن برز منه تأليف أو
(1) وإن شئت تحقيق أحواله وصورة مصنّفاته وعدد مشايخه وتلاميذه وغير ذلك ممّا يتعلّق به ، فارجع إلى ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ (أدام الله أظلاله على رؤوس المسلمين) ممّا علّقه على كتابي التهذيب والاستبصار في تنقيح أسانيدهما ، وقد ذكرت خلاصة ما هناك في مقدّمة كتاب الخلاف الذي طبع «لأوّل مرّة» بأمره واهتمام منه في جمع متفرّقاته . «المقرّر» . مقدّمة الخلاف 1 من ص : الف ـ د .
(الصفحة232)
تصنيف ، وهكذا فهرست الشيخ(قدس سره) .
فعدم تعرّضه لبعض من الرواة باعتبار عدم كونه مصنّفاً لا يدلّ على عدم كونه ثقة عنده ، كما يظهر من بعض المتأخّرين في مشتركاته(1) ، حيث اعتمد في عدم وثاقة الراوي على مجرّد عدم كونه مذكوراً في تلك الكتب ، مع أنّ الظاهر أنّه يمكن استكشاف وثاقة الراوي من تلاميذه الذين أخذوا الحديث عنه ، فإذا كان الآخذ مثل الشيخ أو المفيد أو الصدوق أو غيرهم من الأعلام خصوصاً مع كثرة الرواية عنه لا يبقى ارتياب في وثاقته أصلا .
وحينئذ ينقدح صحة ما أفاده العلاّمة الطباطبائي من الحكم بصحّة هذه الرواية وإن كان أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في ابتداء سند الرواية لم يقع عنه في تلك الكتب ذكر ولا تعرّض ، لأنّ وثاقته تستفاد من رواية الصدوق والشيخ عنه خصوصاً مع كثرة رواياته ، حيث إنّه كان رواية كتب أبيه بإجازة منه ، وإن لم يكن له كتاب ، ولأجله لم يذكر في شيء من تلك الكتب ، فالإنصاف أنّه لا مجال للمناقشة في مثل هذا السند أصلا ، فافهم واغتنم .
المقام الثاني: في دلالة الرواية ، ونقول: الظاهر أنّ السؤال فيها إنّما هو عن حقيقة العدالة وما هو المراد منها في لسان الشرع ، وإن كان ظاهر عبارته يعطي أنّ السؤال إنّما هو عن الأمارة المعرّفة لها بعد العلم بحقيقتها ، وأنّها هي الملكة النفسانية الكذائية .
وذلك لأنّ لفظ العدالة وكذا الفسق وإن كان مستعملا كثيراً في صدر الإسلام وفي عصر نزول القرآن بل قبله ، وقد عرفت الآيات التي استعملت فيها هذه اللفظة وما يقابلها(2) ، وكان اعتبار العدالة في الشاهد معروفاً بين المسلمين من ذلك العصر
(1) تنقيح المقال 1: 95 .
(2) الطلاق : 2 ; الحجرات : 7 ; البقرة: 282 ; المائدة : 106 .
(الصفحة233)
إلى عصر صدور الرواية الذي هو النصف الأول من القرن الثاني .
إلاّ أنّه حيث كانت حقيقتها وما يراد من مفهومها مورداً لاختلاف المراجع للمسلمين في ذلك الزمان في الفتوى وغيرها كأبي حنيفة وغيره ، حيث حكي عن الأول أنّه فسّرها بمجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، وعن غيره تفسيرها بالاجتناب عن الاُمور التي تعلّق النهي بها تحريماً أو تنزيهاً ، وارتكاب الطاعات كذلك واجبة أو مستحبّة(1) ، أراد السائل ـ وهو ابن أبي يعفور ـ الاستفهام عمّا هو المراد منها عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ، وليس مرادنا من ذلك أنّ سؤاله إنّما هو عن المعرّف المنطقي حتّى يكون قوله: «بِمَ تعرف» بصيغة المجهول من باب التفعيل ، بل سؤاله إنّما هو عن مجرّد ما اُريد منها في لسان الأئمّة(عليهم السلام) .
ودعوى أنّ ظاهر السؤال إنّما هو السؤال عن الأمارة المعرّفة للعدالة بعد العلم بمفهومها ، بمعنى أنّ السائل لمّا رأى أنّ العدالة هي الملكة النفسانية الكذائية ، ورأى أنّ احراز تلك الملكة مشكل جدّاً مع كثرة الأحكام المترتّبة على عدالة الرجل ، حدس من ذلك أنّ الشارع جعل لها أمارة لئلاّ يلزم تعطيل تلك الأحكام مع كثرتها ، فسئل عن تلك الأمارة المعرّفة ، ...
في غاية البعد ، بل الظاهر ما ذكرنا ، ولا ينافيه قوله(عليه السلام) في الجواب: «أن تعرفوه بالستر والعفاف . . .» ، نظراً إلى أنّ المعرفة طريق للعدالة لا نفسها ، وذلك لأنّ المعرفة المأخوذة في الجواب إنّما أخذت لأجل تعريف أصل العدالة وإفادة حقيقتها .
وبالجملة: فالتأمّل يقضي بكون مورد السؤال إنّما هو نفس العدالة لا الأمارة المعرّفة لها .
(1) بداية المجتهد 4: 308.
(الصفحة234)
ثمّ إنّه ذكر بعض الأعاظم من المعاصرين في كتابه ـ الصلاة ـ في معنى هذه الرواية وتحقيق مورد السؤال فيها كلاماً ، محصّله: إنّ الظاهر من الرواية بيان معرفة العدالة في الخارج لا بيان مفهومها ، وظاهر السؤال عن طريق تشخيص العدالة أن يكون مفهومها معلوماً معيّناً عند السائل ، لأنّها عرفاً هي الاستقامة والاستواء ، وإذا أطلق الشارع فلايشكّ في أنّ مراده هو الاستقامة في جادّة الشرع الناشئة من الحالة النفسانية ، وهي التديّن الباعث له على ملازمة التقوى .
وحيث لم يكن لهذا المعنى أثر خاصّ وكاشف قطعيّ ، ألجأ السائل إلى أن يسأل طريقه عن الإمام(عليه السلام) ، وهذا بخلاف سائر الملكات ، كالشجاعة والسخاوة وأمثال ذلك ، فإنّها تستكشف قطعاً عند وجود آثارها الخاصّة ، فعرّفه الإمام(عليه السلام)الطريق إلى تشخيصها وأجابه بالستر والعفاف . . . ، وهذه العناوين المذكورة في الجواب وإن كانت مشتملة على الملكة ، ولكن لا تدلّ على الملكة الخاصّة ـ التي هي التديّن والخوف من عقوبة الله، جلّت عظمته ـ التي هي عبارة عن العدالة ، فلا ينافي جعلها طريقاً تعبّدياً إلى ثبوت العدالة .
ثمّ إنّه حيث تحتاج معرفة الشخص بالستر والعفاف، وأنّه تارك للقبائح على وجه الاطلاق إلى معاشرة تامّة في جميع الحالات ، وهذه ممّا لا يتّفق لغالب الناس ، فجعل الشارع لذلك دليلا وطريقاً آخر ، وهو كونه ساتراً لعيوبه في الملأ وبين أظهر الناس ، وطريقاً ثالثاً نافعاً لمن ليس له معاشرة مع شخص مطلقاً إلاّ في أوقات حضور الصلاة مع الجماعة . فمن حضر جماعة المسلمين يحكم بعدالته ، وأنّه لا يرتكب القبائح الشرعيّة مع الجهل بأحوال ذلك الشخص ، بل يكون لحضوره في صلاة الجماعة ثلاث فوائد:
الاُولى: إنّ ترك الجماعة مع المسلمين بدون علّة بحيث يعدّ إعراضاً عنها من أعظم العيوب ، فمن تركها كذلك فليس ساتراً لعيوبه بل هو مظهر لها .
(الصفحة235)
الثانية: إنّ من لم يحضر الجماعة لا دليل لنا على أنّه يصلّي .
الثالثة: إنّ حضوره للجماعة دليل شرعاً على كونه تاركاً لما نهى الله عنه وعاملا بكلّ ما أمر الله تعالى به ، وقد أشار إلى كلّ واحد من هذه الفوائد الصحيحة المتقدّمة فتدبّر فيها(1) ، انتهى .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ جعل الأمارة المعرّفة للعدالة وبيانها للسائل ، مع جعل أمارة لتلك الأمارة ومعرِّفاً لذلك المعرّف كما بيّنه(قدس سره) بعيد جدّاً ، لعدم الاحتياج إلى جعل الأمارة المعرِّفة حينئذ أصلا ، وإلى أنّ مجرّد الحضور لجماعة المسلمين لا ينافي عدم كونه ساتراً لعيوبه ، فلا معنى لجعله طريقاً في قبال الستر للعيوب ، خصوصاً مع كون ظاهر الرواية هو كون الستر للعيوب والحضور لجماعة المسلمين معاً طريقاً ودليلا ، لا كلّ واحد من الأمرين ـ أنّ كلّ ذلك خلاف ظاهر الرواية ، فإنّك عرفت أنّه حيث كان تفسير العدالة وتعريفها مورداً لاختلاف المسلمين في ذلك العصر ، أراد السائل أن يسأل عمّا يراد منها عند أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) ، والجواب لا ينطبق إلاّ على ذلك كما سنبيّن . هذا كلّه فيما يتعلّق بالسؤال .
وأمّا الجواب ، فقوله(عليه السلام) : «أن تعرفوه بالستر والعفاف» ، معناه أن يكون الرجل معروفاً عند المسلمين ، بحيث يعرفونه أو تعرفونه أنتم بالستر الذي هو الحياء ، وبالعفاف الذي هو الحياء أيضاً .
قال في لسان العرب: الستر ، ـ بالكسر ـ : الحياء ، والحجر العقل . وقال في لغة «عف»: العفّة: الكفّ عمّا لا يحلّ ويجمل . عفّ عن المحارم والأطماع الدنية ، يعفّ عفة وعفا وعفافاً «بفتح العين» ، وعفافة فهو عفيف وعفّ أي كفّ وتعفّف . . .(2) .
(1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 517 ـ 518 .
(2) لسان العرب 6: 169 وج9 : 290 .
(الصفحة236)
وبالجملة: أن يكون الرجل معروفاً بالكفّ عمّا لا يجمل له بالحياء المانع عن ارتكابه ، وأن يكون معروفاً بكفّ البطن والفرج ، واليد واللسان، عمّا لا يليق بها ولا يجمل لها . ومنشأ هذا الكفّ هو الستر والحياء ، لأنّه معه يتعسّر من الشخص صدور ما لا ينبغي أن يصدر من مثله بحسب المتعارف .
فهذه الجملة تدلّ على اعتبار المروءة في العدالة، كما هو المشهور بين المتأخّرين(1) ، لأنّها ليست إلاّ عبارة عن ترك ما لا يليق بحال الشخص عادة .
وقوله: «يُعْرَف . . .» ، الظاهر أنّ فعل المضارع منصوب معطوف على قوله: «تعرفوه» المنصوب بكلمة «أن» الناصبة ، فمعناه حينئذ أن يكون الرجل معروفاً أيضاً باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك .
فعليه يكون كلّ من الجملتين الاُولى والثانية بعض المعرّف للعدالة ، لأنّ الجملة الاُولى تدلّ على اعتبار المروءة ، والثانية على اعتبار اجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، وليست الجملة الاُولى تمام المعرّف للعدالة ، والجملة الثانية دليلا على المعرّف ، لأنّه مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر العبارة كما لا يخفى ، وإلى عدم الفرق بين المعرّف والدليل عليه حينئذ أصلا ، يلزم أن لا يكون الدليل دليلا على تمام المعرّف ، لأنّه حينئذ لابدّ من حمل المعرف على الأعم من الأعمال غير اللائقة بحاله عرفاً ، بحيث يشمل غير الجائزة شرعاً أيضاً ، مع أنّ الدليل والطريق ينحصر بخصوص الثانية .
ودعوى أنّ العطف على الجملة الاُولى يلزم منه الاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه ، من جهة أنّ المعطوف عليه هو معرفة المسلمين للرجل والمعطوف
(1) راجع 3 : 226 .
(الصفحة237)
هو معروفيّة الرجل عندهم .
مدفوعة بأنّه لا مانع من ذلك ، بل وقع نظيره في الكتاب العزيز في قوله تعالى: {ولايحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود الله فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}(1) ، حيث أنّه نسب الخوف أوّلا إلى الزوجين ثمّ إلى أهلهما ، وليس ذلك إلاّ لأجل كون مجرّد المعرضيّة كافياً في صحة النسبة كما لا يخفى .
وبالجملة: فالظاهر أنّ هذه الجملة جزء أخير من معرّف العدالة، ومعطوفة على الجملة الاُولى ، وحيث إنّ مقتضى هاتين الجملتين المعرّفتين للعدالة اعتبار كون الشخص واجداً لملكة المروءة ، وكذا ملكة الإجتناب عن المعاصي ، وظاهره اعتبار إحراز ذلك في مقام ترتيب الآثار المترتّبة على العدالة .
ومن الواضح أنّ إحرازه بالعلم مشكل جدّاً ، فلذا نصب له طريق ودليل بيّنه الإمام(عليه السلام)بقوله: «والدلالة على ذلك كلّه . . .» ، ومعناه أنّ الدليل على مجموع ما جعلناه معرّفاً للعدالة من الجزء الذي هو مدلول الجملة الاُولى ، والجزء الآخر الذي هو مدلول الجملة الثانية ، أن يكون الشخص ساتراً لجميع عيوبه على تقدير وجودها أعمّ من العيوب المنافية للمروءة وغير الجائزة شرعاً .
وثمرة سترها أنّه معه يحرم على المسلمين تفحّص ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، وتفتيش خلف الساتر ، بل يجب عليهم حينئذ تزكيته وإظهار عدالته في الناس مع سؤالهم عن حاله .
وحيث إنّ المعاصي على قسمين: وجودية : وهو ارتكاب شيء من المحرّمات . وعدمية: وهوترك شيء من الواجبات. والمعاصي الوجودية على تقديرتحقّقها تحتاج
(1) البقرة: 229 .
(الصفحة238)
إلى الستر الذي به يرائى عدم تحقّقها ، لأنّه يحرم على المسلمين التفتيش والتفحّص .
وأمّا المعاصي العدمية فيكفي في تحقّقها مجرّد الترك وعدم صدور الفعل ، فلا محالة يحتاج في إراءة خلافها إلى إيجاد الفعل ، فلذا جعل الدليل على خلافها التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة .
وتخصيص الصلوات الخمس من بين الواجبات إنّما هو باعتبار كون ما عداها منها ، إمّا أن لا يكون وجوبه مطلقاً لاشتراطه بالاستطاعة المالية أو البدنية أو كلتيهما ، وإمّا أن لا يقدر الشخص على مخالفته باعتبار إجبار الحاكم إيّاه عليه ، كالزكاة ونحوها ، وما عدا ما ذكر ينحصر في الصلوات الخمس ، فلذا جعل التعاهد عليها دليلا على العدالة .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ العدالة على ما تستفاد من الرواية ليست إلاّ الملكة ، لأنّ الستر والعفاف من الأوصاف النفسانية والفضائل الباطنية المانعة عن ارتكاب ما لا يجمل لواجدها ، فالمعتبر هو ملكة المروءة التي يتعسّر معها الاقتحام في خلافها وارتكاب شيء من القبائح العرفيّة غير اللائقة بحاله ، لأنّ صفة الحياء والعفّة تمنع عن ذلك .
وامّا الاجتناب عن الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، الذي هو من تتمّة المعرّف للعدالة ، فهو وإن لم يكن المذكور في الرواية اعتبار ملكته ، إلاّ أنّ ذكر الستر والعفاف يصير قرينة على أنّ المراد به هو ملكة الاجتناب أيضاً . فالعدالة حينئذ ملكة نفسانية وهيئة راسخة في النفس تمنع لأجل الحياء عن ارتكاب القبائح العرفية ، ولأجل الخوف عن ارتكاب القبائح الشرعية .
نعم، قد عرفت أنّ إحراز وجود هذه الحالة بالعلم في غاية الإشكال ، مع أنّا نرى كثرة الأحكام المترتّبة على العدالة وابتلاء الناس بها في مرافعاتهم وصلواتهم
(الصفحة239)
جماعة وغيرهما ، ولأجله جعل الشارع له أمارة وطريقاً شرعياً ربّما يرجع إلى حسن الظاهر .
وهذا الطريق مركّب من أمرين:
1 ـ كون الرجل ساتراً لعيوبه حتّى لا يطّلع غيره من المسلمين على المعاصي الوجوديّة والقبائح العرفيّة الصادرة منه ، بل كان طريق اطلاعهم منحصراً بالتفتيش والتفحّص عمّا وراء الساتر وهو محرّم عليهم .
2 ـ كونه متعاهداً للصلوات الخمس ، ومعنى تعاهده لها إمّا الالتزام بالحضور في جماعات المسلمين حتّى يصلّي معهم جماعة لأجل مدخليتها في قبول الصلاة ، كما يستفاد من ذيل الرواية الدالّة على أنّه «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين» ، بعد حملها على نفي القبول لا نفي الصحّة ، وإمّا كون حضوره فيها دليلا على أنّه لا يتحقّق منه ترك الصلاة ، لا لأجل مدخلية الجماعة في قبولها ، فالملاك هو نفس الإتيان بالصلاة لا الإتيان بها جماعة .
وممّا ذكرنا ينقدح أنّه لا يرد على الرواية شيء ممّا تخيّل وروده عليها ، بل الرواية تنطبق ظاهراً على المعنى المعروف للعدالة بين المحقّقين من المتأخّرين كالفاضلين والشهيدين وغيرهما(1) .
روايات أخرى حول العدالة
إنّ هنا روايات اُخر كثيرة اُورد أكثرها في الوسائل في كتاب الشهادات ، وجملة منها في أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة .
(1) راجع 3 : 226 .
(الصفحة240)
فمن جملة ما أوردها في كتاب الشهادات ، مرسلة يونس عن أبي عبدالله(عليه السلام)الدالّة على أنّه إذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه(1) ، والمراد بكونه مأموناً يحتمل أن يكون هو المأمونية في مقام أداء الشهادة ، بأن كان مأموناً عن الكذب فيها ، ويحتمل أن يكون هو المأمونية المطلقة بأن كان مأموناً ظاهراً عن ارتكاب المعاصي مطلقاً .
ومنها: رواية عبدالله بن المغيرة الواردة في إشهاد شاهدين ناصبيّين في باب الطلاق الدالّة على أنّ كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته(2) ، والظاهر أنّ المراد به جواز شهادة كلّ من ولد على الفطرة ولم يعلم خروجه عنها بحيث كان مقتضى الاستصحاب بقاؤه عليها ، وكان معروفاً أيضاً بالصلاح في نفسه أي في مذهبه وعليه . فيستفاد من الرواية الجواز في مورد السؤال مع معروفيته في نفسه .
ومنها: رواية علاء بن سيّابة الواردة في حكم شهادة من يلعب بالحمام الدالّة على نفي البأس إذا كان لا يعرف بالفسق(3) . وظاهرها عدم كون اللعب بالحمام موجباً للفسق .
ومنها: رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) الدالّة على أنّ عليّاً(عليه السلام) قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه»(4) .
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا
(1) الفقيه 3: 9 ح29 ; الوسائل 27: 392 كتاب الشهادات ب41 ح3 .
(2) الفقيه 3: 28 ح83 ; التهذيب 6 : 283 ح778 ; الإستبصار 3: 14 ح37; الوسائل 27: 393 كتاب الشهادات ب41 ح 5 .
(3) الفقيه 3: 30 ح88; التهذيب6: 284 ح784; الوسائل27:394كتاب الشهاداتب41 ح6وص412ب54 ح1.
(4) الفقيه 3: 30 ح91 ; الوسائل 27: 394 .كتاب الشهادات ب41 ح7 .
|