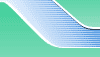(الصفحة81)
في باب الأديان هو تأمين عالم الآخرة ، والدعوة إلى الأعمال الحسنة التي يترتّب عليها الثواب والراحة ، ودخول الجنّة ، وعليه فكيف يمكن أن يكون كتاب الوحي خالياً عن التعرّض لمثل ذلك العالم ، الذي لا تدركه الحواس ، ويحتاج إلى التعرّض والهداية ، وإرائة الطريق إليه ، فضلاً عن الدعوة إلى الأعمال النافعة في ذلك العالم ، الرابحة في سوقه.
نعم ، حرّضت التوراة الناس إلى الطاعة ، والتجنّب عن المعصية من جهة تأثير الطاعة في حصول الغنى في الدنيا ، والتسلّط على الناس باستعبادهم ، وتأثير المعصية في تحقّق السقوط من عين الربّ ، وسلب الأموال والشؤون المادّية ، ولأجل عدم دلالة التوراة على وجود عالم الآخرة والدعوة إلى ما يؤثر فيه; نرى التابعين لها في مثل هذه الأزمنة غير متوجّهين إلاّ إلى الجهات الراجعة إلى عالم المادّة والغنى والمكنة ، ولا نظر لهم أصلاً إلى عالم الآخرة ، ولهم في هذا المجال قصص مضحكة مشهورة.
وفي مقابلها: شريعة إنجيل ، ناظرة إلى الآخرة فقط ، ولا تعرّض فيها لصلاح حال الدنيا وشؤونها بوجه من الوجوه.
امّا القرآن الكريم: فقد نزل في عصر كان الحاكم عليه القوانين الرائجة بين الوثنية من ناحية ، وقوانين التوراة والإنجيل المحرّفة من ناحية اُخرى ، وملاحظة نظامه وتشريعه من حيث هو ـ سيّما مع المقايسة لتلك القوانين الحاكمة في ذلك العصر ـ ترشد الباحث إرشاداً قطعيّاً إلى كونه نازلاً من عند الله تبارك وتعالى.
امّا من جهة اشتماله على نظام الدنيا ، ونظام الآخرة ، وتضمّنه لما يصلح في كلا العالمين ، وتكفّله لما يؤثر في السعادتين; فلا موقع للإرتياب في البين ، ويكفي في
(الصفحة82)
الدعوة إلى عالم الآخرة ، الذي قد عرف انّه الغرض الأقصى والمطلوب الأهمّ في الأديان والشرائع الإلهيّة ، مثل قوله تعالى في سورة القصص: 77:
{وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا}.
بل أنّ هذه الآية تدلّ على كلا النظامين ، وعلى أهمّية النظام الاُخروي ورجحانه على النظام الدنيوي ، وقوله تعالى في سورة الزلزلة 7 ـ 8:
{فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره* ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره}. خصوصاً مع ملاحظة ما حكي في شأن هذه الآية عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) من أنّها تحكم آية في القرآن ، ومع ظهورها في أنّ المرئي في عالم الآخرة نفس عمل الخير والشرّ ، الظاهر في تصوّرهما بأنفسهما بالصور الخاصّة المرئية في ذلك العالم ، كما يدلّ عليه بعض الآيات الاُخر ، وكثير من الروايات ، وذلك لرجوع الضمير إلى نفس العمل ، كما هو ظاهر ، فتدبّر!
وامّا من جهة انطباق قوانينه وشرائعه مع البراهين الواضحة ، والفطرة السليمة ، والأخلاق الفاضلة ، بحيث لا تبقى مع رعايتها بأجمعها وتطبيق العمل عليها ، والالتزام بعدم التخطّي عنها في الأعمال القلبية والخارجية ، والأفعال الجانحيّة والجارحيّة مجال لشائبة النقص والقصور ، وموقع لاحتمال عروض الضعف والفتور ، وبها يمكن التوسّل إلى السعادة المطلوبة ، والوصول إلى الراحة المقصودة في النشأة المادّية والمعنوية.
فتراه في مواضع متعدّدة يأمر الناس بسلوك العدل ، الذي هي الجادّة الوسطى التي لا انحراف عنها يميناً وشمالاً كما في قوله تعالى في سورة النحل 90:
{إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى}.
(الصفحة83)
وكذا يأمرهم بأن يطلبوا منه الهداية إلى الصراط المستقيم ، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة: {اهدنا الصراط المستقيم}.
وكذا ملاحظة سائر قوانينه المؤثرة في تحصيل السعادة الدنيويّة ، أو الأخرويّة ، والخالية عن وصف الكلفة والحرج ، بحيث أخبر الله تعالى بأنّ ما يكون حرجيّاً لم يكن مجعولاً في الدين والشريعة ، وانّه تعلّقت إرادته باليسر ولم تتعلّق بالعسر.
وبالجملة: ملاحظة نظام القرآن وتشريعه ترشد الباحث ـ غير المتعصّب ـ إلى عدم كونه مصنوعاً للبشر ، فإنّه كيف يمكن له الإحاطة بجميع الخصوصيّات الدخيلة في سعادة الدارين ، حتّى يضع قانوناً منطبقاً عليها ، فضلاً عن القوانين الكثيرة الثابتة في جميع الوقائع والحوادث المبتلى بها.
ومن باب المثال: انظر إلى قانوني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذين هما من الواجبات المسلّمة في الشريعة الدالّ عليها الكتاب العزيز ، والسنّة الشريفة ، وقايس هذا القانون مع التشكيلات العصريّة الكاملة تدريجاً ، التي يكون الغرض من تأسيسها ، والغاية الباعثة على جعلها حفظ القوانين البشرية ولزوم تطبيق العمل عليها ، فإنّها ـ مع سعتها المحيّرة ، وعظمتها المعجبة ، واستلزامها لصرف مؤونة كثيرة ـ لا تقدر على تحصيل هذا الغرض كما نراه بالوجدان ، فلا تكاد تقدر على الردع عن مخالفتها ، وسدّ باب نقضها مع جعل عقوبات عجيبة ، وتعذيبات شديدة ، لفرض صورة المخالفة ، والفرار عن الموافقة.
وامّا قانون القرآن فمضافاً إلى عدم افتقاره إلى تشكيلات مخصوصة ، ومؤونة زائدة ما يتضمّن لحفظ القوانين من طريق لزوم مراقبة كلّ فرد بالإضافة إلى آخر
(الصفحة84)
وكونه عيناً عليه ، ناظراً له فهو ـ أي كلّ واحد من المسلمين ـ يتّصف بأنّه مراقب ـ بالكسر ـ ومراقب ـ بالفتح ـ ولا يتصوّر فوق هذا المعنى شيء ، ضرورة أنّ أعضاء تلك التشكيلات محدودة لا محالة ، وهي لا تتّصف إلاّ بعنوان المراقبة ـ بالكسر ـ بخلاف قانون القرآن.
والإنصاف: انّ التدبّر في كلّ واحد من القوانين الثابتة في القرآن ـ فضلاً عن جميعها ـ لا يبقى للمرتاب شكّ ولا للمريب وهم ، ويقضي إلى الحكم الجازم ، والتصديق القطعي ، الذي لا ريب فيه بأنّه كتاب نازل من عند الله العالم الخبير ، والحكيم البصير ، كما قال الله تعالى في سورة البقرة 2: {ذلك الكتاب لاريب فيه هدىً للمتّقين} ولكن الاهتداء بهدايته ، والاستضاءة بنوره يحتاج إلى تقوى القلب ، وسلامته عن مرض العناد والتعصّب واللجاج ، وبقائه على الفطرة الأصلية السليمة القابلة لنور الهداية ، غير المنحرفة عن الجادّة المستقيمة ، التي يكون السالك فيها مطيعاً للفعل ، ومجتنباً عن الضلالة والجهل.
(الصفحة85)
القرآن وأسرار الخلقة
من جملة وجوه الإعجاز الهادية إلى أنّ القرآن قد نزل من عند الله تبارك وتعالى; اشتماله على التعرّض لبعض أسرار الخلقة ، ورموز عالم الكون ، ممّا لا يكاد يهتدي إليه عقل البشر في ذلك العصر ، سيّما من كان في جزيرة العرب ، البعيدة عن التمدّن العصري بمراحل كثيرة ، وهذه الأنباء في القرآن كثيرة ، ولعلّ مجموعها يتجاوز عن كتاب واحد ، وكما أنّ جملة ممّا أخبر به القرآن لم تتّضح إلاّ بعد توفّر العلوم ، والاكتشافات ، وتكثر الفنون والاختراعات ، كذلك يمكن أن يكون وضوح البعض الآخر متوقّفاً على ارتقاء العلم ، وتكامل البشر في هذا المجال الحاصل بالتدريج ، ومرور الأزمنة.
ومن المناسب إيراد بعض الآيات الواردة في هذا الشأن فنقول:
1 ـ ما ورد في شأن النبات ، وثبوت سنّة الزواج بينها ، كما في الحيوانات ، وانّ اللقاح الذي يفتقر إليه في انتاج الزوجين إنّما يحصل بسبب الرياح ، وهو قوله تعالى في سورة يس 36:
{سبحان الذي خلق الأزواج كلّها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا يعلمون}.
وقوله تعالى في سورة الحجر 22: {وأرسلنا الرياح لقواقح}.
(الصفحة86)
فإنّ الكريمة الاُولى: دلّت على عدم اختصاص سنّة الزواج بالحيوانات ، بل نعم النباتات وما لا يعلمه الإنسان من غيرها أيضاً ، بل قدّم ذكر النبات على الإنسان في هذه السنّة ، ولعلّه إشعار بكون هذه السنّة في النباتات قهريّة بخلاف الإنسان ، الذي يكون الأمر فيه على طبق الاختيار والإرادة.
والآية الثانية: تدلّ على أنّ اللقاح الذي يتوقّف عليه إنتاج الشجر والنبات إنّما يتحقّق بسبب الرياح ، وهذا هو الذي اكتشفه علماء معرفة النبات ، ولم يكن يدرك هذا الأمر غير المحسوس وأفكار السابقين ، ولذا التجأوا إلى حمل اللقاح في الآية عل معنى الحمل الذي هو أحد معانيه وفسّروا الآية الشريفة بأنّ الرياح تحمل السحاب الممطرة إلى المواضع التي تعلّقت المشيّة بالأمطار فيها.
وأنت خبير; بأنّه لا وجه للحمل على ذلك ، مضافاً إلى عدم صحّته ، لعدم كون الرياح حاملة للسحاب ، بل دافعة لها من مكان إلى آخر ، مع أنّ هذا المعنى ليس فيه اهتمام كبير ، وعناية خاصّة ، وهذا بخلاف الحمل على ما هو الظاهر فيه.
وحكي انّه لمّا اهتدى علماء أوربا إلى هذا ، وزعموا انّه ممّا لم يسبقوا إليه من العلم; صرّح بعض المطّلعين على القرآن منهم بسبق العرب إليه ما قال بعض المستشرقين: إنّ أصحاب الإبل قد عرفوا أنّ الريح تلقح الأشجار قبل أن يعلمه علماء أوربا بثلاثة عشر قرناً. نعم أنّ أهل النخيل من العرب كانوا يعرفون التلقيح إذ كانوا ينقلون بأيديهم اللقاح من طلع ذكور النخل إلى إناثها ، ولكنّهم لم يعلموا أنّ الرياح تفعل ذلك ، وانّه لا تختصّ الحاجة إلى اللقاح بخصوص النخيل فقط.
2 ـ وما ورد في شأن النبات من جهة أنّ له وزناً خاصّاً ، وهو قوله تعالى في سورة الحجر 19: {وأنبتنا فيها من كلّ شيء موزون} فإنّ علماء معرفة النبات قد
(الصفحة87)
أثبتوا أنّ العناصر التي يتكوّن منها النبات مؤلفة من مقادير معيّنة في كلّ نوع من أنواعه ، بدقّة غريبة لا يمكن ضبطها إلاّ بأدقّ الموازين المقدّرة ، ولو زيد في بعض أجزائها أو نقص لا يمكن حصول ذلك النبات ، بل يتحقّق مركّب آخر غير هذا النبات.
3 ـ وما ورد في شأن الأرض ، وانّها متّصفة بوصف الحركة ، غاية الأمر انّه حيث كان سكون الأرض من الاُمور المسلّمة في ذلك العصر ، بل وبعده إلى حدود القرن العاشر من الهجرة ، ولذا صار الحكيم المعروف بـ «غاليلو» الكاشف لحركة الأرض والمثبت لها مورداً للإهانة والتعذيب والتحقير ، مع جلالته العلميّة ، ومقامه الشامخ ، لم يصرّح القرآن بذلك حذراً من ترتّب النتيجة المعكوسة عليه ، وحصول نقض الفرض بسببه ، بل أشار إلى ذلك بإشارات لطيفة ، وإيماءات بليغة ليهتدي إليها البشر في عصر توفّر العلم والاكتشاف ، فيعتقد بأنّ هذا الكتاب نازل من عند الله المحيط بحقائق الأشياء ، والعالم بأسرار الكون ، ورموز الخليقة ، وقد تحقّقت هذه الإشارة في ضمن آيات كثيرة:
كقوله تعالى في سورتي طه والزخرف 53 ، 10: {الذي جعل لكم الأرض مهداً} فإنّه تعالى قد استعار لفظ «المهد» للأرض ، ومن البيّن أنّ الخصوصية المترقّبة من المهد ، المعدّ للرضيع ، والمصنوع لأجله ، والجهة الملحوظة التي بها يتقوّم عنوان المهدية ليست هي الوضع الخاصّ ، والشكل المخصوص الحاصل من تركيب مواد مختلفة ، وضمّ بعضها إلى بعض ، بل الخصوصية هي حركة المهد وانتقاله من حال إلى حال.
ففي الآية الشريفة إشارة لطيفة إلى حركة الأرض ، من جهة استعارة لفظ المهد
(الصفحة88)
لها وانّه كما أنّ حركة المهد لغاية تربية الطفل واستراحته ، كذلك حركة الأرض تكون الغاية لها تربية الموجودات من الإنسان وغيره.
وقوله تعالى في سورة الملك 15:
{وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها}.
فإنّه تعالى قد استعار لفظ «الذلول» للأرض ، مع أنّه عبارة عن نوع خاصّ من البعير ، ويكون امتيازه بسهولة انقياده ، ففيه إشارة إلى أنّ الخصوصية الموجودة والذلول ، التي ليست لغيره ثابتة في الأرض ، فهي أيضاً متحرّكة بحركة ملائمة للراكب عليها ، الماشي في مناكبها. ومن البين أنّه مع قطع النظر عن هذه الخصوصية ـ وهي خصوصية الحركة ـ يكون إطلاق لفظ الذلول على الأرض واستعارته لها ليس له وجه ظاهر حسن ، خصوصاً مع تفريع الأمر بالمشي عليه ، وإطلاق لفظ المنكب كما هو غير خفيّ.
وقوله تعالى في سورة النمل 88:
{وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرّ السحاب صنع الله الذي أتقن كلّ شيء}.
فإنّه بقرينة وقوعها في سياق الآيات الواردة في القيامة وأهوالها ، ربما يقال ـ كما قيل ـ بأنّ هذه الآية أيضاً ناظرة إلى أحوال القيامة وأهوالها ، مع أنّه لا وجه للحمل على ذلك المقام ، خصوصاً مع قوله تعالى في الذيل: «صنع الله...» الظاهر في ارتباط الآية بشؤون الخلقة وابتدائها ، وحسنها وجمالها ، مع أنّها في نفسها أيضاً ظاهرة في أنّ المرور والحركة ثابت للجبال فعلاً ، كما أنّ حسبان كونها جامدة أيضاً كذلك ، فالآية تدلّ على ثبوت المرور والحركة للأرض من بدو خلقتها
(الصفحة89)
ومصنوعيّتها وانّ الحركة دليل بارز على إتقانها ، وفيها إشارات لطيفة ودقائق ظريفة.
من جهة: أنّه تعالى جعل الدليل والأمارة على حركة الأرض حركة الجبال التي هي أوتاد لها ، ولم يثبت الحركة في هذه الآية لنفس الأرض من دون واسطة. ولعلّه للإشارة إلى أنّ حركة الجسم الكروي بالحركة الوضعية دون الانتقاليّة ، حيث لا تكون محسوسة إلاّ بسبب النقوش والألوان ، أو الارتفاعات الثابتة عليه وفي سطحه ، فلذا يكون الدليل على حركته حركة ذلك النقش واللون أو الارتفاع.
ومن جهة: التعبير عن حركتها بالمرور الذي فيه إشارة إلى بطء حركة الأرض وملائمتها. حسب القانون الطبيعي الذي أودعه الله فيها.
ومن جهة: انّ التشبيه بالسحاب ، مع كون حركتها مختلفة ، فإنّها قد تمرّ إلى جانب المشرق ، وقد تتحرّك إلى سائر الجوانب من الجوانب الأربعة;ى دلّ على عدم اختصاص حركة الأرض بحركة خاصّة ، بل لها حركات مختلفة ربما تتجاوز عن عشرة أنواع ومن غير تلك الجهات.
4 ـ ما ورد في شأن كرويّة الأرض ، مثل قوله تعالى في سورة الزمر 5:
{يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل}.
تقول العرب: «كار العمامة على رأسها إذا أدارها ولفّها ، وكوّرها بالتشديد صيغة مبالغة وتكثير» فالتكوير في اللغة إدارة الشيء عل الجسم المستدير كالرأس بالإضافة إلى العمامة ، فتكوير الليل على النهار ظاهر في كرويّة الأرض ، وفي بيان حقيقة الليل والنهار على الوجه المعروف في الجغرافية الطبيعيّة. وقوله تعالى في سورة الرحمن 17: {ربّ المشرقين وربّ المغربين}.
(الصفحة90)
وتوضيح المراد من هذه الآية الشريفة: أنّ الكتاب العزيز قد استعمل فيه لفظ المشرق والمغرب ـ تارةً ـ بصيغة الافراد ، كقوله تعالى في سورة البقرة 11: {ولله المشرق والمغرب} ـ واُخرى ـ بصيغة التثنية كهذه الآية التي نحن بصدد التوضيح للمراد منها ، وقوله تعالى في سورة الزخرف 28:
{ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين}.
وثالثة ـ بصيغة الجمع ، كقوله تعالى في سورة الأعراف 137:
{وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها}.
وقوله تعالى في سورة المشارق 40:
{فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ}.
أمّا ما ورد فيه هذان اللفظان بصيغة الافراد: فهو مع قطع النظر عن الآيات الظاهرة في التعدّد يلائم مع وحدتهما ، وامّا بعد ملاحظتها فلا محيص عن أن يكون المراد منه هو النوع المنطبق على المتعدّد من أفرادهما.
وامّا ما ورد فيه هذان اللفظان بصيغة المثنّى: فقد اختلف المفسِّرون في معناه فقال بعضهم: المراد مشرق الشمس ومشرق القمر ومغربهما ، وحمله بعضهم على أنّ المراد منه مشرقا الصيف والشتاء ومغرباهما ، ولكن بعد اهتداء البشر إلى كرويّة الأرض وانّها فلك مستدير كروي ، واستكشافهم لوجود قارّة اُخرى على السطح الآخر للأرض يكون شروق الشمس عليها غروبها عن قارّتنا; ظهر أنّ المراد بالآية هو تعدّد المشرق بالإضافة إلى الشمس في كلّ يوم وليلة ، لا أنّ التعدّد بلحاظ الشمس والقمر ، ولا بالنظر إلى اختلاف الفصول ، بل لها في كلّ أربع وعشرين ساعة مشرقان مشرق بالإضافة إلى قارّتنا ، ومشرق بلحاظ القارّة
(الصفحة91)
الاُخرى المكتشفة «وياليتها لم تُكتَشف».
وربّما يؤيِّد ذلك بالآية الشريفة المتقدّمة المقتصر فيها على تثنية المشرق فقط نظراً إلى أنّ الظاهر منها أنّ البُعد بين المشرقين هو أطول مسافة محسوسة فلا يمكن حملها على مشرقي الشمس والقمر ، ولا على مشرقي الصيف والشتاء ، لأنّ المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة ، فلا يمكن حملها على مشرق الشمس والقمر ، ولا على مشرق الصيف والشتاء ، لأنّ المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة ، فلابدّ من أن يراد بها المسافة التي ما بين المشرق والمغرب ، ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقاً لجزء آخر من الكرة الأرضية ليصحّ هذا التعبير.
ولكن في التأييد نظر; لاحتمال أن يكون لفظ «المشرقين» في هذه الآية تثنية للمشرق والمغرب ، لا تثنية للمشرق فقط ، ليدلّ على تعدّد المشرق ، مع قطع النظر عن المغرب ، ولعلّ هذا الاحتمال أقوى من جهة أنّ البُعد والفصل إنّما يناسب مع الشروق والغروب ، لا مع تعدّد المشرق كما هو غير خفيّ.
هذا ولكن ذلك لا يضرّ بدلالة الآية المتقدّمة المشتملة على تثنية المشرق والمغرب معاً ، فإنّ ظهورها فيما ذكرنا من تعدّد المشرق والمغرب لخصوص الشمس في كلّ يوم وليلة ممّا لا ينبغي أن ينكر ، فدلالتها على كرويّة الأرض ووجود قارّة اُخرى واضحة لا ريب فيها.
وأمّا ما ورد فيه ذلك بصيغة الجمع; فدلالته على كرويّة الأرض واضحة ، فإنّ طلوع الشمس على أيّ جزء من أجزاء كرة الأرض يلازم غروبها عن جزء آخر فيكون تعدّد المشارق والمغارب واضحاً لا تكلّف فيه ولا تعسّف.
(الصفحة92)
والمحكي عن بعض المفسِّرين حمل ما ورد فيه ذلك على مطالع الشمس ومغاربها باختلاف أيّام السنة وتعدّد الفصول ، ولكّه مع أنّه تكلّف لا ينبغي أن صار إليه ـ لا يلائم مع التأمّل في الآيات الدالّة على ذلك ، فإنّ الظاهر من الآية الاُولى: أنّ مشارق الأرض ومغاربها كناية عن مجموع الأرض وأجزائها ، فإنّه الذي ينبغي أن يكون القوم المستضعفون وارثين له ، وامّا مجرّد المشارق والمغارب المختلفة باختلاف الفصول وأيّام السنة فلا يلائم مع الوراثة أصلاً ، كما أنّها لا تلائم مع الحلف والقسم فتدبّر. ويؤيّد ذلك: ما ورد في أخبار الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
وممّا يدلّ على كرويّة الأرض مثل ما رواه في الوسائل ، عن الإمام الصادق (عليه السلام)قال: «صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر ، وكنت أنا اُصلّي المغرب إذا غربت الشمس واُصلّي الفجر إذا استبان الفجر ، فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ، فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا ، وهي طالعة على قوم آخرين بعد؟ فقلت: إنّما علينا أن نُصلّي إذا وجب الشمس عنّا ، وإذا طلع الفجر عندنا ، وعلى أولئك أن يصلّوا إذا غربت الشمس عنهم»(1).
ومثله قوله (عليه السلام) في رواية اُخرى: «إنّما عليك مشرقك ومغربك»(2).
فإنّهما ظاهران في اختلاف المشرق والمغرب إنّما هو باختلاف أجزاء الأرض الناشئ عن استدارتها وكرويّتها ، غاية الأمر أنّه يجب على كلّ قوم رعاية مشرق أرضه ومغربها.
(1) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، ب16 ص22.
(2) نفس المصدر.
(الصفحة93)
ومنها ـ أي من الأسرار التي دلّ عليها الكتاب العزيز ـ تعدّد السماوات والأرضين مع أنّ الحسّ الذي كان هو الطريق المنحصر للبشر في ذلك العصر لا يكاد يهدي إلاّ إلى وحدتهما ، ولذا كان جمهور المتقدّمين متّفقين على وحدة الأرض ، وأنّه ليس غير هذه الأرض التي نحن نعيش فيها ونمشي في مناكبها أرض اُخرى. لكنّه قد استقرّ رأي الفلاسفة ـ بعد القرن العاشر من الهجرة ـ على تعدّد الأرضين وعدم اختصاص الأرض بهذه الكرة المحسوسة لنا ، نعم المحكي عن الشيخ الرئيس أبي علي أنّه حكى القول بكثرة الأرضين ، وتعدّدها عن حكماء قديم الفرس ، وأشار إلى ذلك الشاعر المعروف الفارسي المشهور بـ «نظامي» في قوله:
شنيدستم كه هر كوكب جهانيست *** جداگانه زمين و آسمانيست
وكيف كان ، فالثابت عند المتأخّرين أنّ كلّ كوكب سيّار أرض مستقلّ ، مشتمل على ما في أرضنا من الجبال والبحار والسحاب والحيوانات وغيرها ، وقد دلّ الكتاب على تعدّد السماوات والأرضين ، بقوله تعالى في سورة الطلاق 12:
{الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنّ}.
فإنّ ظاهرة تعدّد الأرضين ، كالسماوات ، وبلوغها سبعاً مثلها ، وقد وقع التصريح بالأرضين السبع في الدعاء المعروف: «سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم».
ويؤيّد ما رواه جماعة عن الرضا ـ صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتجبين ـ في جواب السؤال عن ترتيب السماوات السبع والأرضين السبع ممّا مرجعه إلى أنّ الأرض التي نحن فيها ، أرض الدنيا وسماءها سماء الدنيا ،
(الصفحة94)
والأرض الثانية فوق سماء الدنيا ، والسماء الثانية فوقها ، وهكذا.
وبالجملة: دلالة الكتاب على مثل هذا الأمر غير المحسوس ، الذي كان مخالفاً لآراء البشر في عصر النزول تهدي الباعث هداية واضحة ، وترشد الطالب إرشاداً بيّناً إلى نزوله من عند الله الخالق للسماوات السبع ، ومن الأرض مثلهنّ.
ومن تلك الأسرار ما بيّنته الآيات الدالّة على حركة الشمس أوّلاً ، وكونها أصلاً في الحركة ثانياً ، وعلى تعدّدها ثالثاً ، وانّها بمرور الدهور يعرض لها التكوير ويبلغ إلى حدّ يصدق قوله تعالى في سورة الشمس: {إذا الشمس كوّرت}(1) الموافق للرأي الجديد في باب الشمس ونقصان نورها وحرارتها تدريجاً ، وغير ذلك من الأسرار التي دلّ عليها الكتاب تصريحاً أو تلويحاً ، التي ينبغي أن يؤلّف في كتاب واحد ، مع أنّ العلم بتوفّره ، والاكتشاف بتكثّره لم يبلغ إلى مرتبة يحيط لأجلها بجميع الأسرار الكونيّة ، والرموز الخلقيّة المذكورة في الكتاب العزيز. نسأل الله تبارك وتعالى لأن يهدينا سبيل الرشاد ، وهو الهادي إلى ما يتعلّق بالمبدأ والمعاد.
ثمّ إنّ هنا وجوهاً اُخر في باب إعجاز القرآن ، ولكن ما ذكرنا من النواحي التي كانت أعمّ ممّا أشار إليها الكتاب ، وما لم يشِر يكون فيه غنى وكفاية للطالب غير المتعصِّب ، والباحث غير العنود ، ولا يبقى بعد ملاحظة ما ذكرنا شكّ وارتياب في أنّ القرآن وحي إلهي ، وكلام الله الخارج عن حدود القدرة البشريّة.
ولكن هنا أوهام وشبهات حول إعجاز القرآن ، لا بأس بالإشارة إليها بأجوبتها وإن كان بعضها ـ بل كلّها ـ من السخافة والبطلان بمكان لا ينبغي إضاعة الوقت ، وإعمال القوّة العاقلة في دركها وإبطالها ، إلاّ أنّه لأجل إمكان إيرائها
(1) الشمس: 1.
(الصفحة95)
الإرتياب في بعض العقول الناقصة ، والنفوس غير الكاملة لا مانع من التعرّض لمهمّاتها.
(الصفحة96)
شبهات حول إعجاز القرآن
(الصفحة97)
شبهة غموض الإعجاز. شبهة التناقض والاختلاف. شبهة وجود العجز عن الإتيان بغير القرآن أيضاً. شبهة العجز عن المعارضة بسبب الخوف والتطبّع على القرآن. شبهة الخلط والتداخل بين الموضوعات القرآنية. شبهة احتقار المعارضة وعدم الإعلان بها. شبهة وقوع المعارضة وتعداد من عارض بلاغة القرآن والجواب عن كلّ ذلك بالتفصيل.
(الصفحة98)
1 ـ منها: انّ المعجز لابدّ وأن يعرف إعجازه جميع من يراد بالاعجاز إقناعه ، وكلّ من كان المهمّ اعتقاده بصدق مدّعي النبوّة ليخضع في مقابل التكاليف التي يأتي به ، والوظائف التي هو الواسطة في تبليغه وإعلامه ، ضرورة أنّ كلّ فرد منهم مكلّف بتصديق مدّعي النبوّة ، فلابدّ أن تتحقّق المعرفة ـ معرفة الاعجاز ـ بالإضافة إلى كلّ واحد منهم ، مع أنّه من المعلوم أنّ معرفة بلاغة القرآن تختصّ ببعض البشر ولا تعمّ الجميع ، من دون فرق في ذلك بين زمان النزول وسائر الأزمنة إلى يوم القيامة ، فكيف يكون القرآن معجزاً بالإضافة إلى جميع البشر ، ويكون الغرض منه هداية الناس من الظلمات إلى النور كما بيّنه نفسه.
والجواب:
عن ذلك: أنّه لا يشترط في المعجز أن يدرك اعجازه الجميع ، بل المعتبر فيه هو ثبوت المعجز عندهم ، بحيث لا يبقى لهم ارتياب في ذلك ، وأنّه قد أتى النبيّ بما يعجز الناس عن الإتيان بمثله ، وإن لم يكن حاضراً عن الإتيان به ، أو لم يكن ممّن يحتمل في حقّه الإتيان بالمثل ، لعدم اطّلاعه على اللغة العربية ، أو لقصور معرفة
(الصفحة99)
بخصائصها ، فإذا ثبت لنا بالنقل القطعي تحقّق الانشقاق للقمر بيد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) تتمّ الحجّة علينا عقلاً ، وإن لم نكن حاضرين عند تحقّقه ، مشاهدين ذلك بأبصارنا وكذا إذا ثبت إخضرار الشجر بأمره ، أو تكلّم الحجر بإشارته.
وفي المقام نقول: بعدما لاحظنا أنّ القرآن نزل في محيط بلغت البلاغة فيه الغاية القصوى ، والعناية بالفصاحة وشؤونها الدرجة العليا ، بحيث لم يروا لغيرها قدراً ، ولا رتّبوا عليه فضيلة وأجراً ، ولعلّ السرّ في ذلك واقعاً هو أنّه عند نزول القرآن لا يكاد يبقى مجال للارتياب في تفوّقه ، واتّصافه بأنّه السلطان والحاكم في الدولة الأدبيّة ، والحكومة العلميّة ، وبعد ملاحظة أنّ القرآن تحدّاهم إلى الإتيان بمثله ، أو بعشر سور مثله ، أو بسورة مثله ، ولم يقع في جواب ذلك النداء إلاّ إظهار العجز ، والاعتراف بالقصور ، ولذا اختاروا المبارزة بالسنان على المعارضة بالبيان ، ورجّحوا المقابلة بالسيوف على المقاومة بالحروف ، وآثروا بذل الأبدان على القلم واللسان ، مع أنّه كان من الجدير للعرب إذا كان ذلك في مقدرتهم أن يجيبوه ، ويقطعوا حجّته ويأتوا ولو بسورة واحدة مثل القرآن في البلاغة ، فيستريحوا بذلك عن تحمّل مشاق كثيرة ، وإقامة حروب مهلكة ، وبذل أموال خطيرة ، وتفدية نفوس محرّمة ، ولكنّهم ـ مع أنّه كان فيهم الفصحاء النابغون والبلغاء المتبحِّرون ـ خضعوا عند بلاغة القرآن ، وأذعنوا بقصورهم ، بل قصور من لم يكن له ارتباط إلى مبدأ الوحي ، ومنبع الكمال من جميع أفراد البشر ، فعند ملاحظتنا ذلك تتمّ الحجّة علينا عقلاً ، وإن لم نكن من تلك الطبقة النابغة في الفصاحة ، والجماعة الممتازة في الفصاحة بل وإن لم نكن عارفين باللغة العربية أصلاً ، كما هو واضح من أن يخفى.
2 ـ منها: انّ القرآن مع أنّه قد وصف نفسه بعدم وجود الاختلاف فيه ، وعدم
(الصفحة100)
اشتماله على المناقضة بوجه ـ ولابدّ من أن يكون كذلك ـ فإنّ الاختلاف لا يناسب مع كونه من عند الله ، الذي لا يغيب عنه شيء ، والمناقضة لا تلائم مع كونه من عند من هو عالم بكلّ شيء ـ قد وقعت فيه المناقضة في موردين:
أحدهما: قوله تعالى في سورة آل عمران 41:
{قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّام إِلاَّ رَمْزاً}.
فإنّه يتناقض مع قوله تعالى في سورة مريم 10:
{قال آيتك ألا تكلّم الناس ثلاث ليال سويّاً}.
والجواب:
عن هذه الشبهة واضح ، فإنّ لفظ «اليوم» قد يستعمل ويراد منه اليوم في مقابل الليل ، وقد يطلق ويراد به المجموع منهما ، وكذلك لفظ «الليل» فإنّه أيضاً قد يطلق ويراد به ما يقابل اليوم ، وقد يستعمل ويراد منه المجموع من اليوم والليلة ، ولا يختصّ هذا الإطلاق والاستعمال بالكتاب العزيز ، بل هو استعمال شائع في العرب ، بل لا ينحصر بتلك اللغة ، فإنّ ما يرادف اليوم في الفارسيّة ـ مثلاًـ قد يطلق ويراد به بياض النهار ، وقد يطلق ويراد به المجموع منه ومن مدّة مغيب الشمس وإشراقها على القارّة الاُخرى ، وكذلك ما يرادف الليل.
ومن الموارد التي استعمل فيها لفظ «اليوم» وكذا «الليلة» واُريد بكلّ واحد ما يقابل الآخر ما جمع فيه بين اللّفظين ، كما في قوله تعالى في سورة الحاقّة 7:
{سخّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوماً}.
وممّا استعمل فيه لفظ اليوم واُريد به المجموع قوله تعالى في سورة هود 56: {تمتّعوا في داركم ثلاثة أيّام} وكذا الآية المبحوث عنها في المقام المشتملة على لفظ
|