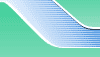(الصفحة141)
المماثلة والسنخية بين السارق والمسروق منه ، من جهة اعتقاد كليهما ببطلان مدّعاهما ، ووقوعهما مغلوبين لهوى النفس وحبّ الجاه والطمع في مطامع الدنيا الزائلة غير الباقية ، والغفلة عن عالم الآخرة ، والعقوبات المعدّة لمضلّي النّاس . وامّا المقايسة بين ما ذكره وبين الكتاب الذي لا يقايس عليه شيء ، وليس كمثله كتاب ، فنقول :
إنّ تبديل كلمة «الكوثر» بلفظ «الجواهر» ممّا لا مسوّغ له ، فإنّ إعطاء الجواهر التي هي من شؤون هذه الدنيا الدنية وزخرفها ، ومن الاُمور المادّية المحضة لا يناسب مع التأكيد والإتيان بكلمة «انّ» ثمّ الاسناد إلى ضمير الجمع ، فإنّ العطية الإلهيّة والعناية الربّانية لا تلائم هذا النحو من الذكر ، والتعبير الكاشف عن العظمة والأهمّية ، إذا كانت من الاُمور المادّية الفانية غير الباقية ، وهذا بخلاف لفظ «الكوثر» الذي معناه هو الخير الكثير العام الشامل للجهات الدنيوية والأخرويّة معاً ، امّا في الدنيا فشرف الرسالة والهداية والزعامة وكثرة الذريّة من البضعة الطاهرة (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يوم القيامة ، الموجبة لبقاء الاسم ، وعدم النسيان ما دامت الدنيا باقية ، وامّا في الآخرة فلا تعدّ ولا تحصى من الشفاعة والجنان وحوض الكوثر ، وغيرها من نعم الله تعالى .
ثمّ ما المناسبة بين إعطاء الجواهر وبين إيجاب الصلاة المتفرّع عليه ، فإنّ الصلاة ـ التي هي معراج المؤمن ، وعمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردَّ ما سواها ، وهي التي أثرها النهي عن الفحشاء والمنكر ، وهي التي تناسب مقام التقوى ، وتكون قربان كلّ تقيّ ، وهي التي خير موضوع من شاء استقلّ ، ومن شاء استكثر ـ لا ملائمة بينها وبين إعطاء الجواهر ، التي هي من النعم الدنية الفانية ،
(الصفحة142)
وهذا بخلاف ترتّب الصلاة على الكوثر بالمعنى الذي عرفت ، فإنّ شدّة الملائمة بين الأمرين ، وكمال المناسبة بين المعنيين غير خفيّ ، كما أنّ ترتّب النحر بناء على أن يكون المراد به هو النحر بمنى ، أو نحر الأضحية في الأضحى واضحة ، ضرورة أنّ ذلك إنّما هو لأجل كون الكمال النفساني كما يتوقّف على الخضوع في مقابل الرب ، والخشوع دونه ، كذلك يتوقّف على صرف المال الذي هو الغاية المهمّة ، والغرض المقصود ، ورفع اليد عنه ، والبذل للناس ، كما أنّه على تقدير كون المراد به هو رفع اليدين إلى النحر في تكبير الصلاة ، أو استقبال القبلة بالنحر تكون المناسبة وصحّة التفرّع واضحة أيضاً .
وامّا قوله : «لا تعتمد قول ساحر» فيرد عليه ـ مضافاً إلى عدم ارتباط معناه بالجملتين الاوّليتين بخلاف قوله تعالى في الكتاب العزيز : «إنّ شانئك هو الأبتر» فإنّ ارتباطه مع الخير الكثير ، الذي من أعظم مصاديقه الصدِّيقة الكبرى ـ سلام الله عليها ـ التي منها تكثّر ذريّة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وتبقى ما بقيت الدهر ظاهر ، وامّا هذا القول السخيف فعدم ارتباطه واضح ـ انّ المراد من قول ساحر ، ومن لفظ ساحر هل هو قول مخصوص من أقواله ، أو ساحر معيّن من السّحرة ، أو جميع أقوال كلّ ساحر مع تقييده بما يرجع إلى جهة سحره ـ لا كلّ أقواله حتّى في الاُمور العادية غير المرتبطة بوصفه العنواني الذي هو السّحر ـ ؟ فلا سبيل إلى الأوّل لعدم قرينة على التعيين لا في ناحية القول ، ولا من جهة القائل .
وامّا الثاني الذي يساعده وقوع النكرة في سياق النهي ـ وهو يدلّ على العموم كوقوعها في سياق النفي ـ فلا مجال له أيضاً ، لأنّ الساحر من حيث هو ساحر لا قول له ولا كلام ، وإنّما يسحر بأعماله وأفعاله ، فلا معنى للنهي عن الاعتماد على
(الصفحة143)
قوله كما هو غير خفيّ .
وامّا معارضة سورة الفاتحة بمثل ما ذكر فيرد عليها ـ مضافاً إلى ما عرفت من بعدها عن حقيقة المعارضة ، ومعناها بمراحل غير عديدة ـ انّه لابدّ من ملاحظة كلّ جملة منها مع آيات الفاتحة ، وجملها الشريفة فنقول :
امّا تبديل قوله تعالى : «الحمد لله» بقوله : «الحمد للرحمن» فمن الواضح انّه يوجب تفويت المعنى المقصود ، فإنّ لفظ الجلالة علم للذات المقدّسة الجامعة لجميع الصفات الكماليّة ـ من دون فرق بين القول بكونه موضوعاً لمعنى عام ينحصر مصداقه في فرد خاص ، وبين القول بكونه علماً لشخص الباري جلّ جلاله ، ضرورة انّه على القول الأوّل يكون ذلك المعنى العام عبارة عن الذات المستجمعة لجميع تلك الصفات ، كما أنّه على القول الثاني تكون تسميته بهذه اللفظة الجميلة إنّما هي باعتبار وصف الاستجامع ، وأين هذا من «الرحمن» الذي هي صفة واحدة من الصفات الكمالية غير العديدة؟ فالغرض من هذه الجملة الكريمة من القرآن اختصاص الحمد بمن كانت جامعة لجميع الصفات الكماليّة ، فكيف يصحّ التبديل بكلمة «الرحمن» مدّعياً كونه وافياً بذلك الغرض ، ومفيداً فائدته كما هو غير خفيّ .
وامّا تبديل قوله تعالى : «ربّ العالمين ، الرحمن الرحيم» بقوله : «ربّ الأكوان» فيرد عليه ـ مضافاً إلى عدم صحّة إضافة كلمة «الربّ» إلى الأكوان ، التي هي جمع الكون بالمعنى المصدري من دون فرق بين أن يكون معناه الحدوث ، أو الوقوع ، أو الصيرورة ، أو الكفالة ـ كما حكي عن بعض كتب اللغة المفصّلة ـ فإنّ معنى الربّ هو المالك المربّي ، ولا معنى لإضافته إلى المعنى المصدري ـ انّ هذا التبديل صار موجباً لتفويت الغرض ، فإنّ توصيف الله تعالى بكونه ربّ العالمين
(الصفحة144)
الرحمن الرحيم يدلّ على أنّه المالك المربّي لجميع العوالم ، وانّ رحمته الواسعة شاملة لها بأجمعها ، رحمة مستمرّة غير منقطعة ، وأين هذا من توصيفه بأنّه ربّ الأكوان .
وكذلك تبديل قوله تعالى : «مالك يوم الدين» بقول هذا القائل الذي أغواه الشيطان : «الملك الديّان» فالجواب عنه : انّ قوله تعالى يكون المعنى المقصود منه انّ هنا يوماً يسمّى يوم الجزاء ، وعالماً استعدّ لمكافأة الأعمال ، إن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ ، وانّ مالك ذلك اليوم ، والمتصرّف النافذ فيه هو الله تبارك وتعالى ، وأين هذا من قول هذا القائل لعدم دلالته على وجود ذلك اليوم المعدّ للجزاء والمكافأة .
وكذلك تغيير قوله تعالى : «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» بقوله : «لك العبادة وبك المستعان» يوجب فوات المعنى المقصود منه الراجع إلى إظهار المؤمن التوحيد في العبادة ، والافتقار إلى الاستعانة بالله فقط ، وانّه لا يخضع لغير الله ، ولا يعبد إلاّ إيّاه ، ولا يستعين إلاّ به ، ففي الحقيقة مرجعه إلى بيان وصف المؤمن ، وانّه في مقام العبادة والاستعانة لا يرى ما سوى الله مستأهلاً لذلك ، صالحاً لأن يعبد أو يستعان به ، وأين هذا المعنى اللطيف الراجع إلى التوحيد في مقام العبادة والاستعانة ـ سيّما مع ملاحظة ابتلاء عرب الجاهلية في ذلك العصر بالشرك في مقام العبادة والاستعانة ، وخضوعهم في مقابل الأوثان ، وطلب الإعانة منهم ، واعتقادهم انّهم يقرّبونهم إلى الله زلفى ، وانّهم الشفعاء عند الله ـ من قول هذا القائل الراجع إلى انحصار العبادة والاستعانة به تعالى ، من دون نظر إلى حال المؤمن ، وإظهاره التوحيد ، وامتيازه عن العرب في ذلك العصر ، كما لا يخفى .
وكذلك إبدال قوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم» بقول هذا القائل الجاهل «اهدنا صراط الايمان» ـ مضافاً إلى عدم كونه موجباً للاختصار إلاّ من ناحية
(الصفحة145)
الألف واللام فقط ، ومن المعلوم عدم دخالتهما في معنى الكلمة ـ يستلزم تضييق معنى وسيع ، فإنّ الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق المتصوّرة إلى المعنى المقصود لا ينحصر بوجه خاصّ ، ولا يختصّ بجانب مخصوص ، بل يعمّ جميع الوجوه والجوانب من العقائد الصحيحة ، والملكات الفاضلة ، والأعمال الحسنة المطلوبة ، وأين هذا من التخصيص بصراط الايمان الذي هو أمر قلبي اعتقادي ، ولا يشمل غيره أصلاً ، كما لا يخفى .
وقد زعم الكاتب الجاهل ، والأجير العامل ، حيث اقتصر في مقام المعارضة مع سورة الفاتحة على هذه الجمل ، ولم يعقّبها بشيء ، إنّ بقيّة السورة المباركة مستغن عنها لا حاجة إلى إضافتها أصلاً ، لعدم إفادتها شيئاً زائداً على ما هو مفاد الجملات التي ذكرها ، مع أنّها تدلّ على مطلب أساسي ، وهو انقسام الناس من جهة الوصول إلى السعادة المطلوبة ، وسلوك الطريق إلى الكمال المعنوي إلى أقسام ثلاثة :
قسم : هم الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ، وهم الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم ، ووصلوا إلى الغرض الأغلى والغاية القصوى ، وينبغي أن يطلب من الله الهداية إليه ، والدخول في زمرتهم ، وسلوك طريقهم ، والكون معهم .
وقسم : وقع غضب الله عليهم ، وهم الذين أنكروا الحقّ بعد وضوحه ، وعاندوه بعد ظهوره ، ونهضوا لإطفاء نوره ، وقاموا في مقابلته وجاهدوا في طريق الباطل .
والقسم الثالث : هم الضالّون الذين ضلّوا عن طريق الهدى ، وانحرفوا عن
(الصفحة146)
الصراط المستقيم بجهلهم وتشبّثهم بما لا يتشبّث به العاقل من تقليد الآباء والأجداد ، وغيره من الطرق المنحرفة غير المستقيمة .
ولعلّ اقتصار الكاتب على الجملات التي ذكرها ، وعدم تعرّضه لمعارضة بقيّة السور كان لأجل وضوح كونه غير القسم الأوّل ، بل من القسم الثاني نعوذ بالله من متابعة الشيطان ، والقيام في مقابل الرحمن ، مع وضوح الحقّ ، وهداية البرهان .
وهنا نختم البحث في إعجاز القرآن ونستمدّ منه الخروج من الظلمات إلى النور .
(الصفحة147)
حول القُرّاء والقراءات
(الصفحة148)
دعوى تواتر القراءات . من هم القرّاء السبع . أدلّة منكري التواتر . أدلّة القائلين بالتواتر والجواب عنها . حجّية القراءات . جواز القراءة بها في الصلاة
(الصفحة149)
والكلام فيها يقع في مقامات :
المقام الأوّل ـ دعوى تواتر القراءات
نسب إلى المشهور بين علماء أهل السنّة القراءات السبع المعروفة بين الناس متواترة ، ومقصودهم ـ ظاهراً ـ هو التواتر عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بمعنى أنّه قد ثبت بالتواتر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) انّه قرأ على وفق هذه القراءات ، وحكى عن بعضهم القول بتواتر القراءات العشر ، بل عن بعضهم أنّ من قال : إنّ القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر : فقوله كفر .
والمعروف بين الشيعة الإماميّة انّها غير متواترة ، بل هي بين ما هو اجتهاد من القارئ ، وبين ما هو منقول بخبر الواحد ، واختار هذا القول جماعة من المحقّقين من العامّة ، ولا يبعد دعوى كونه هو المشهور بينهم ، وسيأتي نقل بعض كلماتهم في هذا المقام .
وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تقديم مقدّمة تنفع لغير المقام أيضاً وهي : إنّ ثبوت القرآن واتّصاف كلام بكونه كذلك أي قرآناً ينحصر طريقه بالتواتر كما أطبق عليه المسلمون بجميع نحلهم المختلفة ومذاهبهم المتفرّقة .
(الصفحة150)
بيان ذلك : انّه ربّما يمكن أن يتوهّم في بادئ النظر انّه ما الفرق بين كلام الله الذي ادّعى عدم ثبوته إلاّ بالتواتر ، وبين كلام المعصوم ـ نبيّاً كان أو إماماًـ حيث لا ينحصر طريق ثبوته به ، بل يثبت بخبر الواحد الجامع لشرائط الاعتبار والحجّية ، فكما أنّ خبر زرارة وحكايته يثبت صدور القول الدالّ على وجوب صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ من الإمام (عليه السلام) فما المانع من أن يكون خبر الواحد مثبتاً أيضاً لكلام الله تبارك وتعالى ، بل ربما يمكن أن يزاد بأنّ ثبوت القرآنية لا طريق له إلاّ قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واخباره بأنّه قرآن وكلام إلهي . وعليه يتوجّه سؤال الفرق بين كلام النبي المتضمّن لثبوت حكم من الأحكام الشرعية وبين إخباره بأنّ الآية الفلانية من القرآن فكما أنّه يثبت الأوّل بخبر الواحد كذلك لا مجال للمناقشة في ثبوت الثاني به أيضاً ، وعدم انحصاره بالتواتر ، هذا غاية ما يمكن أن يتوهّم في المقام .
ويدفعه :
ما عرفت من إطباق المسلمين بأجمعهم على ذلك ، حتّى ذكر السيوطي : انّ القاضي أبا بكر قال في الانتصار : «ذهب قوم من الفقهاء والمتكلِّمين إلى إثبات القرآن حكماً لا علماً بخبر الواحد ، دون الاستفاضة ، وكره ذلك أهل الحقّ وامتنعوا منه» .
وهذا الأصل الذي مرجعه إلى عدم ثبوت وصف القرآنية إلاّ بالتواتر كان مسلّماً عندهم ، بحيث بنى المالكيّة وغيرهم ممّن قال بإنكار البسملة قولهم على هذا الأصل ، وقد ردّه بأنّها لم تواتر في أوائل السور ، وما لم تتواتر فليس بقرآن ، ولكنّهم أجابوا عنه بمنع كونها لم تتواتر ، ويكفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة ، فمن بعدهم بخط المصحف ، مع منعهم أن يكتب في المصحف ما ليس منه ، كأسماء
(الصفحة151)
السور ، وآمين ، والاعشار ، فلو لم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخطّه من غير تمييز ، لأنّ ذلك يحمل على اعتقادها قرآناً ، فيكونون مغررين بالمسلمين ، حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً ، وهذا ممّا لا يجوز اعتقاده في الصحابة .
ونقلوا في إثبات كون البسملة قرآناً روايات كثيرة : أخرجها أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم ، كلّها تدلّ على كونها من الآيات القرآنية ، بل في بعضها : «أعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم» وفي بعضها عن ابن عبّاس قال : «أغفل الناس آية من كتاب الله لم ينزل على أحد سوى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ أن يكون سليمان بن داود : بسم الله الرحمن الرحيم» وفي بعضها : «انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين لا يعلمون فصل الصورة وانقضائها حتّى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت علموا أنّ السورة قد انقضت» .
ولأجل تسلّم هذا الأصل قال السيوطي في الاتقان : «من المشكل على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي ، قال : نقل في بعض الكتب القديمة انّ ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوّذتين من القرآن . وهو في غاية الصعوبة ، لأنّا إن قلنا إنّ النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن ، فإنكاره يوجب الكفر ، وإن قلنا لم يكن حاصلاً في ذلك الزمان ، فيلزم أنّ القرآن ليس بمتواتر في الأصل ، والأغلب على الظنّ أنّ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل ، وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة» .
ثمّ نقل السيوطي أقوالاً مختلفة في هذه الحكاية راجعة إلى تكذيبها ، وانّه موضوع على ابن مسعود أو إلى بطلان ما ذكره ، وعدم صحّته بوجه ، أو إلى تأويله بحيث لا ينافي كونها من القرآن بنحو التواتر .
(الصفحة152)
وبالجملة : ثبوت هذا الأصل بينهم ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، وهو يكفي في مقام الجواب عن ذلك التوهّم ، والفرق بين القرآن وغيره مضافاً إلى أنّه لا محيص عن انحصار ثبوت القرآن بالتواتر ، وذلك لتوفّر الدواعي على نقله ، ضرورة أنّه من أوّل نزوله لم ينزل بعنوان بيان الأحكام فقط ، بل بعنوان المعجزة الخالدة ، الذي يعجز الإنس والجنّ إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل سورة منه ، وقد مرّ في بحث الإعجاز دلالة القرآن بنفسه على كونه معجزة خالدة ، وفي مثل ذلك يتوفّر الدواعي على نقله وضبطه ، ليحفظ ويبقى ببقائه الدين الحنيف ، الذي هو أكمل الأديان ، وأتمّ الشرائع ، وعليه فما نقل بطريق الآحاد لا يكون قرآناً قطعاً ، وإلاّ لكانت الدواعي على نقله متوفّرة ، وبذلك يخرج عن الآحاد ، فالمشكوك كونه قرآناً يقطع بعدم كونه منه ، وخروجه عن هذا الوصف الشريف ، نظير ما ذكروه في الاُصول من أنّ الشكّ في حجّية أمارة مساوق للقطع بعدم الحجّية ، وعدم ترتّب شيء من آثار الحجّة عليه .
والمقام نظير ما إذا أخبر واحد بدخول ملك عظيم في البلد ، مع كون دخوله فيه ممّا لا يخفى على أكثر أهله ، لاستلزامه ـ عادة ـ اطّلاعهم وتهيّؤهم للاستقبال ونحوه من سائر الاُمور الملازمة لدخوله كذلك ، ففي مثل ذلك يكون اخبار واحد فقط موجباً للقطع بكذبه أو اشتباهه ، لاستحالة اطّلاعه فقط ـ عادةً ـ فكيف يكون الكتاب الذي هو الأساس للدين الإسلامي ، ولابدّ من أن يرجع إليه إلى يوم القيامة كلّ من يريد الأخذ بالعقائد الصحيحة ، والملكات الفاضلة ، والأعمال الصالحة ، والدساتير العالية ، والاطّلاع على القصص الماضية ، وحالات الاُمم السالفة ، وغير ذلك من الشؤون والجهات اتي يشتمل عليها الكتاب العزيز ، ممّا
(الصفحة153)
يكفي في ثبوته النقل بخبر الواحد ، وليس ذلك لأجل مجرّد كونه كلام الله تبارك وتعالى ، بل لأجل كونه كلام الله المتضمّن للتحدّي والإعجاز ، والهداية والإرشاد ، وإخراج جميع الناس من الظلمات إلى النور إلى يوم القيامة ، وإلاّ فمجرّد كلام الله تعالى إذا لم يكن متضمّناً لما ذكر ، كالحديث القدسي لا يلزم أن يكون متواتراً .
فقد ظهر الفرق بين مثل الكتاب الذي ليس كمثله كتاب ، وبين كلام المعصوم ـ نبيّاً كان أو إماماً ـ الذي لا ينحصر طريق ثبوته بالتواتر ، فإنّ دليل حجّية خبر الواحد الحاكي لكلام المعصوم إنّما هو ناظر إلى لزوم ترتيب الآثار عليه ، والأخذ به في مقام العمل ، ولا يلزم فيه الاعتقاد بصدوره عنه ، وانّه كلامه ، لأنّ الغرض مجرّد تطبيق العمل في الخارج عليه ، لا صدوره واسناده إليه ، وهذا بخلاف كلام الله المنزل المقرون بالتحدّي والاعجاز ، ويكون هو الأساس للدين والأصل للهداية والميزان ، للخروج من ظلمات الجهل والانحراف إلى عالم نور العلم والمعرفة ، فإنّه لابدّ في مثل ذلك من وضوح كونه كلام الله ، وظهور صدوره عنه تبارك وتعالى .
أضف إلى ذلك أنّ القرآن ـ كما مرّ في بحث الإعجاز مفصّلاً ـ نزل في محيط البلاغة والفصاحة ، وكان واقعاً في المرتبة التي عجز البلغاء عن النيل إليها ، والفصحاء عن الوصول إلى مثلها ، ولأجله خضع دونه البعض ، ونسب البعض الآخر إليه السحر ، ومن هذه الجهة كان موضعاً لعناية المتخصّصين في هذا الفنّ الذي كان هو السبب الوحيد عندهم للفضيلة والشرف ، وبه يقع التفاخر بينهم .
ومن الواضح أنّه مع هذه الموقعية يكون كلّ جزء من أجزائه ملحوظاً لهم ، منظوراً عندهم ، من دون فرق في ذلك بين من آمن به ، ومن لم يؤمن ، فكيف يمكن أن ينحصر نقل مثل ذلك بخبر الواحد ، كما هو غير خفيّ على من كان بعيداً عن
(الصفحة154)
التعصّب والعناد ، متّبعاً لحكم العقل والنظر السداد .
ثمّ انّه ظهر ممّا ذكرنا : انّ اتصاف نقل القرآن بالتواتر ، وانحصاره به إنّما هو على سبيل الوجوب واللزوم ، بمعنى أنّ تواتره لا يكون مجرّد أمر واقع في الخارج ، من دون أن يكون وقوعه لازماً ، والاتّصاف بذلك واجباً ، بل الظاهر لزوم اتّصافه به ، وكون وقوعه في الخارج إنّما هو لأجل لزوم وقوعه فيه كذلك ، لعين ما تقدّم من أصل الدليل على تواتره ، ومناقشة المحقّق القمّي (قدس سره) في هذه الجهة حيث قال : «إنّه ـ يعني وجوب التواتر ـ إنّما يتمّ لو انحصر طريق المعجزة وإثبات النبوّة لمن سلف وغبر فيه ، ألا ترى أنّ بعض المعجزات ممّا لم يثبت تواتره ، وأيضاً يتمّ لو لم يمنع المكلّفون على أنفسهم اللطف ، كما صنعوه في شهود الإمام (عليه السلام)» ليس في محلّها ، فإنّك عرفت أنّ الكتاب هو المعجزة الخالدة الوحيدة ، وانّ نفسه يدلّ على اتّصافه بهذا الوصف ، وانّه الذي لو اجتمع الإنس والجنّ ـ إلى يوم القيامة ـ على الإتيان بمثله لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، وهو الذي يخرج به جميع الناس إلى ذلك اليوم من الظلمات إلى النور ، وانّه الذي يكون نذيراً للعالمين ، فمثل ذلك لو لم يلزم تواتره يلزم عدم حصول الغرض المقصود ، وهو السرّ في عدم ثبوت بعض المعجزات بالتواتر ، لأنّ تواتر القرآن ـ ولزومه كذلك ـ يغني عن اتّصاف غيره من المعجزات بالتواتر ، ومقايسة الكتاب الذي يتّصف بما وصف بمثل شهود الإمام (عليه السلام)الذي منع المكلّفون على أنفسهم اللطف فيه ، غير صحيحة جدّاً ، فهل يمكن أن يصير منع اللطف سبباً لأن تخلو الاُمّة من الإمام رأساً ، فكيف يمكن أن يصير سبباً لعدم لزوم اتّصاف القرآن بالتواتر ، مع إيجابه نقض الغرض ، واستلزامه عدم تحقّق المعنى المقصود من إنزاله .
(الصفحة155)
وممّا ذكرنا انقدح انّه كما لا تثبت القرآنية واتّصاف كلام بكونه كلام الله المنزل على الرسول الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) بعنوان الإعجاز إلاّ بالتواتر ، كذلك اتّصافه بكونه آية لسورة فلانية ، دون السور الاُخرى ، فمثل اتّصاف قوله تعالى : {فبأي آلاء ربّكما تكذّبان} بكونه جزء لسورة «الرحمن» دون غيرها من السور القرآنية ، لا طريق له إلاّ التواتر لعين ما ذكر في أصل الاتّصاف بالقرآنية ، وكذا اتّصاف الآية الفلانية بكونها في محلّها ، وفي موضعها من السورة التي هي جزء لها لا يثبت إلاّ بالتواتر أيضاً ، فاتّصاف قوله تعالى : {اهدنا الصراط المستقيم} بوقوعه بعد قوله تعالى : {مالك يوم الدين} وقبل قوله تعالى : {صراط الذين أنعمت عليهم} لا يثبت إلاّ بالتواتر لما ذكر ، وكذا من جهة الاعراب فقوله : «والأرحام» في آية {واتّقوا الله الذي تسائلون به والأرحام} لابدّ وأن تثبت مفتوحيّته أو مجروريّته بالتواتر ، لاختلاف المعنى بمثل ذلك .
نعم ربما يقال : إنّ مثل الامالة والمدّ واللين لا يلزم فيه التواتر لأنّ القرآن هو الكلام ، وصفات الألفاظ ليس كلاماً ، ولأنّه لا يوجب ذلك اختلافاً في المعنى ، فلا تتعلّق فائدة مهمّة بتواتره ، ولكنّه محلّ نظر ، بل منع ، فتأمّل .
(الصفحة156)
من هم القرّاء؟
إذا تمهّدت لك هذه المقدّمة الشريفة النافعة فإنّه يقع الكلام في دعوى تواتر القراءات السبع ، كما عليه جماعة من علماء أهل السنّة ، بل نسب إلى المشهور بينهم ، بل قيل : إنّه الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن .
ونذكر أوّلاً ترجمة هؤلاء القرّاء بنحو الإجمال فنقول :
1 ـ عبدالله بن عامر الدمشقي ، ولد سنة ثمان من الهجرة وتوفّي سنة 118 ، وله راويان رويا قراءته بوسائط ، وهما : هشام ، وابن ذكوان .
2 ـ عبدالله بن كثير المكّي ، ولد بمكّة سنة 45 ، وتوفى سنة 120 ، وله راويان بوسائط أيضاً هما : البزّي ، وقنبل .
3 ـ عاصم بن بهدلة الكوفي ، مات سنة 127 أو 128 ، وله راويان بغير واسطة هما : حفص ، وأبو بكر .
4 ـ أبو عمرو البصري ، ولد سنة 68 ، وقال غير واحد : مات سنة 154 ، وله راويان بواسطة يحيى بن المبارك اليزيدي هما : الدوري ، والسوسي .
5 ـ حمزة الكوفي ولد سنة 80 ، وتوفى سنة 156 ، وله راويان بواسطة ، هما : خلف بن هشام ، خلاّد بن خالد .
6 ـ نافع المدني ، مات سنة 169 ، وله راويان بلا واسطة هما : قالون ،
(الصفحة157)
وورش .
7 ـ الكسائي الكوفي ، واختلف في تاريخ موته ، وأرّخه غير واحد من العلماء والحفّاظ سنة 189 ، وله راويان بغير واسطة هما : الليث بن خالد ، وحفص بن عمر .
وامّا الثلاثة المتمِّمة للعشرة :
1 ـ خلف بن هشام البزار ، الذي هو أحد الراويّين عن حمزة الكوفي ، ولد سنة 150 ، ومات سنة 229 ، وله راويان هما : إسحاق ، وإدريس .
2 ـ يعقوب بن إسحاق ، مات في ذي الحجّة سنة 205 ، وله ثمان وثمانون سنة ، وله راويان هما : رويس ، وروح .
3 ـ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، مات بالمدينة سنة 130 ، وله راويان هما : عيسى ، وابن جماز .
إذا عرفت ما ذكرنا نقول : إنّ المراد بتواتر القراءات السبع أو العشر ، إن كان هو التواتر عن مشايخها وقرّائها ، بحيث كان إسناد كلّ قراءة إلى شيخها وقاريها ثابتاً ، بنحو اليقين الحاصل من أخبار جماعة يمتنع ـ عادةً ـ تواطؤهم على الكذب ، وتوافقهم على خلاف الواقع ، وكان هذا الوصف موجوداً في جميع الطبقات ، لوجود الوسائط المتعدّدة ، ـ على ما عرفت ـ من تاريخ حياتهم ومماتهم ، ومن الواضح انّ التواتر في مثل هذا الخبر لابدّ وأن تكون رواته في جميع الطبقات كذلك ، أي كانوا جماعة يستحيل عادة اتّفاقهم على الكذب ، فالجواب عنه أمران :
الأوّل : انّك عرفت في تراجمهم : انّ لكلّ من القرّاء السبع ، أو العشر راويين رويا قراءته ـ من دون واسطة أو معها ـ ومن المعلوم انّه لا يتحقّق التواتر بمثل ذلك ،
(الصفحة158)
ولو ثبت وثاقتهما ، فضلاً عمّا إذا لم تثبت الوثاقة كما في بعض الرواة عنهم .
الثاني : انّه على تقدير ثبوت قراءة كلّ منهم بنحو التواتر عنهم ، فهذا لا يترتّب عليه أثر ، ولا فائدة فيه بالإضافة إلينا ، ضرورة أنّهم ليسوا ممّن يكون قوله حجّة علينا ، ولا دليل على اعتبار قولهم أصلاً ، كما هو واضح من أن يخفى .
وإن كان المراد ـ بتواتر القراءات ـ هو التواتر عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كما هو الظاهر من قولهم بحيث كان المراد انّ النبيّ بنفسه الشريفة قرأ على وفق تلك القراءات المختلفة ، بمعنى انّه قرأ على طبق قراءة عبدالله بن عامر ـ مثلاً ـ مرّة ، وعلى وفق قراءة عبدالله بن كثير تارةً اُخرى ، وهكذا ، وكان ذلك ثابتاً بنحو التواتر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) فيردّه اُمور :
الأوّل : ما عرفت من عدم ثبوت تلك القراءات عن مشايخها وقرّائها بنحو التواتر ، فضلاً عن ثبوتها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كذلك .
الثاني : انّه على تقدير ثبوتها بنحو التواتر عنهم ـ أي عن المشايخ والقرّاءـ فاتّصال أسانيد القراءات بهم أنفسهم ، أو انقطاعها مع الوصول إليهم ، بداهة انتهاء السند إلى الشيخ والقارئ في كلّ قراءة اجتهاديّة ، وعدم التجاوز عنه إلى غيره يمنع عن تحقّق التواتر ، إمّا لأجل انقطاع السند ، وعدم التجاوز عن الشيخ إلى من قبله ، وإمّا لأجل أنّه يلزم ـ في تحقّق التواتر ـ اتّصاف الرواة في جميع الطبقات بكونهم ممّن يمتنع ـ عادةً ـ تواطؤهم على الكذب ، واخبار خلاف الواقع ، وفي رتبة القرّاء أنفسهم لا يكون هذا الشرط بمتحقّق أصلاً ، لأنّه في هذه الرتبة لا يكون الراوي إلاّ واحداً ، أو هو الشيخ والقارئ وحده ، فلا يبقى حينئذ مجال لاتّصاف القراءات بالتواتر عن النبيّ ، كما هو المفروض .
(الصفحة159)
الثالث : استدلال كلّ واحد منهم واحتجاجه ـ في مقام ترجيح قراءته على قراءة غيره وإعراضه عن قراءة غيره ـ مع أنّه لو كانت بأجمعها متواترة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحتجّ إلى الاحتجاج ، ولم يكن وجه للإعراض عن قراءة غيره ، بل لم يكن وجه ترجيح قراءته على قراءة الغير ورجحانها عليها ، فإنّه بعد ثبوت انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قرأ على وفق جميعها لا يكون مجال للمقايسة ، ولا يبقى موقع لاحتمال رجحان بعضها على الآخر أصلاً ، كما هو واضح لا يخفى .
الرابع : إضافة هذه القراءات إلى خصوص مشايخها وقرّائها ، فإنّه على تقدير كونها ثابتة بنحو التواتر عن النبي ، الذي نزل عليه الوحي لما كان وجه لإضافة هذه القراءات إلى هؤلاء الأشخاص ، بل كان اللاّزم إضافة الجميع إلى الواسطة بين الخلق والخالق ، ومن نزل عليه كلام الله المجيد ، بل اللاّزم الإضافة إلى الله تبارك وتعالى ، لأنّ قراءة النبي لم تكن من عند نفسه ، بل حكاية لما هو في الواقع ، ووحي يوحى إليه وبالتالي لا يكون لهؤلاء القرّاء على هذا التقدير المفروض امتياز ، وجهة اختصاص موجبة للإضافة إليهم دون غيرهم ، ومجرّد وقوعهم في طريق النقل المتواتر لا يوجب لهم مزيّة وخصوصية ، واختيار كلّ واحد منهم لقراءة خاصّة ـ مع أنّه لم يكن وجه ـ كما عرفت في الأمر الثالث ـ لا يصحّح الاسناد والإضافة أصلاً ، فلابدّ من أن يكون لهذه الإضافة وجه وسبب ، وليس ذلك إلاّ مدخلية اجتهادهم واستنباطهم في قراءتهم .
وبالجملة : نفس إضافة القراءات إلى مشايخها ، دون من نزل عليه الوحي دليل قطعي على عدم ثبوتها بنحو التواتر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلاّ فلا مجال لهذا الاسناد ، وهذه الإضافة .
(الصفحة160)
الخامس : شهادة غير واحد من المحقّقين من أعلام أهل السنّة على عدم تواتر القراءات ، وإنكار بعضهم على جملة من القراءات والإيراد عليه ، وعلى فرض صدق التواتر وتحقّقه مع شرائطه لا يرى وجه للاعتراض والإيراد على شيء من القراءات ، وهل هو حينئذ إلاّ إيراد على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) واعتراض عليه ـ نعوذ بالله منه ـ .
|