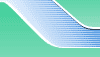(الصفحة 301)
[اعتبار العدالة في المفتي والقاضي وطرق ثبوتها]
مسألة 27: يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تُعرف بُحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم 1 .
1 ـ أمّا اعتبار العدالة في المفتي ، فقد عرفت الكلام فيه في شرائط من يرجع
إليه للتقليد(1) .
وأمّا اعتباره في القاضي ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى الإجماع ، وإلى الأولويّة القطعيّة الثابتة للمقام بالإضافة إلى إمام الجماعة والشاهد ; فإنّه إذا اعتبرت العدالة في إمام الجماعة ، مع أ نّه لا يبلغ من الأهمّية منصب الإفتاء والقضاء ، فاعتبارها فيهما بطريق أولى ، وإلى أنّ التحاكم والترافع إلى الفاسق من المصاديق الظاهرة للركون إلى الظلمة المنهيّ عنه في الشريعة المقدّسة ، وإلى أنّ الخصوصيّات التي اعتبرها الشارع في القضاء والقاضي لا تلائم إلاّ مع ثبوت وصف العدالة للقاضي ، كما هو ظاهر لمن تأمّلهاـ روايات :
منها : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : اتّقوا الحكومة ; فإنّ
(1) في ص98 ـ 103 .
(الصفحة 302)
الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ(1) .
ومنها : صحيحة أبي خديجة قال : بعثني أبو عبدالله(عليه السلام) إلى أصحابنا ، فقال : قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة ، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا ; فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً . وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً
إلى السلطان الجائر(2) .
فإنّ في تعليق النهي عن التحاكم على وصف الفسق إشعاراً بل دلالة على أنّ
الفاسق لا يكون أهلا لذلك .
ثمّ إنّ طريق ثبوت العدالة ما ستعرف مفصّلا إن شاء الله تعالى ، ويأتي(3) أ نّه
قد جعل الشارع لها أمارة موسومة بحسن الظاهر ، وأنّ كاشفيّته لا تختصّ بما إذا أفاد العلم أو الاطمئنان ، بل هو كاشف شرعيّ تعبّديّ ، وأنّ حسن الظاهر قد يحرز من طريق المعاشرة ، وقد يحرز من غير هذا الطريق ، فانتظر .
(1) الكافي : 7 / 406 ح1 ، الفقيه : 3 / 4 ح7 ، تهذيب الأحكام : 6 / 217 ح511 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 17 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب3 ح3 .
(2) تهذيب الأحكام : 6 / 303 ح846 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 139 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح6 .
(3) في ص305 ـ 306 و 365 ـ 369 .
(الصفحة 303)
[معنى العدالة ومفهومها]
مسألة28: العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى ; مِن ترك المحرّمات وفِعل الواجبات.
مسألة29: تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية 1
1 ـ الكلام في هاتين المسألتين يقع في مقامين :
المقام الأوّل : معنى العدالة ومفهومها ، وهي لغة بمعنى الاستواء أو الاستقامة
أو هما معاً ، وقد اختلف الأصحاب ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ في بيان المراد من هذه اللفظة الواردة في كلام الشارع والمتشرّعة على أقوال يرجع ظاهرها
إلى خمسة :
أحدها : ما هو المشهور بين العلاّمة(1) ومن تأخّر عنه(2) ، بل نسب إلى المشهور بقول مطلق ، بل إلى العلماء أو الفقهاء أو الموافق والمخالف (3)، من أنّها كيفيّة نفسانيّة راسخة في النفس ، باعثة على ملازمة التقوى ، أو عليها مع المروءة ، وقد وقع الاختلاف بين أصحاب هذا القول من جهة التعبير بلفظ الكيفيّة ، أو الملكة ، أو
(1) إرشاد الأذهان : 2 / 156 ، مختلف الشيعة : 8 / 501 .
(2) ذكرى الشيعة: 4/101 ، التنقيح الرائع: 4 / 289 ، جامع المقاصد : 2 / 372 ، الروضة البهية : 1 / 378 ـ 379 .
(3) مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 351 و ج 12 / 311 ، مفتاح الكرامة: 3 / 80 ، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع: 1 / 428 .
(الصفحة 304)
الحالة ، أو الهيئة ، أو أشباه ذلك ، ولكنّ المراد واحد ; وهو الأمر النفسانيّ الباعث على ذلك .
ثانيها : أنّ العدالة عبارة عن مجرّد الاجتناب عن المعاصي ، أو خصوص الكبيرة منها ، وهو الظاهر من محكيّ السرائر ، حيث قال : حدّ العدل هو الذي لا يُخِلّ بواجب ، ولا يرتكب قبيحاً(1) . وعن المحدّث المجلسي(2) والمحقّق السبزواري(قدس سرهما)(3)نسبة هذا القول إلى الأشهر ، ومرجعه إلى أنّ العدالة عبارة عن الاستقامة العمليّة في جادّة الشريعة في أفعاله وتروكه ، من دون اعتبار كون ذلك ناشئاً عن الملكة والحالة النفسانيّة .
والظاهر أنّ المراد بهذا القول هو القول الأوّل ; فإنّ ظاهر عدم الإخلال بالواجب ـ خصوصاً مع التعبير عنه بصيغة المضارع ـ هو أن لا يكون من شأنه الإخلال بالواجب وارتكاب القبيح ، وهو لا يكاد ينطبق إلاّ على الملكة والحالة النفسانيّة ، وبعبارة اُخرى : ليس المراد بعدم الإخلال إلاّ عدمه مطلقاً ولو في الاستقبال ، وهذا لا يكاد يحرز مع عدم الملكة أصلا .
ويؤيّده ما عرفت من أ نّه نسب هذا القول المحدّث المجلسي والمحقّق السبزواري(قدس سرهما) إلى الأشهر ، مع أ نّه لا ريب في أنّ التفسير بالملكة أشهر ، فيدلّ ذلك على أنّ مرادهما من الاجتناب عن المعاصي ، وعدم الإخلال بالواجب ; هو ما يكون ناشئاً عن الملكة ، كما هو ظاهر .
ثالثها : أنّه عبارة عن الاستقامة الفعليّة العمليّة منضمّة إلى الملكة النفسانيّة ،
(1) السرائر : 1 / 280 .
(2) بحار الأنوار : 88 / 25 .
(3) كفاية الفقه، المشتهر بـ«كفاية الأحكام» : 1 / 138 .
(الصفحة 305)
وهذا المعنى وإن كان بظاهره يغاير المعنى الأوّل ; فإنّ الملكة التي فُسِّرت بها العدالة ـ بناءً على المعنى الأوّل ـ لا تُنافي حصول المعصية الكبيرة ، كما أنّ الاجتناب عن المعاصي يمكن أن يتحقّق من دون ملكة ، إلاّ أ نّه بعد ملاحظة أنّ مراد القائل بالمعنى الأوّل ليس مجرّد حصول الملكة ولو لم يتحقّق الاجتناب عن المعاصي فعلا ; للإجماع على أنّ فعل الكبيرة قادح في العدالة .
فاللازم أن يُقال بأنّ مراده هي الملكة والاجتناب الفعلي ، فلا مغايرة بين التفسيرين ، ولا تنافي بين المعنيين إلاّ في مجرّد أنّ مرجع الوجه الأوّل إلى أنّ العدالة عبارة عن الملكة الباعثة على الاجتناب العملي ، ومرجع الوجه الأخير إلى أنّها عبارة عن العمل الخارجي ، والاجتناب الفعلي الناشىء عن الحالة النفسانيّة ، وهذا المقدار من الفرق لا يترتّب عليه ثمرة أصلا .
رابعها : الإسلام وعدم ظهور الفسق ، وهو المحكي عن ابن الجنيد(1) ، والمفيد في كتاب الإشراف(2) ، والشيخ في كتابي المبسوط(3) والخلاف(4) مدّعياً عليه الإجماع ، وحكي هذا المعنى عن أبي حنيفة من العامّة(5) .
خامسها : حسن الظاهر ، ومرجعه إلى كونه في الظاهر يعدّ رجلا صالحاً مطيعاً
(1) حكى عنه في مختلف الشيعة : 2 / 513 .
(2) لم نعثر عليه في كتاب الإشراف ، المطبوع في ضمن المجلّد التاسع من سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد . نعم حكى عنه في مفتاح الكرامة : 3 / 80 ، وجواهر الكلام : 13 / 280 ، والشيخ الأنصاري في رسالته في العدالة .
(3) المبسوط : 8 / 217 .
(4) الخلاف : 6 / 217 ـ 218 مسألة 10 .
(5) المغني لابن قدامة : 12 / 30 ، الشرح الكبير : 12 / 40 ، المبسوط للسرخسي : 16 / 132 ، الخلاف : 6/301 مسألة 50 .
(الصفحة 306)
للأوامر والنواهي الشرعيّة ، نسب هذا القول إلى جماعة ، بل إلى أكثر القدماء(1) . والظاهر أنّ هذين المعنيين ليسا قولين في العدالة وتفسيرين لها ; لأنّها من الأوصاف الواقعيّة والفضائل النفس الأمريّة ، ومجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر لا يوجب أن يكون الشخص متّصفاً بهذه الصفة واقعاً ; فإنّه يمكن أن يكون في الواقع فاسقاً . غاية الأمر أ نّه لم يظهر فسقه ، بل كان ظاهره حسناً .
وبعبارة اُخرى : مقتضى ذلك أن تكون العدالة من الأُمور التي يكون وجودها الواقعي عين وجودها الذهني ، وهذا لا يلائم مع كون ضدّها ـ وهو الفسق ـ من الأُمور الواقعيّة التي لا دخل للذهن فيها ، ولا مدخليّة للعلم في تحقّقها.
والدليل عليه ـ مضافاً إلى الإجماع ـ : إضافة كلمة الظهور إلى الفسق في التفسير الرابع ، وعليه : فمن كان في علم الله مرتكباً للكبائر مع عدم ظهور ذلك لأحد يلزم أن يكون عادلا واقعاً وفاسقاً واقعاً . وكذا لو علمنا بأنّ زيداً مع اتّصافه بحسن الظاهر سابقاً كان في ذلك الزمان مرتكباً للكبائر ، يلزم أن يكون في ذلك الزمان عادلا واقعاً لاتّصافه بحسن الظاهر ، وفاسقاً كذلك لأجل الارتكاب للكبيرة ، وبطلان هذا أوضح من أن يخفى .
فاللازم أن يقال بأنّ هذين المعنيين طريقان للعدالة ، والمقصود أنّ ما يترتّب عليه الأثر من الأحكام المترتّبة على العدالة هو هذا المعنى ، الذي يكون كاشفاً عن العدالة شرعاً .
والدليل عليه ـ مضافاً إلى ما ذكرناه ـ : أنّ الشيخ(قدس سره) في الخلاف بعد ما تمسّك لمذهبه في قِبال الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ; وهو عدم وجوب البحث عن
(1) جواهر الكلام : 13 / 290 ، رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري : 8 .
(الصفحة 307)
الشاهد الذي عرف إسلامه ولم يعرف جرحه ، بإجماع الفرقة وأخبارهم ، قال : وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة ، والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل . وأيضاً نحن نعلم أ نّه ما كان البحث في أيّام النبي(صلى الله عليه وآله) ولا أيّام الصحابة ولا أيّام التابعين ، وإنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبدالله القاضي الخ(1) . فإنّ تمسّكه بالأصل ، وكذا بعدم ثبوت البحث في تلك الأيّام المختلفة المتعاقبة ، ظاهر في أ نّه ليس مراده من ذلك تفسير حقيقة العدالة وبيان معناها ، بل المراد بيان ما يكفي في حكم الحاكم بشهادة الشاهدين ، وأنّ الملاك في ذلك مجرّد معروفيّة إسلامهما وعدم معروفيّة جرحهما ، كما لا يخفى .
فانقدح من جميع ذلك أنّ العدالة لا يكاد يكون لها إلاّ معنى واحد وحقيقة فاردة ; وهي المشتملة على الملكة والحالة النفسانيّة التي هي من المراتب التالية للعصمة . غاية الأمر أنّ العصمة عبارة عن الملكة التي تحصل للنفوس الشريفة ويمتنع معها صدور المعصية عادة . وأمّا ملكة العدالة ، فلا يمتنع معها صدورها كذلك ، ولكن يتعسّر ويصعب .
ثمّ إن بعض الأعلام ذكر في شرحه على العروة كلاماً في معنى العدالة محصّله : أنّه لم تثبت للعدالة حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة ، وإنّما هي بمعناها اللغوي ; أعني الاستقامة وعدم الجور والانحراف ، وهي قد تستند إلى الأُمور المحسوسة ، فيقال : هذا الجدار عدل . وقد تستند إلى الأُمور غير المحسوسة ، فيُراد منها الاستقامة المعنويّة ، فيقال : عقيدة فلان مستقيمة . وقد تستند إلى الذوات ، فيقال : زيد عادل ، وهذا هو المراد من العدالة المطلقة ، ومعناها حينئذ هي الاستقامة العمليّة
(1) الخلاف : 6 / 218 مسألة 10 .
(الصفحة 308)
التي هي صفة خارجيّة وليست من الأوصاف النفسانيّة .
ثمّ قال في توضيحه ما ملخّصه : إنّ ترك المحرّمات والإتيان بالواجبات قد
يستند إلى عدم المقتضي لفعل الحرام أو ترك الواجب ، كما إذا لم تكن له قوّة شهويّة أو غضبيّة. وهذا مجرّد فرض لا وقوع له، أو لو كان متحقّقاً فهو من الندرة بمكان.
وكيف كان ، فعلى تقدير تحقّقه لا يكفي ذلك في تحقّق العدالة بوجه ; لأنّ المكلّف وإن لم ينحرف حينئذ عن جادّة الشرع، إلاّ أ نّه لم يسلك جادّته برادع عن المحرّمات، وإنّما سلكها لا عن مقتض لارتكابها، وهو في الحقيقة خارج عن موضوع العدالة والفسق.
وقد يكون ترك المحرّمات وفعل الواجبات مستنداً إلى الرادع عن المعصية مع وجود المقتضي لارتكابها ، وهذ الرادع قد يكون تسلّط القوّة العاقلة على العقل العملي ; بمعنى أنّ العقل قد يكون مسيطراً على النفس سيطرة تامّة ، فيلاحظ الأعمال التي يريد المكلّف إصدارها ، فيصدر ما هو محبوب منها لله سبحانه ، كما حكي ذلك عن السيّد الرضي(قدس سره) ، وأنّه لم يرتكب مباحاً طيلة حياته فضلا عن الحرام والمكروه ، ومن الواضح أنّ العدالة المعتبرة في الموارد الكثيرة لا يكاد يكون المراد بها هذا المعنى الذي هو تلو مرتبة العصمة .
وقد يكون الرادع عن ارتكاب المعصية مع وجود المقتضي لها رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، كما لعلّه الغالب في آحاد المكلّفين ، وهذا المعنى من العدالة هو المراد منها في موضوع جملة من الأحكام الشرعيّة .
ثمّ إنّ الرادع عن ارتكاب المحرّم إذا لم يكن هو الخوف أو الرجاء ، فلا يخلو إمّا أن يكون أمراً محرّماً في نفسه كالرياء ، ومن البديهي أنّ ذلك لا يكون من العدالة في
(الصفحة 309)
شيء ، بل هو محكوم بالفسق ، وإمّا أن يكون أمراً مباحاً ، كما إذا كان الرادع الشرافة والجاه والخوف عن السقوط عن أعين الناس ، وفي هذه الصورة يكون المكلّف خارجاً عن عنواني العادل والفاسق معاً .
فانقدح أنّ العدالة هي الاستقامة العمليّة في جادّة الشرع بداعي الخوف من الله أو رجاء الثواب ; وهي صفة عمليّة وليست من الأوصاف النفسانيّة ، لكنّه يعتبر أن تكون هذه الاستقامة مستمرّة بحيث تصير كالطبيعة الثانويّة للمكلّف ، فالاستقامة في حين دون حين كما في شهر رمضان ، أو مكان دون مكان ، كما في المساجد والمشاهد ، لا تكون عدالة أصلا . نعم ، لا يضرّ بها ارتكاب المعصية في بعض الأحيان ـ لغلبة الشهوة أو الغضب ـ فيما إذا ندم بعد الارتكاب(1) .
ويرد عليه ـ بعد وضوح أ نّه ليس المراد بالاستقامة هي الاستقامة فيما مضى فقط أو بضميمة الحال ، بل الاستقامة الدائميّة المطلقة الحاصلة بترك المحرّم والإتيان بالواجب في الاستقبال أيضاً ـ : أنّ هذا النحو من الاستقامة الناشئة عن الخوف أو الرجاء لا تكاد تنفك عن الملكة ; فإنّ القائل باعتبار الملكة في العدالة لا يريد بها إلاّ الحالة التي إذا اطّلع الغير عليها يطمئنّ بعدم صدور المعصية من صاحبها ، إلاّ أن يحاط به ويغلب عليه الشهوة أو الغضب على خلاف العادة .
ومن المعلوم أنّ تحقّق الخوف الدائمي والرجاء كذلك لا ينفك عن هذه الحالة والكيفيّة ، بل لا مغايرة بين الأمرين ; فإنّ الحالة الكذائيّة ليست إلاّ حالة الخوف المرتكزة في النفس الحاصلة بعد تحقّق مبادئها ، التي هي عبارة عن الاعتقاد بالوحدانيّة وبالرسالة وبغيرهما من الأُمور الاعتقاديّة ، وبما يترتّب على مخالفة
(1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 254 ـ 258 .
(الصفحة 310)
التكليف من التبعة ، فالتحقيق أنّ هذا يرجع إلى النزاع اللفظي ، ولا نزاع معنويّاً في البين كما هو ظاهر .
نعم ، لابدّ من ملاحظة ما استدلّ به على اعتبار الملكة في العدالة ، وهي اُمور مذكورة في كلام الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) على ما في رسالة العدالة(1) :
الأوّل : الأصل ، والظاهر أنّ المراد به أصالة عدم ترتّب الآثار المرغوبة من العدالة والمطلوبة منها على مجرّد الاجتناب العملي ، الذي لم يكن ناشئاً عن الملكة النفسانية ، وأشار إلى ضعف هذا الدليل بأمره بالتأمّل ، ولعلّ الوجه فيه : أنّه ليس الشكّ في حصول مفهوم مبيّن وتحقّقه في الخارج ، بل الشكّ في أصل المفهوم والمعنى ، وإجراء الأصل لا يثبت كون المفهوم معتبراً فيه الملكة إلاّ على القول بالأُصول المثبتة ، وهو خلاف التحقيق .
الثاني : الاتّفاق المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة ، بل عدم الخلاف ، وهذا الدليل وإن كان يساعده ما ذكرناه من رجوع الأقوال المختلفة إلى قول واحد ، إلاّ أنّ بلوغه إلى مرحلة الاتّفاق غير ثابت ، والاتّفاق المنقول لا يكون واجداً لوصف الحجيّة على ما قرّر في الأُصول(2) .
الثالث : ما دلّ على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة وورعه ; فإنّ الوثوق لايحصل بمجرّد تركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره ما لم يعلم أو يظنّ فيه ملكة الترك .
وأُورد عليه بالمنع عن عدم حصول الوثوق بدين من نرى أ نّه يأتي بواجباته
(1) رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري : 11 .
(2) فرائد الاُصول : 1 / 125 وما بعدها ، سيرى كامل در اُصول فقه: 1 / 291 وما بعدها .
(الصفحة 311)
ويترك المحرّمات مع عدم إحراز الملكة فيه ; لأنّا إذا عاشرنا زيداً مثلا مدّة ، ورأينا أ نّه يخاف حيواناً من الحيوانات الموذية مثلا يحصل لنا الوثوق بذلك في حقّه ، وكذلك الحال في المقام ، فإنّا إذا عاشرناه مدّة ، ورأينا أ نّه يخاف الله سبحانه ،
ولا يرتكب محرّماً ، ولا يُخِلّ بواجب ، يحصل لنا الوثوق بديانته ، ولو لم تكن الملكة موجودة فيه (1).
والجواب عن ذلك ما ذكرنا من أنّ حصول الوثوق بتحقّق الخوف الدائمي ،
أو الرجاء كذلك فيه الموجب لعدم الإخلال بالواجب ، وعدم الإتيان بالمحرّم عبارة اُخرى عن حصول الوثوق بالملكة والحالة النفسانيّة ; ضرورة عدم كون مراد القائل باعتبار الملكة أزيد من ذلك .
الرابع : ما ورد في الشاهد ممّا يدلّ على اعتبار المأمونيّة والعفّة والصيانة والصلاح وغيرها فيه(2) ، مع الإجماع على عدم اعتبارها زائداً على العدالة ، ووضوح كونها من الصفات النفسانيّة .
وأُورد عليه بأنّ العناوين المذكورة غير منطبقة على الأفعال النفسانيّة ، فضلا عن أن تنطبق على الصفات النفسانيّة ، وتفصيل ذلك : أنّ كون الرجل مرضيّاً بمعنى أن يكون أفعاله ممّا يرضى به الناس ، فهي من صفات الأعمال الخارجيّة ، وليس من الصفات النفسانيّة .
نعم ، الرضا صفة نفسانيّة ، إلاّ أ نّه صفة قائمة بالغير ; لأنّ العادل هو المرضي ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، وكذا كونه صالحاً معناه أن لا يكون فاسد العمل ،
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 261 .
(2) وسائل الشيعة: 27 / 391، كتاب الشهادات ب 41 .
(الصفحة 312)
وكذا كونه مأموناً ; فإنّ الأمن وإن كان بمعنى اطمئنان النفس وسكونها في
مقابل اضطرابها وتشويشها ، إلاّ أ نّه أمرٌ قائم بالغير دون المتّصف بالعدالة ، والخيّر
هو الذي كانت أعماله خيراً ،والصائن من ترك المعاصي مع وجود المقتضي
لارتكابها .
والستر بمعنى التغطئة ، وكون المكلّف ساتراً إمّا بمعنى أ نّه ساتر لعيوبه عن الله سبحانه ، فهو بهذا المعنى عبارة اُخرى عن اجتنابه المعاصي ، وإمّا بمعنى كونه مستوراً لدى الناس ; بمعنى أ نّه لايتجاسر بالمعاصي ولايتجاهر بها ، فهذا أيضاً ليس من الصفات النفسانية .
والعفّة بمعنى الامتناع عمّا لا يحلّ ، والامتناع هو من عناوين الأفعال الخارجيّة ، فهذه الصفات والعناوين لا تكاد تنطبق على الصفات النفسانيّة بوجه (1).
والجواب عن هذا الإيراد يظهر ممّا ذكرنا من أنّ هذه العناوين لا يكاد يراد بها إلاّ تحقّقها في جميع الحالات والأزمنة الثلاثة ، لا خصوص الماضي والحال ، ومن المعلوم أنّ إحرازها كذلك لا يكاد ينفكّ عن تحقّق الملكة ، خصوصاً بعد اعتبار كون الاجتناب ناشئاً عن الخوف النفساني والرجاء كذلك ; فإنّ إحراز الخوف الدائمي عبارة اُخرى عن إحراز الملكة المانعة عن ارتكاب المحرّم والباعثة على الإتيان بالواجب .
هذا ، مع ما سيأتي(2) من أنّ بعض هذه العناوين قد فسّر في اللغة بما لا ينطبق إلاّ
على الصفة النفسانيّة ، كالستر والعفاف وأشباههما .
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 262 ـ 263 .
(2) يأتي في ص318 .
(الصفحة 313)
حول صحيحة عبدالله بن أبي يعفور]
الخامس : ـ وهو العمدة في الباب ـ صحيحة عبدالله بن أبي يعفور التي رواها الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب .
أمّا الأوّل : فقد رواها باسناده عنه قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : بم تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تُقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك ; من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين .
وأن لايتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة، فإذاكان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه ; فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ; وذلك أنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأ نّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة المسلمين.
وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، ولو لا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ; لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ; فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلّي
(الصفحة 314)
في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله ـ عزّ وجلّ ـ ومن رسوله(صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار ،
وقد كان يقول : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة(1) .
وأمّا الثاني : فقد رواه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور نحوه ، إلاّ أ نّه أسقط ـ على ما حكاه في كتاب الوسائل ـ قوله : فإذا كان كذلك لازماً لمصلاّه ـ إلى قوله :ـ ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، وأسقط قوله : فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) همّ بأن يحرق ـ إلى قوله :ـ بين المسلمين ، وزاد : وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ، ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين ، وإلاّ أُحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته بينهم(2) .
والكلام في هذه الرواية الشريفة يقع في أمرين :
الأمر الأوّل : سندها ، وقد حكي عن العلاّمة الطباطبائي(قدس سره) أ نّه حكم بصحّة هذه الرواية ، حيث قال ـ في محكي ما صنّفه في مناسك الحج ـ : الصحيح عندنا في الكبائر أنّها المعاصي التي أوجب الله تعالى سبحانه عليها النار ، وقد ورد تفسيرها بذلك في كثير من الأخبار المرويّة عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ;
(1) الفقيه : 3 / 24 ح65 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 391 ، كتاب الشهادات ب41 ح1 .
(2) تهذيب الأحكام: 6 / 241 ح596 ، الاستبصار : 3 / 12 ح33 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 392 ، كتاب الشهادات ب41 ح2 .
(الصفحة 315)
نحو صحيحة عبدالله بن أبي يعفور الواردة في صفة العدل الخ(1) . لكن في مفتاح الكرامة بعد نقل هذه العبارة قال : الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب
ولا في الفقيه(2) .
والظاهر أنّ منشأ الإشكال في التهذيب هو اشتمال السند على محمد بن موسى الهمداني ، وفي الفقيه اشتماله على أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، حيث لم يقع عنه ذكر في الكتب المصنّفة في الرجال حتى يعدل أو يجرح ، مع أنّ التحقيق كما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي(قدس سره) يقضي بعدم الاحتياج إليه(3) .
توضيح ذلك : أنّ الكتب الموضوعة في هذا الباب لا تتجاوز عن عدّة كتب ، ككتاب رجال الشيخ ، ورجال الكشي ، وفهرستي النجاشي والشيخ ، وعدم التعرّض في هذه الكتب لبعض الرواة لا يوجب عدم الاعتناء بروايته ; لأنّ كتاب رجال الشيخ لا يكون مشتملا على جميع الرواة ; لأنّ الظاهر أ نّه كان بصورة المسودّة ، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانياً لنظمه وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين ممّن لم يتعرّض لبيان حاله ، كما يشهد لذلك الاقتصار في بعض الرواة على ذكر مجرّد اسمه واسم أبيه ، من دون تعرّض لبيان حاله من حيث الوثاقة وغيرها ، وكذا ذكر بعض الرواة مكرّراً ، كما يتّفق فيه كثيراً مع عدم التعرّض لذكر بعض آخر .
فهذا وأمثاله ممّا يوجب الظنّ الغالب بكون الكتاب لم يبلغ إلى حدّ النظم والترتيب والخروج بصورة الكتاب ، وذلك كان مستنداً إلى كثرة اشتغال الشيخ(قدس سره)
(1) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 3 / 91 .
(2) مفتاح الكرامة : 3 / 91 .
(3) نهاية التقرير : 3 / 230 ـ 232 .
(الصفحة 316)
بالتأليف والتصنيف في الفنون المختلفة الإسلاميّة من الفقه والأُصول ، وجمع الأحاديث والتفسير والكلام والرجال وغير ذلك من العلوم ، بحيث لو قسّمت مدّة حياته على تأليفاته لا يقع في مقابل كتابه هذا إلاّ ساعات معيّنة معدودة .
وأمّا رجال الكشي ، فالظاهر ـ كما يظهر لمن راجع إليه ـ أ نّه كان غرضه منه جمع الأشخاص الذين ورد في حقّهم الرواية مدحاً أو قدحاً أو غيرهما .
وأمّا الفهرستان ، فالغرض منهما إيراد المصنّفين ومن برز منه تأليف أو تصنيف ، فعدم التعرّض لبعض الرواة فيهما لأجل عدم كونه مصنّفاً ، لا دلالة فيه على عدم وثاقته .
فانقدح أنّ عدم التعرّض في هذه الكتب الأربعة لا يدلّنا على عدم الوثاقة ، بل يمكن استكشاف وثاقة الراوي من طرق أُخَر ، منها : تلاميذه الذين أخذوا عنه الحديث ، فإذا كان الآخذ مثل الشيخ أو الصدوق أو المفيد ، أو غيرهم من الأعلام ، خصوصاً مع كثرة الرواية عنه ، لا يبقى ارتياب في وثاقته أصلاً ، ولأجل ذلك يحكم في المقام بوثاقة أحمد بن محمّد بن يحيى ; لرواية مثل الصدوق والشيخ عنه ، خصوصاً مع كثرة رواياته ، حيث إ نّه كان راوية كتب أبيه بإجازة منه ، فالإنصاف أ نّه لا مجال للمناقشة في مثل هذا السند ، وأنّ ما أفاده العلاّمة الطباطبائي من الحكم بصحّة هذه الرواية في كمال الصحّة ، فافهم واغتنم .
الأمر الثاني : دلالتها ، ونقول : الظاهر أنّ السؤال فيها إنّما هو عن حقيقة العدالة وما هو المراد منها في لسان الشارع ، وإن كان ظاهر عبارته يعطي أنّ السؤال إنّما هو عن الأمارة المعرّفة لها بعد العلم بحقيقتها ، وأنّها هي الملكة النفسانيّة الكذائيّة ، نظراً إلى أ نّها لو لم تكن من الصفات النفسانيّة لما احتاجت إلى الأمارة الكاشفة ، فالسؤال عنها دليل على كونها عبارة عن الملكة .
(الصفحة 317)
وذلك ـ أي وجه كون السؤال عن حقيقة العدالة ـ أنّ لفظ «العدالة» وكذا «الفسق» وإن كان مستعملا كثيراً في صدر الإسلام ، وفي عصر نزول القرآن بل قبله ، وقد ورد في الكتاب العزيز موارد كثيرة استعملت فيها هذه اللفظة ، وكذا مضادّها ، إلاّ أ نّه حيث كانت حقيقتها وما يراد من مفهومها في الاستعمالات الشرعيّة مورداً لاختلاف المراجع في الفتوى للمسلمين في ذلك الزمان ;
كأبي حنيفة وغيره ، حيث إنّ المحكي عن الأوّل كما عرفت (1) أ نّه فسّرها بمجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، وعن غيره تفسيرها بالاجتناب عن جميع الأُمور الّتي تعلّق النهي بها تحريماً أو تنزيهاً ، وارتكاب الطاعات كذلك واجبة
أو مستحبّة ، أراد السائل ـ وهو ابن أبي يعفور ـ الاستفهام عمّا هو المراد منها عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين .
وليس مرادنا من ذلك أنّ سؤاله إنّما هو عن المعرّف المنطقي حتى يكون قوله : «بم تعرف» بصيغة المجهول من باب التفعيل ، حتى يورد عليه ـ مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر العبارة ، خصوصاً بقرينة قوله(عليه السلام) في الجواب : «أن تعرفوه» ـ بأنّ المعرّف المنطقي إصطلاح خاصّ بين المنطقيين حدث بعد صدور الرواية (2)، بل مرادنا أنّ سؤاله إنّما هو عن مجرّد ما أُريد من العدالة في لسان الأئمّة(عليهم السلام) في قبال مثل أبي حنيفة .
ولا ينافي ما ذكرنا من كون المراد من السؤال ذلك ، قوله(عليه السلام) في الجواب :
«أن تعرفوه بالستر والعفاف» ، نظراً إلى أنّ المعرفة طريق للعدالة لا نفسها ،
(1) في ص305 .
(2) المورد هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 264 ـ 265 .
(الصفحة 318)
وذلك لأنّ المعرفة المأخوذة في الجواب إنّما اُخذت آلة لتعريف العدالة وإفادة حقيقتها ، مع أنّ هذا الإشكال مشترك الورود ; ضرورة أ نّه لو كان المراد السؤال عن طريق معرفة العدالة لا نفسها لم يكن الطريق المذكور في الجواب إلاّ الستر والعفاف لا المعروفيّة بهما ، فتدبّر .
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الأمارة هي نفس المعرفة والمعروفيّة ، والستر والعفاف وكفّ البطن إلخ عبارة اُخرى عن حقيقة العدالة وماهيّتها في لسان الشارع ، وعليه : فيرجع إلى ما ذكرنا ، كما لا يخفى .
وأمّا الجواب ، فقوله(عليه السلام) : «أن تعرفوه بالستر والعفاف إلخ» معناه أن يكون الرجل معروفاً عند المسلمين ، بحيث يعرفونه أو تعرفونه أنتم بالستر الذي هو الحياء ، وبالعفاف الذي هو الحياء أيضاً .
قال في لسان العرب : السِتر ـ بالكسرـ : الحياء ، والحِجر العقل(1) . وقال في لغة عفّ : العِفّة : الكفّ عمّا لا يحلّ ويَجمُلُ ، عفّ عن المحارم والأطماع الدنيّة يعفّ عِفَّة وعَفّاً وعَفافاً وعَفافة ـ بفتح العين ـ فهو عَفيف ، وعفَّ أي كفَّ وتعفَّفَ(2) .
وبالجملة : أن يكون الرجل معروفاً بالكفّ عمّا لا يجمل له بالحياء المانع عن ارتكابه ، وأن يكون معروفاً بكفّ البطن والفرج واليد واللسان عمّا لا يليق بها
ولا يجمل لها ، ومنشأ هذا الكفّ هو الستر والحياء ; لأ نّه معه يتعسّر من الشخص صدور ما لا ينبغي أن يصدر من مثله بحسب المتعارف . فهذه الجملة تدلّ على اعتبار المروءة في العدالة ، كما هو المشهور بين المتأخّرين (3); لأنّها ليست إلاّ عبارة
(1) لسان العرب : 3 / 243 .
(2) لسان العرب : 4 / 376 .
(3) رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري : 17 .
(الصفحة 319)
عن ترك ما لا يليق بحال الشخص عادة ، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى(1) .
وقوله(عليه السلام) : «ويُعْرَف» الظاهر أ نّه منصوب معطوف على قوله(عليه السلام) : «أن تعرفوه» المنصوب بكلمة «أن» الناصبة ، كما أنّ الظاهر أ نّه بصيغة المذكّر ، كما في الوسائل وغيرها ، والضمير فيه يرجع إلى الرجل الذي يراد معرفة عدالته ، ومعناه حينئذ
أن يكون الرجل معروفاً أيضاً باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار ; من شرب الخمر ، والزنا ، والربا الخ .
وعليه : تكون كلّ واحدة من الجملتين بعض المعرِّف للعدالة ; لأنّ الجملة الأُولى تدلّ على اعتبار المروءة ، والثانية على اعتبار الاجتناب عن الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، وليست الجملة الأُولى تمامَ المعرِّف للعدالة ; والثانية دليلا على المعرِّف ; لأ نّه ـ مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر العبارة التي هي بصيغة المذكّر كما عرفت ، وإلى أ نّه لا يبقى فرق حينئذ بين المعرِّف والدليل عليه أصلا ـ يلزم
أن لا يكون الدليل دليلا على تمام المعرِّف ; لأ نّه حينئذ لابدّ من حمل المعرِّف على الأعمّ من الأعمال غير اللائقة بحاله عرفاً ، بحيث يشمل غير الجائزة شرعاً أيضاً ، مع أنّ الدليل والطريق ينحصر بخصوص الثانية .
ودعوى أنّ العطف على الجملة الأُولى يلزم منه الاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه ; من جهة أنّ المعطوف عليه هو معرفة المسلمين للرجل ، والمعطوف هو معروفيّة الرجل عندهم .
مدفوعة بأ نّه لا مانع من ذلك ، بل وقع نظيره في الكتاب العزيز في قوله تعالى : {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
(1) في ص363 ـ 365 .
(الصفحة 320)
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِى}(1) . حيث نسب الخوف أوّلا إلى الزوجين ثمّ إلى أهلهما ، وليس ذلك إلاّ لأجل كون مجرّد المعرضيّة كافياً في النسبة ، كما لا يخفى .
وبالجملة : فالظاهر أنّ هذه الجملة جزء أخير من معرّف العدالة ، ومعطوفة على الجملة الأُولى ، وهو مطابق لِما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي(قدس سره) على ما قرّرته في كتاب «نهاية التقرير»(2) الذي يشتمل على تقريراته في جلّ مباحث الصلاة ، وقد طبع في ثلاثة أجزاء .
ولكن فيه شيء ; وهو أنّ ذكر المروءة أوّلا في تفسير العدالة ، وبيان حقيقتها قبل ما هو بمنزلة الركن في معناها ـ وهو اجتناب الكبائر بالوصف المذكور فيها ـ ربما لا يلائم مقام التعريف وبيان المعنى، خصوصاًمع ذكر عبارات مختلفة وجهات متنوّعة.
فالأولى أن يقال : إنّ الجملة الأُولى تدلّ على اعتبار كلا الأمرين من المروءة واجتناب الكبيرة ، والجملة الثانية تخصيص بعد التعميم ، وامتيازها إنّما هو من جهة كونها الركن في معناها ، وبها قوام العدالة ، ويؤيّده ـ مضافاً إلى ما ذكرنا ـ تفسير العفّة في اللغة كما عرفت بالكفّ عمّا لا يحلّ ويَجمُلُ ، حيث جمع بين الاجتناب عن غير الجميل والاجتناب عن غير الحلال ، وبناءً على ذلك يكون اعتبار الملكة في العدالة ، ودلالة الرواية عليه واضحاً ; لما عرفت من أنّ الستر والعفاف من الأوصاف النفسية .
وأمّا كفّ البطن والفرج إلخ ، فهو أيضاً يرجع إلى حالة نفسانيّة ; لأ نّه ـ مضافاً إلى
(1) سورة البقرة : 2 / 229 .
(2) نهاية التقرير : 3 / 237 .
|