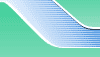الصفحة 241
فبارتفاع أحد طرفيها يستكشف ارتفاع الطرف الآخر أيضاً كما لا يخفى على من تتبّع طريقتهم، بل يمكن أن يقال: إنّ السؤال عن تنجّس الثوب كناية عن السؤال عن نجاسة الماء بمعنى انّ السؤال عن نجاسة الماء تارة يكون بنحو الحقيقة واُخرى بنحو الكناية وذكر اللاّزم وإرادة الملزوم فالسؤال في الحقيقة إنّما هو عن نجاسة الماء كما لا يخفى.
ولهذه الملازمة تخصّص قاعدة «النجس منجّس» حيث إنّ البناء على الطهارة يستلزم أن لا يكون البول أو الغائط مؤثِّراً في تنجّس الماء الملاقي معه.
إن قلت : إنّ البناء على الطهارة ـ كما هو المفروض ـ يستلزم تخصيص عموم أدلّة انفعال الماء القليل وعدم اعتصامه أيضاً.
قلت : إنّ هذه القاعدة ليست قاعدة مستقلّة في مقابل قاعدة «النجس منجّس» بل هي من افراد تلك القاعدة ومصاديقها فلا تكون هنا قاعدتان مستقلّتان حتّى يكون الحكم بطهارة ماء الاستنجاء تخصيصاً بالإضافة إلى كلتيهما كما هو واضح.
ثمّ إنّ الشيخ(قدس سره) في كتاب الطهارة ذكر ـ أوّلاً ـ انّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة إنّما هي طهارة الماء فيتعيّن تخصيص ما دلّ على انفعال الماء القليل وهو أولى من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدّي نجاسة كلّ متنجّس، ثمّ ذكر انّ التحقيق انّ القاعدة الثانية ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردّد بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن عمومها فتبقى أدلّة تنجّس الماء القليل وأدلّة عدم البأس بماء الاستنجاء على حالهما من عدم التعارض لأنّ التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء فالقول بأنّه نجس لا ينجّس ملاقيه قوي لا محيص عنه.
ثمّ قال: «ويمكن أن يقال: إنّ الأخبار المذكورة معارضة بأنفسها لأدلّة تنجّس القليل فتخصّصها لأنّ النجاسة ـ في الشرع ـ امّا وجوب الاجتناب عن الشيء في
الصفحة 242
الصلاة والأكل وما ألحق بهما، أو صفة منتزعة عن هذه الأحكام فإذا حكم الشارع بأنّه لا بأس بالثوب الواقع في ماء الاستنجاء فهو كالصريح بجواز الصلاة والطواف فيه وإذا لم ينجّس الطعام المطبوخ جاز أكله، فإذا لم يجب الاجتناب عنه في الصلاة ولا في الأكل لم يكن نجساً، وامّا سائر الأحكام كحرمة شربه وإدخاله المسجد ونحوهما فإنّما جاء من أدلّة وجوب الاجتناب عن النجس والمفروض عدمه».
واستشكل عليه في مستمسك العروة حيث قال: «ووجه الإشكال فيه:
أوّلاً: ما أشرنا إليه من أنّ تخصيص عموم الانفعال ليس لتقديم قاعدة نجاسة ملاقي النجس عليه، بل للدلالة الالتزامية العرفية.
وثانياً: انّ عموم انفعال الماء القليل في رتبة قاعدة نجاسة ملاقي النجس فإذا فرض معارضة أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء مع أصالة العموم فيها بالنسبة إلى ماء الاستنجاء فهذه المعارضة بعينها حاصلة بين اصالة العموم في القاعدة في الأوّل وأصالة العموم في عموم انفعال الماء القليل في الثاني، فالعلم الإجمالي يوجب سقوط العمومين معاً.
وثالثاً: انّ المعارضة بين أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى الفردين غير ظاهرة لسقوط أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء جزماً للعلم الإجمالي بالتخصيص أو التخصّص فتبقى أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ماء الاستنجاء الملاقي للبول والغائط بلا معارض، وكذا عموم انفعال الماء القليل بل لو فرض ملاقاة ماء الاستنجاء لماء آخر فلا معارضة في عموم انفعال الماء القليل بالنسبة إلى تطبيقه لأنّ تطبيقه بالنسبة إلى الماء الثاني معلوم البطلان امّا للتخصيص أو للتخصّص على نحو ما عرفت في عموم نجاسة ملاقي النجس».
أقول: لا يخفى انّ ما استشكل عليه أوّلاً هو بعينه ما أفاده الشيخ(قدس سره) في ذيل
الصفحة 243
كلامه من قوله: «ويمكن أن يقال...».
وامّا الإشكال الثاني فهو ككلام الشيخ مبني على أن تكون هنا قاعدتان مستقلّان وقد عرفت بطلانه وانّه لا يكون في البين إلاّ قاعدة تأثير النجس في نجاسة ملاقيه ـ ماءً كان أو غيره ـ وهي القاعدة المستفادة من الموارد الجزئية التي منها انفعال الماء القليل بالملاقاة، وقد عرفت انّ الظاهر تخصيصها بالنسبة إلى نفس ماء الاستنجاء لأنّ المستفاد من الأخبار طهارته وعدم نجاسته بوجه.
وامّا الاشكال الثالث فيدفعه ثبوت المعارضة وعدم انحلال العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي بعدم تأثير ماء الاستنجاء في تنجّس ملاقيه امّا لطهارته أو للعفوّ عنه، وذلك لأنّه يستحيل أن يؤثّر العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي في رفعه وهل هو إلاّ كتأثير المعلول في رفع علّته ومن الواضح استحالته.
توضيحه انّ منشأ العلم التفصيلي في المقام العلم ـ إجمالاً ـ بتخصيص القاعدة امّا بالنسبة إلى نفس ماء الاستنجاء الملاقي للبول أو الغائط، وامّا بالإضافة إلى ملاقيه من الثوب أو غيره فلا يعقل أن يؤثّر في انحلاله إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي بالإضافة إلى ماء الاستنجاء حتّى تبقى فيه اصالة العموم بلا معارض فيحكم بنجاسته الملازمة لثبوت التخصيص بالنسبة إلى الملاقي.
وهذا نظير ما لو علم ـ إجمالاً ـ بوجوب الوضوء مثلاً وتردّد بين أن يكون الوجوب نفسياً أو غيريّاً ناشئاً من وجوب الصلاة ونظائرها فإنّه لا مجال لما قيل من انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الوضوء والشكّ البدوي في وجوب الصلاة ـ مثلاً ـ فتجري فيه البراءة، وذلك لأنّ جريان البراءة في وجوبها مستلزم لعدم وجوب مقدّماته التي منها الوضوء فلا يجب ـ حينئذ ـ فكيف يعلم تفصيلاً بوجوبه، فالعلم التفصيلي يتوقّف على بقاء العلم الإجمالي لأنّه مقوم له كما
الصفحة 244
هو واضح.
والمقام من هذا القبيل فإنّ العلم التفصيلي بطهارة الملاقى ليس متولّداً إلاّ من العلم الإجمالي بالتخصيص أو التخصّص فكيف يمكن أن يؤثّر في نفي أحد طرفيه، وما اشتهر من انحلال العلم الإجمالي ـ في بعض الموارد ـ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي فالمراد صورة توهّم العلم الإجمالي، وإلاّ فكيف يمكن أن يؤثّر ما يتولّد من الشيء في رفعه فافهم واغتنم.
ثمّ إنّ بعض الأعلام ـ في شرح العروة ـ حيث لم يستفد من الروايات الواردة في ماء الاستنجاء طهارته زاعماً انّ الأخبار الواردة في الباب كلّها ساكتة عن إفادة طهارة الماء وغاية مدلولها طهارة ملاقيه فحسب اختار نجاسته نظراً إلى أنّه لا مناص من التمسّك بعموم أدلّة انفعال الماء القليل ثمّ قال ما ملخّصه: «إنّه لا مجال للتمسّك بعموم ما دلّ على منجّسية النجس والمتنجّس كي تثبت بأصالة عدم تخصيصه طهارة ماء الاستنجاء ويستكشف بذلك انّ خروجه عن ذلك العموم تخصّصي لا تخصيصي، والوجه في عدم إمكانه انّ التمسّك بالعموم إنّما يسوغ فيما إذا شكّ في حكم فرد بعد إحراز فرديته والعلم بدخوله في موضوع العموم كما إذا شككنا في وجوب إكرام زيد العالم، وامّا إذا انعكس الحال وعلمنا بالحكم في مورد وشككنا في وجوب إكرام زيد العالم كما إذا علمنا بحرمة إكرام زيد وتردّدنا في أنّه عالم أو جاهل فلم يثبت بناء العقلاء على التمسّك بأصالة العموم لإثبات انّه ليس بعالم والمقام من هذا القبيل لأنّا نعلم بعدم منجّسية ماء الاستنجاء بمقتضى الأخبار المتقدّمة ونشكّ في أنّه من افراد الماء المتنجّس ليكون عدم منجّسيته تخصيصاً للعموم أو انّه طاهر حتى يكون الخروج تخصّصاً فلا يمكن التمسّك بأصالة العموم لإثبات طهارة ماء الاستنجاء، بل لا مناص من الرجوع إلى عموم أدلّة الانفعال
الصفحة 245
والالتزام بتخصيص ذلك العموم في خصوص ماء الاستنجاء، وعليه يتعيّن مذهب الشهيد(قدس سره)من نجاسة ماء الاستنجاء وثبوت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه للروايات».
ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما عرفت من دلالة روايات الباب على طهارة نفس ماء الاستنجاء بحيث لا مجال للخدشة فيها أصلاً ـ ما مرّت الإشارة إليه من أنّه ليس هنا قاعدتان وعمومان: قاعدة منجّسية كلّ نجس ومتنجّس وعموم أدلّة انفعال الماء القليل، بل ليس هنا إلاّ قاعدة واحدة وهي القاعدة الاُولى، والثانية تكون من مصاديقها وأفرادها لا انّها قاعدة اُخرى، وعليه فنقول: إنّا نقطع بتخصيص عموم هذه القاعدة ـ منجّسية كلّ نجس أو متنجّس ـ ضرورة انّه لو قلنا بطهارة ماء الاستنجاء فقد خصّص العموم المذكور بالإضافة إلى البول والغائط فإنّهما نجسان ولم ينجسا الماء حسب الفرض، ولو قلنا بنجاسة ماء الاستنجاء فقد خصّص العموم المذكور بالنسبة إلى نفس ماء الاستنجاء الملاقي للثوب ـ مثلاً ـ فإنّ الملاقى له طاهر بالاتّفاق، وعليه فالعموم المذكور قد خصّص قطعاً. غاية الأمر انّ مورد التخصيص غير معلوم لأنّه لا يعلم انّ تخصيصه هل هو بالإضافة إلى البول أو الغائط حتّى يكون الماء طاهراً أو بالنسبة إلى ماء الاستنجاء حتّى يكون نجساً غير منجّس ومع هذا العلم يسقط العموم عن الاعتبار في ماء الاستنجاء وليس لنا عموم آخر نرجع إليه فيبقى الماء مشكوك الطهارة والمرجع فيه الأصل والعموم الدالّ على الطهارة كما هو ظاهر.
فانقدح من جميع ما ذكرنا انّ الأقوى هو القول بطهارة ماء الاستنجاء لما ذكرنا من أنّ المتفاهم من الأخبار هي الطهارة وبها تخصّص قاعدة تأثير النجس في نجاسة ملاقيه بالنسبة إلى البول أو الغائط الملاقي مع ماء الاستنجاء لا لما أفاده
الصفحة 246
المحقّق الهمداني (قدس سره) في المصباح مع أنّ تخصيص القاعدة بالنسبة إلى ماء الاستنجاء والقول بطهارته أهون من تخصيصها بالنسبة إلى الملاقي لأنّ التخصيص بالإضافة إلى الثاني مستلزم للتخصيص فيما يدلّ على حرمة أكل النجس وشربه وغير ذلك ممّا يشترط بالطهارة أيضاً.
لأنّه يرد عليه ـ مضافاً إلى منافاة هذا الكلام لما أفاده في ذيل كلامه من أنّ معنى العفو هو عدم وجوب الاجتناب بالنسبة إلى خصوص الملاقي لا عدم حرمة الأكل وغير ذلك من الأحكام المشترطة بالطهارة ـ انّ ترجيح التخصيص الواحد على التخصيص المتعدّد ـ اثنين أو أزيد ـ لا دليل عليه في مورد العلم الإجمالي لسقوط أصالة العموم بالنسبة إلى الجميع بعد العلم الإجمالي بخلافها ورفع اليد عنها بالتخصيص الواحد أو بالأزيد كما لا يخفى.
ثمّ إنّه لا فرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين لا لأنّ لفظ «الاستنجاء» يشملهما فإنّ شموله لغسل البول غير معلوم وكلمات اللغويين كالنصوص مختلفة، بل لأنّه حيث يكون الانفكاك بينهما في غاية الندرة إذ العادة قاضية بندرة انفراد الغائط عن البول وباجتماع غسالتهما في محلّ واحد، فعليه يستفاد من الأخبار إطلاق الحكم وعدم الاختصاص بغسل الغائط والفرق بين غسل البول فيما إذا اجتمع مع الغائط وغسله فيما إذا انفرد عنه خلاف ما هو المتفاهم عند العرف كما يظهر بالمراجعة إليهم.
وكذا لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره، سواء كان غير الطبيعي طبيعياً بالنسبة إلى هذا الشخص مثل أن يكون مخرجه من حين الولادة على غير ما هو المتعارف. أو صار طبيعياً بالنسبة إليه لا من حين الولادة كما لو فرض انّ مخرجه حين الولادة كان كسائر أفراد طبيعة الإنسان إلاّ أنّه لعروض بعض الحالات قد تبدّل إلى موضع آخر بحيث يكون هذا الموضع مخرجاً طبيعياً بالإضافة إليه فعلاً، وذلك لصدق
الصفحة 247
الاستنجاء في جميع الفروض والحكم في الروايات معلّق على نفس طبيعة الاستنجاء، نعم لا يبعد أن يقال بعدم الشمول لما لو تبدّل مخرجه الطبيعي إلى موضع آخر موقتاً لعدم صدق الاستنجاء عليه، كما أنّه لا يشمل من لا يكون له مخرج أصلاً بل يقيء كلّ ما يأكل ويشرب. وبالجملة فالمناط صدق الاستنجاء لأنّ الحكم مترتّب على طبيعته لا على الافراد حتّى يشكّ في الشمول للأفراد غير المتعارفة، ولو شكّ في مورد صدق الاستنجاء فالواجب ترتيب أحكام النجاسة عليه فتدبّر.
ثمّ إنّ المراد بالعفو ـ على القول به ـ هل هو العفو عن خصوص الملاقي بمعنى عدم تأثير ماء الاستنجاء في نجاسة ملاقيه، وامّا سائر الأحكام المترتّبة على النجس كحرمة الأكل والشرب فلا مناص عن ترتّبها عليه، أو انّ المراد هو العفو عن جميع الأحكام اللاّزمة لعدم صدق العفو في غيرها، أو العفو عن جميع الأحكام؟ وجوه بل أقوال.
ولكنّه لا يخفى انّه لو قلنا بالعفو فلا محيص عن أن يكون المراد به هو المعنى الأوّل لوضوح انّه لم يرد في روايات الباب كلمة «العفو» حتّى يقال بعدم صدقه إلاّ في الأحكام اللاّزمة أو بشموله لجميع الأحكام بل الروايات بين ما يدلّ على عدم البأس وبين ما يكون مدلوله عدم التأثير في نجاسة الثوب، ومن الواضح انّ الضمير في قوله(عليه السلام) : «لا بأس به» يرجع إلى الثوب الذي وقع على ماء الاستنجاء أو إلى وقوع الثوب فيه لا إلى نفس الماء فيصير مفاد مجموع الروايات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بعد إلغاء خصوصية الثوبية، وامّا ارتفاع سائر الأحكام الموضوعة على النجس المترتّبة عليه فلا دليل عليه أصلاً.
بقي الكلام في هذا المقام في جواز استعماله في رفع الحدث والخبث وعدمه والأقوال في المسألة ثلاثة:
الصفحة 248
أحدها: عدم جواز استعماله في رفع شيء منهما لكونه محكوماً بالنجاسة، غاية الأمر ثبوت العفو بمعنى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي للروايات الدالّة عليه وهو محكي عن الشهيد وكلّ من قال بالنجاسة.
ثانيها : جواز استعماله في رفع كلّ واحد منهما لكونه طاهراً ولم يقم دليل على المنع من استعماله فيه وقد قوّاه صاحب الحدائق ونسبه إلى المحقّق الأردبيلي(قدس سرهما).
ثالثها: ما اختاره السيّد في العروة من ثبوت الطهارة وجواز استعماله في رفع الخبث دون الحدث للإجماعات المنقولة على أنّ الماء المستعمل في إزالة الخبث لا يرفع الحدث.
أقول : امّا عدم الجواز على القول بالنجاسة فواضح لعدم جواز استعمال الماء المتنجّس في رفع الحدث ولم يقم دليل على العفو بحيث يشمل رفع هذا المنع أيضاً كما عرفت، وامّا على القول بالطهارة فمقتضى القاعدة في بادئ النظر جواز استعماله في رفع كلّ واحد منهما ; لأنّ المفروض ثبوت الطهارة وعدم وجود دليل على المنع عدا الإجماعات المنقولة على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في إزالة الخبث مطلقاً أو خصوص ماء الاستنجاء في رفع الحدث كما هو المحكي عن العلاّمة وبعض المتأخّرين كصاحب الذخيرة، ولكن حيث قد حقّق في محلّه عدم حجّية الإجماعات المنقولة بغير التواتر أوّلاً، واحتمال كون المدرك بعض الروايات الذي سيجيء ثانياً، ووضوح كون أكثر المجمعين قائلين بنجاسة الغسالة ثالثاً، لا يبقى لحجّية هذه الإجماعات مجال.
نعم هنا شيء وهو انّه لا يبعد دعوى انصراف أدلّة الوضوء والغسل المشروعين لحصول النظافة الظاهرية أيضاً مقدّمة لعبادة المعبود والخضوع لديه والتقرّب إليه جلّ شأنه عن الوضوء والغسل بماء الاستنجاء بل تنكر المتشرّعة على القائل
الصفحة 249
بجوازه بحيث يجعلونه كالأحكام المبتدعة، كما أنّه لا يبعد أن يقال بانصراف الأدلّة الواردة في التطهير عن النجاسات عن التطهير بمثل هذا الماء فتدبّر.
وامّا القول الثالث فيمكن الاستدلال له ـ مضافاً إلى الإجماعات المنقولة المذكورة ـ برواية عبدالله بن سنان ـ المتقدّمة في بحث الغسالة ـ المشتملة على قوله(عليه السلام): «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه» بتقريب انّه بعد وضوح كون المراد بالثوب هو الثوب النجس لا خصوصية للثوب، بل المراد مطلق المتنجّس فيشمل محلّ النجو أيضاً، كما أنّه لا خصوصية للوضوء، بل المراد مطلق رافع الحدث ولو كان غسلاً خصوصاً لو كان الضمير في أشباهه راجعاً إلى الوضوء.
أقول: امّا الإجماعات فقد عرفت الجواب عن الاستدلال بها.
وامّا الرواية فـ ـ مضافاً إلى ضعف سندها كما عرفت البحث فيه مفصلاًّ ـ يرد على الاستدلال بها انّ الكلام إنّما هو مع فرض الطهارة ولا دلالة للرواية عليها، ومن المحتمل أن يكون الحكم بعدم الجواز ناشئاً عن نجاسة الغسالة، وعليه فإلغاء الخصوصية من الثوب إنّما هو بالمقدار الذي يكون مشتركاً معه في هذا الحكم أي النجاسة ولا وجه لإلغائه بحيث يشمل محلّ النجو أيضاً مع كون الماء المستعمل في غسله محكوماً بالطهارة كما هو المفروض. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
المقام الثاني: فيما يكون الطهارة أو العفو مشروطاً به جزماً أو احتمالاً وهي اُمور:
الأوّل: أن لا يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والريح بنجاسة المحلّ الذي انفصل عنه الماء ولا ينبغي الإشكال في اعتبار هذا الأمر لإطلاق ما دلّ على نجاسة الماء المتغيّر وعدم المنافاة بينه وبين أدلّة طهارة ماء الاستنجاء لوضوح انّ السؤال في هذه الروايات إنّما هو عن حيثية كونه ملاقياً للنجس بمعنى أنّه هل يكون
الصفحة 250
ماء الاستنجاء كسائر المياه القليلة المنفعلة بمجرّد الملاقاة مع النجاسة أو له خصوصية لا يتأثّر بذلك فمحطّ نظر السائل إنّما هو هذه الحيثية، وعليه فالحكم بالطهارة من هذه الجهة لا ينافي النجاسة في مورد حصول التغيّر فلا منافاة بين أدلّة المقام وبين مثل النبوي: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه» ولا سيّما بعد ملاحظة عدم كون التغيّر أمراً غالبياً في ماء الاستنجاء بل قد يتّفق أحياناً.
ثمّ إنّه لو سلّمنا شمول أدلّة الاستنجاء لصورة التغيّر والحكم بالطهارة فيها أيضاً فلا مجال لادّعاء الانصراف فيها أصلاً لأنّ مورده ما إذا أوجب تقييداً في الدليل حتّى لا يجوز التمسّك بإطلاقه وهو لم يثبت في المقام، وعليه فيقع التعارض بين أدلّة طهارة الاستنجاء الشاملة لفرض التغيّر وبين مثل النبوي الدالّ على نجاسة الماء المتغيّر مطلقاً ويصير الترجيح مع النبوي لضعف شمول أخبار الاستنجاء لهذا الفرض حتّى ادّعى فيها الانصراف كما عرفت، أوّلاً، وعدم وجود ماء متغيّر محكوم بالطهارة ثانياً ; لأنّ جميع المياه المعتصمة أيضاً محكومة بالنجاسة مع التغيّر، وعدم اقتضاء التسهيل ـ الذي يبتني حكم ماء الاستنجاء عليه ـ للحكم بالطهارة فيه أيضاً ثالثاً; لعدم كون التغيّر أمراً غالبياً لو لم نقل بثبوت الغلبة مع الافراد غير المتغيّرة.
هذا ولكنّه أفاد بعض الأعلام في وجه ترجيح أخبار النجاسة طريقاً آخر وهو انّ فيها ما هو عام وهو صحيحة حريز: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء وأشرب... وبما انّ دلالته بالوضع فتتقدّم على إطلاق الطائفة الاُولى لا محالة وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيّره بأوصاف النجس.
وهذا الكلام مخدوش أولاً بأنّ هذه الرواية بمنطوقها تدلّ على بيان حكم الماء
الصفحة 251
غير المتغيّر، والمعارض مع أخبار الاستنجاء هو الأدلّة الواردة في الماء المتغيّر الدالّة على نجاسته. نعم ذيل الرواية وارد في حكم الماء المتغيّر ولكنّه خال عن لفظ العموم.
وثانياً: بأنّ الموضوع في هذه الرواية أيضاً هو لفظة «الماء» وهي مطلقة وكلمة «كلّما» زمانية، والمراد الماء في كلّ زمان. ومن المعلوم انّ مدّعاه هو العموم الافرادي لا الازماني فالرواية لا دلالة لها عليه أصلاً، وعليه فالتحقيق في وجه الترجيح ما ذكرنا.
ثمّ لا يخفى انّ المعارضة بين الدليلين إنّما هو على فرض القول بالطهارة في ماء الاستنجاء، وامّا على تقدير النجاسة وثبوت العفو فلا معارضة أصلاً ولكنّه مع ذلك لا تشمل أدلّة ماء الاستنجاء لصورة التغيّر لما ذكرنا في أوّل البحث فلا تغفل.
ثمّ إنّ المراد بالتغيّر ـ في المقام ـ إنّما هو التغيّر بعد الانفصال عن المحلّ والاجتماع في موضع وحد، وامّا مجرّد تغيّر أوّل جزء منه مع زواله بعد الاجتماع أو قبل الوصول إلى المحلّ الذي يجتمع فيه ماء الاستنجاء فلا يوجب النجاسة أصلاً لندرة فرض ما لو لم يتغيّر شيء من أجزائه بوجه فلو حمل الأخبار على ذلك الفرض يلزم طرحها غالباً.
الأمر الثاني: أن لا تكون فيه أجزاء متميّزة من الغائط، والوجه في اعتباره كما قيل: إنّ المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقى من النجاسة في الموضع شيء يسير ولا يوجد شيء من أجزائها المتمايزة في الماء، وامّا إذا كان الباقي في الموضع كثيراً خارجاً عن العادة على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميّزاً حين الاستنجاء أو بعد الفراغ منه فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء لأنّ الأجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية ودليل طهارة ماء الاستنجاء إنّما يدلّ على أنّ الملاقاة للنجاسة في موضعها
الصفحة 252
لا توجب الانفعال دون ما إذا كانت الملاقاة في غير الموضع.
والظاهر عدم مساعدة الدليل على اعتبار هذا الأمر بعد صدق ماء الاستنجاء وشمول الأخبار وكون الفرد من الأفراد المتعارفة ولاسيما بعد ملاحظة تداول الاجتماع في مكان يبقى فيه الماء وربّما يقع فيه الثوب وغيره لعدم تعارف وضع محلّ خاصّ له كما هو المتعارف بين أكثر الأعاجم والحكم بكونه نجاسة خارجية ودليل ماء الاستنجاء لا يشمله واضع المنع ومن المستبعد جدّاً أن تكون النجاسة بعينها غير مؤثّرة في انفعال ماء في الموضع ومؤثّرة فيه في نفس ذلك الماء بعد الانفصال عنه مع عدم حصول تغيير في الماء أصلاً كما هو المفروض.
الأمر الثالث: أن لا يكون متعدّياً بالتعدّي الفاحش بحيث لا يصدق معه الاستنجاء واعتبار هذا الأمر واضح لأنّه له مدخلية في قوام الموضوع وتحقّق العنوان والوجه فيه انّ الاستنجاء عبارة عمّا يستعمل في تطهير محلّ النجو والنجو ما يخرج من الموضع المعتاد من غائط أو ريح وهذا إنّما يصدق فيما إذا لم يتجاوز الغائط عن الموضع المعتاد مثل ما إذا أصاب الفخذ ـ مثلاً ـ فيبقى هذا الفرض تحت أدلّة الانفعال بلا إشكال.
الأمر الرابع: ما إذا لم تصل إليه نجاسة من خارج والدليل على اعتبار هذا الأمر وضوح انّ أدلّة طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه إنّما تقتضي الطهارة أو العفو بملاقاة عين الغائط أو البول حال الاستنجاء، وامّا ثبوت أحدهما بوصول النجاسة إليه من الخارج فلم يقم عليه دليل من دون فرق بين ما لو كان المحلّ متنجّساً بنجاسة اُخرى وبين ما لو لاقته نجاسة خارجية أو كانت اليد متنجّسة قبل الاستنجاء فإنّ الحكم في جميع الموارد هو النجاسة والانفعال.
وقد حكم في المتن بأنّ مثل الدم الخارج مع الغائط أو البول يعدّ من هذا القبيل
الصفحة 253
حتّى فيما كان يعدّ جزءً منهما على الأحوط.
أقول: امّا ما يعدّ جزء منهما فالوجه في خروجه ما عرفت من عدم صدق ماء الاستنجاء على ماء قد استعمل في تطهير الدم الخارج من المحلّ لأنّ النجو ـ على ما مرّ ـ عبارة عمّا يخرج عادةً من المحلّ من الغائط والريح فالماء المستعمل في غسل الدم الخارج من المحلّ خارج عن هذا العنوان بلا إشكال.
وامّا ما يعدّ جزءً منهما فإن لم يكن بنحو يستهلك فيهما فالظاهر عدم صدق الاستنجاء أيضاً ولا مناص من الحكم بالنجاسة وإن نفى عنه البأس في العروة لكنّه لا يتمّ أصلاً ولاسيّما فيما إذا كان الدم مع البول دون الغائط لعدم دلالة دليل لفظي على طهارة الماء المستعمل في إزالة البول فإنّ الروايات قد وردت في ماء الاستنجاء وهو ماء يستعمل في تطهير محلّ النجو، غاية الأمر انّا ألحقنا البول بالغائط من جهة عدم معهودية الاستنجاء من الغائط في محلّ ومن البول في محلّ آخر وجريان العادة على الاستنجاء منهما في مكان واحد وقد حكم على الماء المستعمل في إزالتهما ـ الذي هو ماء واحد ـ بالطهارة فيستفاد من ذلك طهارة الماء المستعمل في إزالة البول أيضاً والقدر المتيقّن من هذه الملازمة هو طهارة الماء المستعمل في إزالة نفس البول، وامّا المستعمل في طهارة البول مع الدم فلم تتحقّق فيه ملازمة فإنّ خروج الدم معه أمر قديتّفق وليس أمراً دائمياً بل ولا غالبياً فلا مجال للحكم بطهارته.
نعم لو خرج من المحلّ مع الغائط بعض الأجسام الطاهرة كما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر فلا أثر له في نجاسة الماء كما هو واضح، كما أنّه لو أصاب المحلّ جسم طاهر فتأثّر منه فإنّه لا يؤثر في النجاسة ضرورة انّ العرف لا يتعقلون تأثيره في نجاسة المحل الذي تأثّر هو منه أوّلاً، نعم لو أصابه فتأثّر ثمّ رجع ثمّ أصابه ثانياً قبل التطهير فالظاهر تأثيره في نجاسة الماء لصدق
الصفحة 254
كونها نجاسة خارجية.
الأمر الخامس: سبق الماء على اليد والظاهر عدم اعتباره كما أفاده في المتن; لأنّ كلاًّ من سبق الماء على اليد وسبق اليد على الماء أمر متعارف في الاستنجاء والإطلاق يشملهما، نعم لو أصابت يده الغائط لا لأجل الاستنجاء بل بداعي أمر آخر لا وجه ـ حينئذ ـ للحكم بالطهارة لعدم صدق الاستنجاء في هذا الفرض، فتدبّر.
الصفحة 255
مسألة 27 ـ إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي ومع عدمها ففيه تفصيل1.
1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في اشتباه النجس بين أطراف محصورة والفرق بينه وبين ما كان الأمر دائراً بين أطراف كثيرة ويعبّر عنه بالشبهة غير المحصورة فنقول ـ بعد انقسام الشبهة إلى القسمين: المحصورة وغيرها ـ انّه على التقديرين امّا أن يكون المقصود إحراز تنجيز العلم الإجمالي وانّه هل يكون العلم الإجمالي كالتفصيلي منجّزاً وموجباً لصحّة العقوبة واستحقاقها عند العقلاء ـ لو ارتكب أحد الأطراف واتّفق مصادفته للحرام الواقعي أو ارتكب الجميع ـ وامّا أن يكون النزاع في جواز الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها وعدم جوازه، كما أنّ ذلك كلّه فيما لو كان التكليف الفعلي معلوماً بالقطع واليقين، وقد يقع الكلام أيضاً فيما لو قامت الأمارة على نجاسة شيء ـ مثلاً ـ وتردّد ذلك الشيء بين أمرين أو اُمور، أو على حرمته كذلك وكذا فيما لو كان مقتضى الأصل النجاسة أو الحرمة فنقول:
امّا لو علم ـ إجمالاً ـ بحرمة شيء مردّد بين أطراف محصورة أو نجاسته فلا إشكال في كون هذا العلم منجّزاً، لأنّ التنجيز ليس إلاّ مجرّد صحّة احتجاج المولى على العبد وجواز عقوبته على ارتكاب المحرم الواقعي ومخالفة التكليف كما يظهر بالمراجعة إلى العقلاء الذين هم المرجع في مثل المقام ممّا يرجع إلى الإطاعة والعصيان وما يترتّب عليهما من استحقاق الجنان والنيران وغيره من الآثار، ومن الواضح انّه لا فرق عندهم في تنجّز التكليف المعلوم بين ما إذا كان تعلّق العلم به
الصفحة 256
على سبيل التفصيل أو على نحو الإجمال بأن كان المعلوم مردّداً بين أمرين أو أزيد، فكما أنّه يكون العبد عاصياً مستحقّاً للعقوبة فيما لو ارتكب شرب الخمر المعلوم كذلك فيما لو ارتكب شرب الخمر المشتبه المردّد بين أطراف محصورة.
وبالجملة فهذا الحكم من الأحكام البديهية عند العقلاء ولا يقبل الخدشة بوجه وكما لا يجوز للمكلّف ارتكاب أحد الأطراف لتنجّز التكليف، كذلك لا يجوز للمولى الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف للزوم المناقضة فإنّ الحكم بحرمة الخمر المردّد بين أشياء ، الذي يكون مرجعه إلى أنّ المولى لم يرفع يده عن تكليفه بمجرّد التردّد وإجمال المتعلّق، لا يجتمع مع الترخيص في بعض الأطراف الذي مرجعه إلى كون التكليف مرفوعاً على تقدير مصادفة ما رخّص فيه مع الحرام الواقعي، فثبوت التكليف على أي تقدير، ورفعه على بعض التقادير ممّا لا يجتمعان لأنّ مرجعه إلى اجتماع المتناقضين الذي يكون هو الأصل في الامتناع كارتفاعهما وإن كان الاجتماع يرجع أيضاً إلى الارتفاع كما لا يخفى.
وامّا الشبهة غير المحصورة فالتكليف الفعلي وإن كان معلوماً فيها إلاّ أنّه لا يكون منجّزاً لما عرفت من أنّ تنجّز التكليف ـ عند العقلاء ـ عبارة عن كونه بحيث يصحّ للمولى الاحتجاج به على العبد والمؤاخذة على مخالفته، وهذا لا يكون بمتحقّق في الشبهة غير المحصورة لأنّ احتمال المحرم الواقعي في كلّ واحد من الأطراف قد بلغ في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء واعتمادهم عليه، بل ربما يعدّون من رتب الأثر على هذه المرتبة من الاحتمال سفيهاً غير عاقل، ألا ترى انّ من كان له ولد ـ مثلاً ـ في بلد عظيم كثير الأهل، وسمع وقوع حادثة في ذلك البلد منتهية إلى قتل واحد من ساكنيه، فلو رتّب الأثر على مجرّد احتمال كون المقتول ولده وأقام بتعزيته والتضرّع عليه لاحتمال انطباق المقتول على ولده المحبوب لكان
الصفحة 257
مذموماً عند العقلاء مورداً للطعن والحكم عليه بالخروج عن الطريقة العقلائية بل لو صار بصدد الفحص والسؤال عن أنّه هل يكون ولده أو غيره لكان أيضاً كذلك، ولو صار مثل هذا الاحتمال سبباً لترتّب الأثر عليه لانسد باب المعيشة وسائر الأعمال كما هو ظاهر.
وبالجملة فالتكليف الفعلي وإن كان معلوماً إلاّ أنّ في كلّ واحد من الأطراف أمارة عقلائية على عدم كونه هو المحرم الواقعي لأنّ احتماله واقع بين الاحتمالات الكثيرة ـ على حسب كثرة الأطراف ـ المخالفة لذلك الاحتمال، ومع بلوغه إلى هذا الحدّ من الضعف يفرض وجوده كالعدم عند العقلاء بحيث لا يعتنون به أصلاً، فيجوز ارتكاب جميع الأطراف مع ثبوت هذه الامارة العقلائية بالإضافة إلى كلّ واحد منها، نعم لو كان قصده من أوّل الأمر ارتكاب الحرام الواقعي بارتكاب جميع الأطراف وارتكب واحداً منها واتّفقت مصادفته للحرام الواقعي تصحّ العقوبة عليه بلا ارتياب.
ثمّ إنّ المحقتق الحائري(قدس سره) في كتاب «الدرر» بعد توجيهه جواز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة بما يرجع إلى ما ذكرنا قال: «ولكن فيما ذكرنا أيضاً تأمّل فإنّ الاطمئنان بعدم الحرام في كلّ واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها وعدم خروجه عنها، وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية من الظنّ بالسلب الكلّي».
وأنت خبير بأنّه لو كان متعلّق الاطمئنان هو بعينه متعلّق العلم ـ ولو اختلفا من حيث الإيجاب والسلب ـ يلزم ما ذكر ولكنّه ليس في المقام كذلك فإنّ متعلّق العلم هو وجود الحرام بين مجموع هذه الأطراف التي لا تكون محصورة، ومتعلّق الاطمئنان هو خروج كلّ واحد منها بالقياس إلى غيره وإلاّ فتلزم المنافاة ولو لم
الصفحة 258
يكن هناك اطمئنان أصلاً، بل كان مجرّد الاحتمال ضرورة انّه كيف يجتمع العلم مع الاحتمال بل تلزم في الشبهة المحصورة أيضاً فإنّه كيف يجتمع العلم بوجود الحرام بين الانائين مع الشكّ في كلّ واحد منهما أنّه هو الحرام الواقعي لعدم إمكان اجتماع العلم مع الشكّ.
والسرّ ما ذكرنا من اختلاف المتعلّقين وانّ الشكّ إنّما يلاحظ بالقياس إلى الطرف الآخر بمعنى أنّه لا يعلم انّ هذا الاناء الواقع في طرف اليمين ظرف للمحرم الواقعي أو ذلك الاناء الواقع في طرف اليسار، ولاينافي هذا تحقّق العلم بوجود الحرام بينهما بل منشأ الشكّ هو وجود ذلك العلم.
وفيما نحن فيه حيث انّ احتمال وجود الحرام في كلّ واحد من الأطراف بخصوصه ضعيف في الغاية لوقوعه في مقابل احتمالات كثيرة على خلافه، فالاطمئنان بعدم كونه هو المحرم الواقعي إنّما هو لضعف ذلك الاحتمال بالنسبة إلى غيره وهذا لا ينافي وجود العلم بكون الحرام في هذه الأطراف غير المحصورة، غير خارج عنها بل كما عرفت يكون هذا العلم منشأً لتحقّق الاحتمال ولكنّه مع ذلك لا يجوز للمولى الترخيص ولو في ارتكاب بعض الأطراف للزوم المناقضة المذكورة في الشبهة المحصورة.
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر انّ الملاك في بلوغ الشبهة إلى حدّ عدم الحصر واتّصافها بكونها غير محصورة هو أن يكون احتمال وجود الحرام في كلّ واحد من الأطراف ضعيفاً ـ لكثرتها ـ بحيث لا يعتنى به عند العقلاء أصلاً، كما أنّ المنناط في الشبهة المحصورة هو اعتماد العقلاء واعتنائهم على احتمال كون كلّ واحد من الطرفين أو الأطراف هو المحرم الواقعي وترتيب الأثر عليه.
وممّا ذكرنا من وجود الامارة العقلائية في كلّ واحد من أطراف الشبهة غير
الصفحة 259
المحصورة ظهر انّ حال أطرافها أوسع من حال الشبهة البدوية أيضاً فإنّه إذا تردّد مائع ـ مثلاً ـ بين كونه ماءً أو لبناً لا يجوز التوضّي بذلك المائع لعدم إحراز الماء المطلق ـ الذي هو شرط في صحّة الوضوء ـ بخلاف ما لو تردّد لبن بين المياه الكثيرة فإنّه يجوز الوضوء بكلّ واحد من الأطراف وإن احتمل كونه لبناً لوجود الامارة العقلائية على الخلاف كما عرفت.
ثمّ إنّ بعض الأعاظم من المعاصرين ذكر في ضابط الشبهة غير المحصورة ـ على ما في التقريرات المنسوبة إليه ـ انّ ضابطها هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّاً لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك، وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال، فتارة يعلم بنجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حقّة منها فهذا لا يكون من الشبهة غير المحصورة لإمكان استعمال الحقة من الحنطة بطحن وخبز وأكل، مع أنّ نسبة الحبّة إلى الحقة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف، واُخرى يعلم بنجاسة إماء من لبن البلد فهذا يكون من الشبهة غير المحصورة ولو كانت أواني البلد لا تبلغ الألف لعدم التمكّن العادي من جمع الأواني في الاستعمال وإن كان المكلّف متمكّناً من آحادها، فليس العبرة بقلّة العدد وكثرته فقط إذ ربّ عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالحقة من الحنطة، كما أنّه لا عبرة بعدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال فقط إذ ربما لا يتمكّن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضاً محصورة كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب، بل لابدّ في الشبهة غير المحصورة من اجتماع كلا الأمرين وهما كثرة العدد وعدم التمكّن من جمعه في الاستعمال انتهى.
ولا يخفى انّه إن كان المراد بالتمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال هو إمكان جمعها دفعة أي في أكل واحد أو شرب واحد أو لبس واحد وهكذا فهذا
الصفحة 260
يوجب خروج أكثر الشبهات المحصورة ومنها المثال الذي ذكره لها، وإن كان المراد هو عدم التمكّن من جمعها ولو تدريجاً بحسب مرور الأيّام والدهور ومضي السنين والشهور فلازمه خروج أكثر الشبهات غير المحصورة عن كونها كذلك ودخولها في الشبهة المحصورة فلا محيص عن الالتزام بكون المناط في الحصر وعدمه ما ذكرنا فتدبّر.
ثمّ إنّهم ذكروا لوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة شروطاً واعتبروا فيه اُموراً:
منها: تنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي على كلّ تقدير بأن يكون كلّ واحد منهما ـ مثلاً ـ بحيث لو علم تفصيلاً بكونه هو المحرم الواقعي لوجب الاجتناب عنه، وامّا لو لم يكن كذلك بأن لم يكلّف به أصلاً كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إنائين أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو كثير لا ينفعل بالملاقاة لم يجب الاجتناب عن الآخر لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب، وكذا لو كان التكليف في أحدهما معلوماً لكن لا على وجه التنجّز بل معلّقاً على تمكّن المكلّف منه، فإنّ ما لا يتمكّن المكلّف من ارتكابه لا يكلّف منجّزاً بالاجتناب عنه كما إذا تردّد النجس بين إنائه وإناء آخر لا دخل للمكلّف فيه أصلاً، فإنّ التكليف بالاجتناب عن الاناء الآخر غير منجز عرفاً وإن كان متمكّناً منه عقلاً ولهذا لا يحسن التكليف المنجّز بما ليس من شأن المكلّف الابتلاء به، نعم يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيّداً بتحقّق الابتلاء.
والحاصل انّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصة بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهي عنها ولذا يعدّ خطاب غيره بالترك مستهجناً، والسرّ في ذلك انّ غير المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم الابتلاء فلا حاجة إلى
|