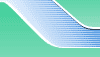(الصفحة41)
العزيز على خصوصية مفقودة في غيره ، ولا يكاد يقدر عليها البشر ، وإن بلغ ما بلغ ، وهي الإتيان بقصّة واحدة بأساليب متعدّدة وتعبيرات مختلفة متساوية من حيث الوقوع في أعلى مرتبة البلاغة ، وبذلك ترتفع الشبهة التي يمكن أن يخطر بالبال ، بل بعض الناس أوردها على الإعجاز بالبلاغة والاسلوب ، وهي انّ الجملة أو السورة المشتملة على القصّة يمكن التعبير عنها بعبارات مختلفة تؤدّي المعنى ، ولابدّ أن تكون عبارة منها ينتهي إليها حسن البيان ، مع السلامة عن كلّ عيب لفظي ، أو معنوي ، فمن سبق إلى هذه العبارة أعجز غيره عن الإتيان بمثلها ، لأنّ تأليف الكلام في اللغة لا يحتمل ذلك ، ولكن القرآن عبّر عن بعض المعاني وبعض القصص بعبارات مختلفة الاسلوب والنظم ، من مختصر ومطوّل ، والتحدّي في مثله لا يظهر في قصّة مخترعة مفتراة ، بل لابدّ من التعدّد الذي يظهر في التعبير عن المعنى الواحد والقصّة الواحدة بأساليب مختلفة وتراكيب متعدّدة.
ومن الآيات الدالّة على التحدّي قوله تعالى في سورة طه المكّية:
{أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لاَ يُؤْمِنُونَ* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيث مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ}(1).
والظاهر: انّها ناظرة إلى التحدّي بمجموع القرآن ، لأنّ المنساق من «الحديث» في مثل هذه الموارد هو الكتاب الكامل الجامع ، ويؤيّده توصيفه بالمثل المضاف إلى القرآن الظاهر في مجموعه.
ولو تنزّلنا عن ذلك فثبوت الإطلاق له بحيث يشمل ما دون سورة واحدة ، كجملة ونحوها في غاية الإشكال وإن كان مقتضى ما حكيناه عن المفسّر المتقدّم ذلك ، إلاّ انّه يبعّده ـ مضافاً إلى بعده في نفسه ـ فإنّ جملة واحدة من القرآن مشتملة
(1) الطور: 33 ـ 34.
(الصفحة42)
على معنى ومقصود ، كيف يكون البشر عاجزاً عن الإتيان بمثلها.
وقد عرفت انّ بعض المفسِّرين أنكر كون بعض السور كذلك ، وإن استظهرنا من الكتاب خلافه ـ انّ التحدّي بسورة واحدة بعد ذلك ، كما وقع في سورة البقرة المدنيّة لا يبقى على هذا الفرض له مجال ، فالإنصاف انّ تعميم «الحديث» بحيث يشمل ما دون سورة واحدة ممّا لا يرتضيه الذوق السليم ، ولا يقتضيه التأمّل في آيات التحدّي في القرآن الكريم.
ومنها: قوله تعالى في سورة البقرة المدنية:
{وإن كنتم في ريب ممّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين}(1).
واحتمل في ضمير «مثله» أن يكون راجعاً إلى «ما» الموصولة في قوله: «ممّا نزّلنا» وأن يكون عائداً إلى العبد الذي هو الرسول الذي نزل عليه القرآن ، فعلى الأوّل يوافق من حيث المدلول مع الكريمة المتقدّمة الواقعة في سورة يونس ، وعلى الثاني تمتاز هذه الآية من حيث ملاحظة من نزل عليه في مقام التحدّي.
والظاهر قوّة الاحتمال الأوّل; لأنّ المناسب بعد فرض الريب في الكتاب المنزل مع قطع النظر عمّن اُنزل عليه ، كما هو الظاهر من قوله تعالى: {وإن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا} الدالّ على أنّ متعلّق الريب نفس ما نزل هو التحدّي بخصوص ما وقع فيه الريب ، مع عدم لحاظ الواسطة أصلاً.
ويؤيّده سائر آيات التحدّي ، حيث كان مدلولها اشتمال نفس القرآن على خصوصية معجزة للغير عن الإتيان بمثله في جملته أو بسورة مثله ، مع أنّ لحاظ
(1) البقرة: 24.
(الصفحة43)
حال الواسطة الذي نزل عليه الكتاب من حيث كونه اُمّياً ليس له سابقة تعلّم ، ولم يتربى في حِجر معلِّم ومرب أصلاً ، ربّما يشعر بإشعار عرفي بأنّ الكتاب من حيث هو لا يكون بمعجز ، بحيث لا يقدر البشر على الإتيان بمثله وإن كان بالغاً في العلم ما بلغ.
وبالجملة: فالظاهر عود الضمير إلى الكتاب ، لا إلى من نزل عليه ، وعلى تقديره فالوجه في التعرّض له في هذه الآية يمكن أن يكون ـ على بعدما في بعض التفاسير ـ من أنّه لمّا كان كفّار المدينة الذين يوجّه إليهم الاحتجاج أوّلاً وبالذات هم اليهود وهم يعدّون اخبار الرسل في القرآن غير دالّة على علم الغيب ، تحدّاهم بسورة من مثل النبيّ في اُمّيته ، مع بقاء التحدّي المطلق بسورة واحدة مثله على إطلاقه غير مقيّد بكونه من مثل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن هذا الوجه مبني على كون وجه التحدّي في الآية إرادة نوع خاصّ من الإعجاز ، مع أنّه لم يثبت بل الظاهر من الآية خلافه فتدبّر جيّداً.
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في هذا المقام: إنّ اتّصاف القرآن بأنّه معجز ممّا يدلّ عليه الآيات المشتملة على التحدّي ، وانّ مقتضاها اتّصاف كلّ سورة من سورة بذلك من دون فرق بين الطويلة والقصيرة ، وامّا ما دون السورة فلم يظهر من شيء من هذه الآيات الكريمة كونه كذلك ، وامّا وجه الإعجاز ، وانّ اعجازه عام ومن جميع الجهات ، أو خاصّ ومن بعض الجهات فسيأتي التعرّض له إن شاء الله تعالى.
(الصفحة44)
القرآن معجزة خالدة
من الحقائق التي لا يشكّ فيها مسلم ، بل كلّ من له أدنى مساس بعالم الأديان من الباحثين والمطّلعين; أنّ الكتاب العزيز هو المعجزة الوحيدة الخالدة ، والأثر الفرد الباقي بعد النبوّة ، ولابدّ من أن يكون كذلك ، فإنّه بعد اتّصاف الدين الإسلامي بالخلود والبقاء ، وتلبّس الشريعة المحمّدية بلباس الخاتميّة والدوام لا محيص من أن يكون بحسب البقاء ـ إثباتاً ـ له برهان ودليل ، فإنّ النبوّة والسفارة كما تحتاج في أصل ثبوتها ابتداءً إلى الإعجاز ، والإتيان بما يخرق العادة وناموس الطبيعة كذلك يفتقر في بقائها إلى ذلك خصوصاً إذا كانت دائميّة باقية ببقاء الدهر.
ومن المعلوم: أنّ ما يصلح لهذا الشأن ليس إلاّ الكتاب ، ويدلّ هو بنفسه على ذلك في ضمن آيات كثيرة; منها قوله تعالى في سورة الإسراء:
{قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً}(1).
فإنّ التحدّي في هذه الآية عام شامل لكلّ من الإنس والجنّ ، أعمّ من الموجودين في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بل الظاهر الشمول للسابقين عليه أيضاً ، وعموم التحدّي دليل على خلود الإعجاز كما هو ظاهر.
(1) الإسراء: 88.
(الصفحة45)
ومنها: قوله في سورة إبراهيم:
{كتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد}(1).
فإنّ إخراج الناس الظاهر في العموم من الظلمات إلى النور بسبب الكتاب النازل ، كما تدلّ عليه لام الغاية ، لا يكاد يمكن بدون خلود الإعجاز ، فإنّ تصدّي الكتاب للهداية بالإضافة إلى العصور المتأخّرة إنّما هو فرع كونه معجزة خالدة ، ضرورة أنّه بدونه لا يكاد يصلح لهذه الغاية أصلاً.
ومنها: قوله تعالى في سورة الفرقان:
{تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً}(2).
فإنّ صلاحية الفرقان للإنذار كما هو ظاهر الآية بالنسبة إلى العالمين ، الظاهرة في الأوّلين والآخرين لا تتحقّق بدون الاتّصاف بخلود الإعجاز ، كما هو واضح.
ودعوى انصراف لفظ «العالمين» إلى خصوص الموجودين ، كما في قوله تعالى في وصف مريم: {واصطفيناك على نساء العالمين} ضرورة عدم كونها مصطفاة على جميع نساء الأوّلين والآخرين ، الشاملة لمن كان هذا الوصف مختصّاً بها ، وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
مدفوعة: بكون المراد بالعالمين في تلك الآية ـ أيضاً ـ هو الأوّلين والآخرين ، غاية الأمر أنّ المراد بالاصطفاء ـ فيها كما تدلّ عليه الرواية المعتبرة ـ هو الولادة من غير بعل ، ومن الواضح اختصاص هذه المزيّة بمريم ، وانحصارها بها ، وعدم
(1) إبراهيم: 1.
(2) الفرقان: 1.
(الصفحة46)
اشتراكها فيها أحد من النساء.
وبالجملة: لا ينبغي الإرتياب في كون المراد من العالمين في آية الفرقان ليس خصوص الموجودين في ذلك العصر.
ومنها: غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يستفاد منها ذلك ، ولا حاجة إلى التعرّض لها بعد وضوح الأمر وظهور المطلوب.
(الصفحة47)
وجوه إعجاز القرآن
(الصفحة48)
تحدّيات القرآن التي عجزت عنها المعارضة. التحدّي بالاسلوب والمضمون. التحدّي بالمناهج والتشريعات ، وأسرار التكوين ، وما وراء الطبيعة وعالم الآخرة ، والمغيبات.
(الصفحة49)
لا يرتاب ذو مسكة في اختلاف طبقات الناس ، وتنوّع أفراد البشر في اجتناء الكمالات العلمية المختلفة ، وحيازة الفنون المتشتّتة. والوجه في ذلك ـ مضافاً إلى افتقار تحصيل كلّ واحدة منها إلى صرف مؤونة الزمان ، وغيره من المقدّمات الكثيرة والأسباب المتعدّدة ـ اختلافهم بحسب النظر والتفكّر وتفاوتهم بلحاظ الذوق والعلاقة فترى بعضهم يشتري بعمره الطويل الوصول إلى العلوم الصناعية وبعضاً آخر يتحمّل مشقّات فوق الطاقة العاديّة لتحصيل علم الفلسفة مثلاً ، وهكذا سائر العلوم والمعارف المادّية والمعنويّة ، بل اتّساع دائرة جميع العلوم اقتضى انقسام كلّ واحدة منها إلى شعب وأقسام ، بحيث لا يكاد يوجد من حازه بجميع شعبه وناله بتمام أقسامه ، وهذا كما في علم الطبّ في هذه الأزمنة والعصور المتأخِّرة ، فإنّه لا يوجد واحد مطّلع على جميع شؤونه المتكثّرة ، وشعبه المتعدّدة ، بل بعد صرف زمان طويل وتهيئة مقدّمات كثيرة قد يقدر على الوصول إلى بعض شعبه ، وحصول المهارة الكاملة في خصوص تلك الشعبة ، كما نراه بالوجدان.
وبالجملة: ما ذكرناه في اختلاف طبقات البشر ، واتّساع دائرة كلّ واحد من العلوم ، بحيث لا يكاد يمكن الوصول إلى واحد بتمام شؤونه فكيف الجميع ، ممّا لا
(الصفحة50)
حاجة في إثباته إلى بيِّنة وبرهان ، بل يكفي في تصديقه مجرّد ملاحظة الوجدان.
وحينئذ نقول: إنّ الكتاب العزيز ، والقرآن المجيد حيث يكون الغرض من إنزاله ، والغاية من إرساله ، اهتداء عموم الناس ، وخروجهم من الظلمات إلى النور ، كما صرّح هو بذلك في الآية المتقدّمة من سورة إبراهيم ـ آية 1.
والظاهر ـ كما عرفت ـ عدم اختصاص الناس بخصوص الموجودين في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنّه كما تقدّم معجزة خالدة يوم القيامة ، مضافاً إلى أنّه كتاب جامع لجميع الكمالات المعنويّة ، والفضائل الروحية ، والقوانين العمليّة ، والدستورات الكاملة الدنيوية حيث انّه يتضمّن البحث عن الاُصول الاعتقادية المطابقة للفطرة السليمة ، وعن الفضائل الأخلاقية ، والقوانين الشرعية ، والقصص الماضية ، والحوادث الآتية ، وبالتالي عن جميع الموجودات الأرضية والسماوية ، وجميع الحالات والعوالم ، وكلّ ما له دخل في سعادة الإنسان في الدار الفانية والدار الباقية ، فمثل هذا الكتاب ـ الذي ليس كمثله كتاب ـ كيف يمكن أن يكون إعجازه من وجه خاصّ ، مع كونه واقعاً قبال جميع البشر ، بل والجنّ أيضاً.
والذي ينادي بذلك بأعلى صوته قوله تعالى في سورة الإسراء:
{قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً}(1).
وجه الدلالة:
أوّلاً: فرض اجتماع الإنس والجنّ ، وفي الحقيقة دعوتهم إلى الإتيان بمثل القرآن ، مع أنّك عرفت ثبوت الاختلاف بينهم ، واختصاص كلّ طبقة وطائفة
(1) الاسراء: 88.
(الصفحة51)
بفضيلة خاصّة من سنخ الفضائل التي يشتمل عليها الكتاب ، فكيف يمكن أن يكون وجه الإعجاز هي البلاغة والفصاحة ـ مثلاً ـ مع أنّه لم يقع التصدّي للوصول إلى هذين العلمين إلاّ من صنف خاصّ قليل الافراد ، فدعوة غيره إلى الإتيان بمثل القرآن من خصوص هذه الجهة لا يترتّب عليها فائدة أصلاً ، فتوجّه الدعوة إلى العموم دليل ظاهر على عدم اختصاص الإعجاز بوجه خاصّ.
وثانياً: قد عرفت اشتمال الكتاب العزيز على جهات متكثّرة ، وشؤون مختلفة من الاُصول الاعتقادية الراجعة إلى الإلهيّات والنبوّات وغيرهما ، والفضائل الأخلاقية والسياسات المدنيّة ، والقوانين التشريعيّة العمليّة ، وغير ذلك من القصص والحكايات الماضية والحوادث الكائنة في الآتية ، والاُمور الراجعة إلى الفلكيات ، ووصف الموجودات السماوية والأرضية ، وغير ذلك ، مضافاً إلى الجهات الراجعة إلى مقام الألفاظ والعبارات ، وحينئذ عدم ذكر وجه المماثلة في الآية الكريمة ، مع عدم الانصراف إلى وجه خاصّ من تلك الوجوه المذكورة دليل على عدم الاختصاص ، وانّ اجتماع الجنّ والإنس واستظهار بعضهم ببعض لا يكاد يؤثّر في الإتيان بمثل القرآن في شيء من الوجوه المذكورة.
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا فساد دعوى اختصاص الإعجاز بوجه خاصّ ـ أي وجه كان ـ نعم قد وقع التحدّي في الكتاب ببعض الوجوه والمزايا ، ولا بأس بالتعرّض لها ولبعض ما لم يقع التحدّي فيه بالخصوص ، تتميماً للفائدة ، وتعظيماً للكتاب الذي هي المعجزة الوحيدة الخالدة.
(الصفحة52)
التحدّي
بمن اُنزل عليه القرآن
ممّا وقع التحدّي به في الكتاب العزيز هو: الرسول الاُمّي ، الذي اُنزل عليه القرآن ، قال الله تعالى في سورة يونس:
{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآن غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم* قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}(1)
فإنّ قوله تعالى: «أفلا تعقلون» يرجع إلى انّ من كان له حظّ من نعمة العقل ، التي هي عمدة النعم الإلهيّة ، إذا رجع إلى عقله واستقضاه يعرف أنّ الكتاب الذي أتى به النبيّ ، الذي كان فيهم مدّة أربعين سنة ، وفي تلك المدّة مع وضوح حاله واطّلاع الناس على وضعه لم يظهر منه فضل ، ولم ينطق بعلم ، حتّى أنّه مع تداول الشعر وشيوعه بينهم ، بحيث لا يرون القدر إلاّ له ، ولا يرتّبون الأجر إلاّ عليه ، وكان هو السبب الوحيد في الامتياز والفضيلة ، لم يصدر منه شعر ، بل ولم يأت بنثر ما ، لا محالة يكون من عند الله ، فإنّه كيف يمكن أن يأتي الاُمّي بكتاب جامع لجميع
(1) يونس: 15 ـ 16.
(الصفحة53)
الكمالات اللفظية والمعنوية ، والقوانين والحدود الدينيّة والدنيويّة.
نعم ، حيث عجزوا عن معارضته ، وكلّت ألسنة البُلغاء دونه ، لم يجدوا بدّاً من الافتراء الظاهر ، والبهتان الواضح ، فقالوا فيه: إنّه سافر إلى الشام للتجارة ، فتعلّم القصص هناك من الرهبان ، ولم يتعقّلوا أنّه لو فرض ـ محالاً ـ صحّة ذلك ، فما هذه المعارف والعلوم ، ومن أين هذه القوانين والأحكام ، وهذه الحكم والحقائق ، وممّن هذه البلاغة في جميع الكتاب.
كما أنّه أخذوا عليه أنّه كان يقف على قين بمكّة من أهل الروم كان يعمل السيوف ويبيعها ، ولقد أجابهم عن ذلك الكتاب بقوله في سورة النحل:
{ولقد نعلم انّهم يقولون إنّما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسانٌ عربيّ مبين}.
كما أنّه قالوا فيه: إنّه أخذ من سلمان الفارسي ، وهو من علماء الفرس ، وكان عالماً بالمذاهب والأديان ، مع أنّ سلمان إنّما آمن به في المدينة بعد نزول أكثر القرآن بمكّة ، مضافاً إلى اختلاف الكتاب مع العهدين في القصص وفي غيرها اختلافاً كثيراً مع أنّه لم يكن ـ حينئذ ـ وجه الايمان سلمان به ، مع كونه هو الأصل في الفضيلة على هذا القول ، ولعمري أنّ مثل ذلك ممّا لا مساغ للتفوّه به.
فانقدح انّ اُمّية الرسول من وجوه الإعجاز التي قد وقع التحدّي بها في الكتاب كما عرفت.
(الصفحة54)
التحدّي
بعدم الاختلاف والسلامة والاستقامة
قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء83:
{أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}.
دلّ على ثبوت الملازمة بين كون القرآن من عند غير الله ووجدان الاختلاف الكثير فيه وجداناً حقيقيّاً ، فلابدّ من استكشاف بطلان المقدّم من بطلان التالي وحيث انّ الموضوع هو القرآن المعهود بتمام خصوصيّاته ، وجميع شؤونه ومزاياه ، فلا يكاد يتوهّم انّ كلّ كتاب لو كان من عند غير الله لكان ذلك مستلزماً لوجدان الاختلاف الكثير فيه ، حتّى يرد عليه منع الملازمة في بعض الموارد ، بل في كثيرهاو ضرورة أنّ الموضوع الذي يدور حوله اختلاف الأنظار ، من جهة كونه نازلاً من عند غيره هو شخص القرآن الكريم ، الذي هو كتاب خاصّ فالملازمة إنّما هي بالإضافة إليه.
وحينئذ فلابدّ من ملاحظة الجهات الكثيرة التي يشتمل عليها ، والخصوصيّات المتنوّعة التي يحيط بها ، والمزايا الحقيقيّة التي يمتاز بها ، وكلّ جهة ينبغي أن تلحظ ، وكلّ أمر يناسب أن يراعى.
فنقول: تارةً يلاحظ نفس القرآن ويجعل موضوعاً للملازمة ، مع قطع النظر
(الصفحة55)
عن كون الآتي به مدّعياً ، لكونه من عند الله ، وانّه أنزل عليه من مبدأ الوحي ، واُخرى مع ملاحظة الاقتران بدعوى كونه من عند غير الممكن.
فعلى الأوّل: يكون الوجه في الملازمة الخصوصيّات التي يشتمل عليها القرآن من جهة اشتماله على فنون المعارف ، وشتّى العلوم ، كالاُصول الاعتقادية ، والقوانين الشرعية العلميّة ، والفضائل الكاملة الأخلاقية ، والقصص والحكايات التاريخية ، والحوادث الكائنة في الآتية ، والعلوم الراجعة إلى الفلكيات ، وبعض الموجودات غير المرئية ، وغير ذلك من الجهات التي لا تحيط بها يد الإحصاء ، ولا تنالها أفكار العقلاء ضرورة أنّ مثل هذا الكتاب المشتمل على هذه الخصوصيات لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ، بداهة انّ نشأة المادّة تلازم التحوّل والتكامل ، والموجودات التي هي أجزاء هذا العالم لا تزال تتحوّل وتتكامل ، وتتوجّه من النقص إلى الكمال ومن الضعف إلى القوّة ، والإنسان الذي هو ن جملة هذه الموجودات محكوم أيضاً لهذا القانون الطبيعي ، ومعرّض للتغيّر والتبدّل ، والتحوّل والتكامل في ذاته وأفعاله وآثاره وأفكاره وإدراكاته ولا يكاد ينقضي عليه أزمان ـ وهو غير متغيّر ـ ولا يتصرّم عليه أحيان وهو غير متبدّل.
أضف إلى ذلك: انّ عروض الأحوال الخارجية ، وتبدّل العوارض الحادثة يؤثّر في الإنسان أثراً عجيباً ، ويغيّره تغيّراً عظيماً ، فحالة الأمن تغاير الخوف من جهة التأثير ، والسفر والحضر متفاوتان كذلك ، والفقر والغنى والسلامة والمرض ، كلّ ذلك على هذا المنوال. وعليه فكيف يمكن أن يكون الكتاب النازل في مدّة زائدة على عشرين سنة ، الجامع للخصوصيّات المذكورة وغيرها ، من عند غير الله ، ومع ذلك لم يوجد فيه اختلاف ، فضلاً عن أن يكون كثيراً ، ولم يرَ فيه تناقض ، فضلاً
(الصفحة56)
عن أن يكون عديداً.
وعلى الثاني: يكون الوجه في الملازمة ـ مضافاً إلى الخصوصيات المشتمل عليها الكتاب ـ الاقتران بدعوى كونه من عند الله ، نظراً إلى أنّ الذي يبني أمره على الكذب والافتراء لا محيص له عن الواقع في الاختلاف والتناقض ، ولاسيّما إذا تعرّض لجميع الشؤون البشرية والاُمور المهمّة الدنيوية والأخرويّة ، وخصوصاً إذا كانت المدّة كثيرة زائدة على عشرين سنة ، وفي المثل المعروف: «لا حافظة لكذوب». ثمّ إنّ في هذا المقام إشكالين:
أحدهما: منع بطلان التالي المستلزم لبطلان المقدّم ، لأنّه قد أخذ على القرآن مناقضات واختلافات ، وقد بلغت من الكثرة إلى حدّ ربما ألّف فيها التأليفات ، وكتب فيها الرسالات.
والجواب عنه: انّ المناقضات المذكورة كلّها مذكورة في كتب المفسِّرين ، ومأخوذة منها ، وقد أوردوها مع أجوبتها في تفاسيرهم ، وغرضهم من ذلك إزالة كلّ شبهة يمكن أن ترد ، ودفع كلّ توهّم يمكن أن يتخيّل ، لكن الأيادي الخائنة ، والعناصر الضالّة المضلّة المرصدة لاستفادة السوء من كلّ قضيّة وحادثة قد جمعوا تلك الشبهات في كتب وتأليفات ، من دون التعرّض للأجوبة الكافية ، ونعم ما قيل:
«لو كانت عين الرضا متّهمة فعين السخط أولى بالتّهمة».
ثانيهما: اعتراف القرآن بوقوع النسخ فيه ، في قوله تعالى في سورة البقرة 116: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} وفي قوله تعالى في سورة النحل 101: {وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} والنسخ من أظهر
(الصفحة57)
مصاديق الاختلاف.
والجواب عنه:
أوّلاً: منع كون النسخ اختلافاً ، فضلاً عن أن يكون من أظهر مصاديقه فإنّه ـ بحسب الاصطلاح ـ يرجع إلى رفع أمر ثابت في الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه ، ومن الواضح انّ ارتفاع الحكم لأجل ارتفاع زمانه لا يعدّ تناقضاً ، ولا يوجب اختلافاً.
وثانياً: فإنّ النسخ إن كان بنحو تكون الآية الناسخة ناظرة بالدلالة اللفظية إلى الحكم المنسوخ ، ومبنيّة لرفعه ، كما في آية النجوى الواقعة في سورة المجادلة 13:
{يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإنّ الله غفور رحيم}.
حيث ذهب أكثر العلماء إلى نسخا بقوله تعالى بعد هذه الآية 14:
{ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبيرٌ بما تملون}.
فعدم كونه من مصاديق الاختلاف ممّا ينبغي فيه الشكّ والارتياب.
وإن كان بنحو يكون مقتضى الجمع بين الآيتين اللّتين يترائى بينهما الاختلاف والتنافي ، هو حمل الآية المتأخّرة على كونها ناسخة ، والمتقدّمة على كونها منسوخة ـ كما التزم به كثير من المفسِّرين ـ فثبوته في القرآن غير معلوم ، ولابدّ من البحث عنه في فصل مستقلّ ولِمَ لا يجوز الاستدلال بهذه الآية أعني قوله تعالى: {أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان...} الآية على نفي وقوعه في القرآن وسلامته من ثبوت النسخ فيه بهذا المعنى ، كما لا يخفى.
(الصفحة58)
التحدّي
بأنّه تبيان كلّ شيء
قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل 89: {ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء} فإنّ اتّصاف الكتاب ـ الذي يكون المراد به هو القرآن بملاحظة التنزيل ـ بكونه تبياناً لكلّ شيء دليل على كونه نازلاً من عند من يكون له إحاطة كاملة بجميع الأشياء ، بحيث لا يغيب عنه شيء أو لا يعزب عنه من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ، امّا الموجود الذي تكون إحاطته العلمية تابعة لأصل وجوده في النفس والمحدودية ، كيف يمكن أن يكون من عنده كتاب موصوف بأنّه تبيان كلّ شيء ، فمن هذه الخصوصية التي لا يعقل أن تتحقّق في البشر ، والكتاب الذي من عنده تستكشف خصوصية اُخرى وهي نزوله من عند الله العالم القادر المحيط كما هو واضح.
نعم ، ربما يمكن أن يتوهّم انّ القرآن لا يكون تبياناً لكلّ شيء ، لأنّا نرى عدم تعرّضه لكثير من المسائل المهمّة الدينية ، والفروع الفقهية العمليّة ، فضلاً عمّا ليس له مساس بالدين ، وليس بيانه من شأن الله تبارك وتعالى بما هو شارع وحاكم ، فإنّ مثل أعداد ركعات الصلاة التي هي عمود الدين ومعراج المؤمن ـ على ما روي ـ لا يكون مذكوراً في الكتاب العزيز ، مع أنّها من الأهمّية بمثابة تكون الزيادة
(الصفحة59)
عليها والنقص عنها قادحة مبطلة ، فضلاً عن خصوصيات سائر العبادات والأعمال من الصوم والزكاة والحج وغيرها ، وعليه فكيف يصف القرآن نفسه ويعرّفه بأنّه تبيان كلّ شيء.
والجواب:
عن هذا التوهّم ، انّ شأن الكتاب إنّما هو بيان الكلّيات ورؤوس المطالب ، وامّا الجزئيات والخصوصيات فإنّما تستكشف من طريق الرسول ، الذي فرض القرآن نفسه الأخذ بما آتاهم ، والانتهاء عن ما نهاهم بقوله تعالى في سورة الحشر 7: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ففي الحقيقة انّ كون القرآن تبياناً أعمّ من أن يكون تبياناً للشيء بنفسه ، أو بواسطة الرسول الذي نزّل عليه القرآن.
ومن الآيات التي يمكن أن يستدلّ بها على التحدّي بالعلم ، قوله تعال يفي سورة الأنعام 59: {ولا رطب ولا يابس إلاّ في كتاب مبين} بناءً على كون المراد بالكتاب المبين هو القرآن المجيد ، وكون المراد بالرطب واليابس المنفيّين هو علم كلّ شيء بحيث تكون الآية كناية عن الإحاطة العلميّة ، والبيان الكامل الجامع ، فيرجع المراد إلى ما في الآية المتقدّمة من كون الكتاب جامعاً لعلم الأشياء ، وحاوياً لبيان كلّ شيء.
لكن الظاهر انّه ليس المراد بالكتاب المبين هو القرآن ، بل شيئاً آخر يكون فيه جميع الموجودات والأشياء بأنفسها ، ويؤيّده صدر الآية وهو قوله تعالى: {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاّ هو} وكذا تعلّق النفي بنفس الرطب واليابس الظاهرين في أنفسهما ، لا في العلم بهما ، وكذا عدم اختصاص النفي بهما ، بل تعلّقه بالحبّة التي في
(الصفحة60)
ظلمات الأرض ، لأنّ الاستثناء يتعلّق به أيضاً ، فلابدّ من الالتزام بكون المراد بها هو العلم بالحبّة أيضاً ، وهو خلاف الظاهر جدّاً ، وعليه يكون مفاد الآية أجنبيّاً عمّا نحن بصدده ، لأنّ مرجعه إلى ثبوت الأشياء الموجودات بأنفسها في الكتاب الذي هو بمنزلة الخزينة لها.
نعم ، يبقى الكلام في المراد من ذلك الكتاب ، وانّه هل هو عبارة عن صفحة الوجود المشتملة على أعيان جميع الموجودات ، أو أمر آخر يغاير هذا الكون ، ثابت فيه الأشياء نوعاً من الثبوت ، كما يشير إليه قوله تعالى في سورة الحجر 21: {وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَر مَعْلُوم} وعلى أيّ لا يرتبط بالمقام الذي يدور البحث فيه حول الكتاب بمعنى القرآن المجيد الذي يكون معجزة.
|