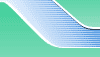(الصفحة21)
الذي يأتي به مدّعيه لإثبات صدقه لا يسمّى معجزة ، لعدم توقّف إثباته على الإتيان بأمر خارق للعادة ، بل يمكن التوسّل بدليل آخر كالامتحان ونحوه ، ففي الحقيقة ، المعجزة: عبارة عن الدليل الخارق للعادة الذي ينحصر طريق إثبات الدعوى به ولا سبيل لإثباته غيره.
الثالث: أن تكون الدعوى في نفسها ممّا يجري فيه احتمال الصدق والكذب وإلاّ فلا تصل النوبة إلى المعجزة ، بل لا يتحقّق الإعجاز بوجه ، ضرورة أنّه مع العلم بصدق الدعوى لا حاجة إلى إثباتها ، ومع العلم بكذبها لا معنى لدلالتها عى صدق مدّعيها وإن كان البشر عاجزاً عن الإتيان بمثلها ـ فرضاً ـ وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الكذب معلوماً من طريق العقل ، أو من سبيل النقل ، فإذا ادّعى أحد أنّه هو الله الخالق الواجب الوجود وأتى بما يعجز عنه البشر ـ فرضاً ـ فذلك لا يسمّى معجزة ، لأنّ الدعوى في نفسها باطلة بحكم العقل ، للبراهين القطعيّة العقليّة الدالّة على استحالة ذلك ، كما أنّه إذا ادّعى أحد النبوّة بعد خاتم النبيّين (صلى الله عليه وآله وسلم)وأتى ـ فرضاً ـ بما يخرق نواميس الطبيعة والقوانين الجارية فذلك لا يسمّى معجزة بالإضافة إلى المسلم الذي لا يرتاب في صحّة اعتقاده ونبوّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنّه كما ثبتت نبوّته كذلك ثبتت خاتميّته بالأدلّة القاطعة النقليّة ، فالمعتبر في تحقّق المعجزة ـ اصطلاحاً ـ كون الدعوى محتملة لكلّ من الصدق والكذب.
ومن ذلك يظهر: انّ المعجزات المتعدّدة لمدّع واحد إنّما يكون اتّصافها بالإعجاز بلحاظ الأفراد المتعدّدة ، فكلّ معجزة إنّما يكون إعجازها بالإضافة إلى من كانت تلك المعجزة دليلاً عنده على صدق المدّعي ، وإلاّ فلو كان صدق دعواه ـ عنده ـ ثابتاً بالمعجزة السابقة بحيث لا يكون هذا الشخص في ريب وشكّ أصلاً ،
(الصفحة22)
فلا تكون المعجزة اللاّحقة معجزة بالإضافة إليه بوجه ، فاتّصاف اللاّحقة بهذا الوصف إنّما هو لأجل تأثيرها في هداية غيره ، وخروج ذلك الغير من الشكّ إلى اليقين لأجلها ، وبعبارة اُخرى إنّما يكون اتّصافها بالإعجاز عند الغير لا عند هذا الشخص.
الرابع: كون ذلك الأمر خارقاً للعادة الطبيعيّة ، وخارجاً عن حدود القدرة البشرية ، وفيه إشارة إلى أنّ المعجزة تستحيل أن تكون خارقة للقواعد العقليّة ، وهو كذلك ضرورة أنّ القواعد العقلية غير قابلة للإنخرام ، كيف وإلاّ لا يحصل لنا القطع بشيء من النتائج ، ولا بحقيقة من الحقائق ، فإنّ حصول القطع من القياس المركّب من الصغرى والكبرى ـ بما هو نتيجته ـ إنّما يتفرّع على ثبوت القاعدة العقلية الراجعة إلى امتناع اجتماع النقيضين ، ضرورة أنّ حصول العلم بحدوث العالم ـ مثلاً ـ من القياس المركّب من: «العالم متغيّر وكلّ متغيّر حادث» إنّما يتوقّف على استحالة اتّصاف العالم بوجود الحدوث وعدمه معاً ، ضرورة أنّه بدونها لا يحصل القطع بالحدوث في مقابل العدم ، كما هو غير خفيّ.
وكذلك العلم بوجود الباري ـ جلّت عظمته ـ من طريق البراهين الساطعة القاطعة ، الدالّة على وجوده إنّما يتوقّف على استحالة كون شيء متّصفاً بالوجود والعدم معاً في آن واحد ، وامتناع عروض كلا الأمرين في زمان فارد ، بداهة أنّه بدونها لا مجال لحصول القطع بالوجود في مقابل العدم ، كما هو ظاهر.
فالقواعد العقلية خصوصاً قاعدة امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، التي إليها ترجع سائر القواعد ، وعليها يبتني جميع العلوم والمعارف ، بعيدة عن عالم الانخراق والانخرام بمراحل لا يمكن طيّها أصلاً.
(الصفحة23)
ويدلّ على ما ذكرنا من استحالة كون المعجزة خارقة للقواعد العقليّة في خصوص المقام: أنّ الغرض من الإتيان بالمعجزة إثبات دعوى المدّعي واستكشاف صدقه في ثبوت المنصب الإلهي ، فإذا فرضنا إمكان تصرّف المعجزة في القواعد العقلية وانخرامها بها ، لا يحصل الغرض المقصود منها ، فإنّ دلالتها على صدق مدّعي النبوّة ـ مثلاً ـ إنّما تتمّ على تقدير استحالة اتّصاف شخص واحد في زمان واحد بالنبوّة وجوداً وعدماً ، وإلاّ فلا مانع من ثبوت هذا الاتّصاف ، وتحقّق كلا الأمرين ، فلا يترتّب عليها الغاية من الإتيان بها ، والغرض المقصود في البين ، كما لا يخفى.
وعلى ما ذكرنا فالمعجزة ما يكون خارقاً للعادة الطبيعيّة ، التي يكون البشر عاجزاً عن التخلّف عنها ، إلاّ أن يكون مرتبطاً بمنع القدرة المطلقة المتعلّقة بكلّ شيء ، ومنه يظهر الفرق بين السحر وبين المعجزة ، وكذا بينها وبين ما يتحقّق من المرتاضين ، الذين حصلت لهم القدرة لأجل الرياضة ـ على اختلاف أنواعها وتشعّب صورها ـ على الإتيان بما يعجز عنه من لم تحصل له هذه المقدّمات ، فإنّ ابتناء مثل ذلك على قواعد علميّة ، أو أعمال رياضية توجب خروجه عن دائرة المعجزة ، التي ليس لها ظهير إلاّ القدرة الكاملة التامّة الإلهيّة ، وهكذا الإبداعات الصناعيّة ، والاختراعات المتنوّعة; والكشفيّات المتعدّدة من الطبّية وغيرها من الحوادث المختلفة العاجزة عنها الطبيعة البشرية ، قبل تحصيل القواعد العلميّة التي تترتّب عليها هذه النتائج ، وإن كان الترتّب أمراً خفيّاً يحتاج إلى الدقّة والاستنباط ، فإنّ جميع ذلك ليس ممّا يعجز عنه البشر ، ولا خارقاً لناموس الطبيعة أصلاً.
(الصفحة24)
نعم ، يبقى الكلام بعد وضوح الفرق بين المعجزة وغيرها بحسب الواقع ومقام الثبوت ، فإنّ الاُولى خارجة عن القدرة البشريّة بشؤونها المختلفة ، والثانية تتوقّف على مبادئ ومقدّمات يقدر على الإتيان بها كلّ من يحصل له العلم بها والاطّلاع عليها ـ في تشخيص المعجزة عن غيرها ـ بحسب مقام الإثبات ، وفي الحقيقة في طريق تعيين المعجزة عمّا يشابهها صورة ، وأنّه هل هنا امارة مميّزة وعلامة مشخّصة أم لا؟
والظاهر: أنّ الأمارة التي يمكن أن تكون معيّنة عبارة عن أنّ المعجزة لا تكون محدودة من جهة الزمان والمكان ، وكذا من سائر الجهات كالآلات ونحوها ، حيث انّ أصلها القدرة الأزلية العامّة غير المحدودة بشيء ، وهذا بخلاف مثل السّحر والأعمال التي هي نتائج الرياضات ، فإنّها ـ لا محالة ـ محدودة من جهة من الجهات ولا يمكن التعدّي عن تلك الجهة ، فالرياضة التي نتيجتها التصرّف في المتحرّك وإمكانه ـ مثلاً ـ لا يمكن أن تتحقّق من غير طريق تلك الآلة ، وهكذا ، فالمحدوديّة علامة عدم الإعجاز.
مضافاً إلى أنّ الأغراض الباعثة على الإتيان مختلفة ، بداهة أنّ النبيّ الواقعي لا يكون له غرض إلاّ ما يتعلّق بالاُمور المعنويّة ، والجهات النفسانيّة ، والسير بالناس في المسير الكمالي المتكفّل لسعادتهم.
وأمّا النبيّ الكاذب فلا تكون استفادته من المعجزة إلاّ الجهات الراجعة إلى شخصه من الاُمور المادّية ، كالشهرة والجاه والمال وأشباهها ، فكيفيّة الاستفادة من المعجزة من علائم كونها معجزة أم لا ، كما هو واضح.
الخامس: أن يكون الإتيان بذلك الأمر مقروناً بالتحدّي الراجع إلى دعوة
(الصفحة25)
الناس إلى الإتيان بمثله إن استطاعوا ، ليعلم بذلك:
أوّلاً ـ غرض المدّعي الآتي بالمعجزة ، وأنّ الغاية المقصودة من الإتيان بها تعجيز الناس ، وإثبات عجزهم من طريق لا يمكنهم التخلّص عنه ، ولا الإشكال عليه.
وثانياً ـ أنّ عدم الإتيان بمثله لم يكن لأجل عدم تحدّيهم للإتيان ، وعدم ورودهم في هذا الوادي ، وإلاّ فكان من الممكن الإتيان بمثله ، ضرورة أنّ التحدّي الراجع إلى تعجيز الناس الذي يترتّب عليه أحكام وآثار عظيمة من لزوم الإطاعة للمدّعي ، وتصديق ما يدّعيه ، ويأتي به من القوانين والحدود ، والتسليم في مقابلها يوجب ـ بحسب الطبع البشري والجبلة الإنسانية ـ تحريكهم إلى الإتيان بمثله ، لئلاّ يسجّل عجزهم ويثبت تصوّرهم ، وعليه فالعجز عقيب التحدّي لا ينطبق عليه عنوان غير نفس هذا العنوان ، ولا يقبل مجملاً غير ذلك ولا يمكن أن يلبّس بلباس آخر ولا تعقل موازاته بالأغراض الفاسدة ، والعناد والتعصّب القبيح.
السادس: أن يكون سالماً عن المعارضة ، ضرورة أنّ مع الابتلاء بالمعارضة بالمثل لا وجه لدلالته على صدق المدّعى ولزوم التصديق ، لأنّه إن كان المعارض ـ بالكسر ـ قد حصّل القدرة من طريق السحر والرياضة ـ مثلاً ـ فذلك كاشف عن كون المعارض ـ بالفتح ـ قد أتى بما هو خارق للعادة والناموس الطبيعي ـ وقد مرّ اعتباره في تحقّق الإعجاز الاصطلاحي بلا ارتياب ـ وإن كان المعارض قد أقدره الله تبارك وتعالى على ذلك لإبطال دعوى المدّعي فلا يبقى ـ حينئذ ـ وجه لدلالة معجزه على صدقه أصلاً.
وبالجملة: مع الابتلاء بالمعارضة يعلم كذب المدّعي في دعوى النبوّة ، إمّا
(الصفحة26)
لأجل عدم كون معجزته خارقة للعادة الطبيعية ، وإمّا لأجل كون الفرض من اقدار المعارض إبطال دعواه ، إذ لا يتصوّر غير هذين الفرضين فرض ثالث أصلاً ، كما لا يخفى.
السابع: لزوم التطبيق ، بمعنى أن يكون الأمر الخارق للعادة ، الذي يأتي به المدّعي للنبوّة والسفارة كان وقوعه بيده بمقتضى إرادته وغرضه ، بمعنى تطابق قوله وعمله ، فإذا تخالف لا يتحقّق الإعجاز بحسب الاصطلاح ، كما حكي أنّ مسيلمة الكذّاب تفل في بئر قليلة الماء ليكثر ماؤها فغار جميع ما فيها من الماء ، وانّه أمرَّ يده على رؤوس صبيان بني حنيفة وحنكهم فأصاب القرع كلّ صبيّ مسح رأسه ، ولثغ كلّ صبيّ مسح حنكه ، وإن شئت فسمِّ هذه المعجزة الدالّة على الكذب ، لأنّه أجرى الله تعالى هذا الأمر بيده لإبطال دعواه ، وإثبات كذبه ، وهداية الناس إلى ذلك.
بقي الكلام: في حقيقة المعجزة في أمر ، وهو انّ الإعجاز هل هو تصرّف في قانون الأسباب والمسبّبات العاديّة ، وراجع إلى تخصيص مثل: «أبى الله أن يجري الاُمور إلاّ بأسبابها» أو انّه لا يرجع إلى التصرّف في ذلك القانون ، ولا يستلزم التخصيص في مثل تلك العبارة الآبية بظاهرها عن التخصيص ، بل التصرّف إنّما هو من جهة الزمان ، وإلغاء التدريج والتدرّج بحسبه ، فمرجع الإعجاز في مثل جعل الشجر اليابس خضراً ـ في الفصل الذي لا يقع فيه هذا التبدّل والتغيّر عادة من الفصول الأربعة السنوية ـ إلى تحصيل ما يحتاج إليه الشجر في الاخضرار من حرارة الشمس والهواء والماء ، وما يستفيده من الأرض في آن واحد ، لا إلى استغنائه عن ذلك رأساً؟ الظاهر هو الوجه الثاني وإن كان لا يترتّب على هذا البحث ثمرة كثيرة مهمّة.
(الصفحة27)
نعم ، يظهر ممّا استظهرناه الجواب عمّا استند إليه المادّيون في دعواهم إنكار المعجزة ، من أنّ المعجزة الراجعة إلى الإتيان بما يخرق العادة يوجب انحزام أصل «العليّة والمعلوليّة» والخدشة في هذه القاعدة المسلّمة في العلوم الطبيعية ، وفي العلم الأعلى والفلسفة ، فإنّ ابتنائهما على قانون العلّية ممّا لا يكاد يخفى ، ولا يمكن للعقل أيضاً إنكاره فإنّ افتقار الممكن ـ في مقابل الواجب والممتنع ـ إلى العلّة بديهي لأنّه حيث لا يكون في ذاته اقتضاء الوجود والعدم ، بل يكون متساوي النسبة إليهما ، كما هو معنى الإمكان ، فترجيح أحد الأمرين لا يمكن إلاّ بعد وجود مرجّح في البين ، يكون ذلك المرجّح خارجاً عن ذات الممكن وماهيّته ، وذلك المرجّح إنّما هي العلّة التي تؤثّر في أحد الطرفين ، وتخرج الممكن عن حدّ التساوي.
وحينئذ يقال في المقام: إنّ المعجزة كما أنّها خارقة للعادة الطبيعية كذلك خارمة لهذه القاعدة العقلية المشتهرة بقانون العلّية والمعلوليّة ، وموجبة لوقوع التخصيص فيها ، وحيث انّها غير قابلة للتخصيص فلا محيص عن إنكارها كلاًّ ونفيها رأساً.
والجواب:
أوّلاً: انّ ما تقتضيه القاعدة المسلّمة إنّما هو مجرّد افتقار الممكن إلى العلّة المرجّحة ، وامّا انّ تلك العلّة لابدّ وأن تكون طبيعيّة مادّية فهو أمر خارج عن مقتضى تلك القاعدة ، والقائلون بثبوت الإعجاز لا ينكرون القاعدة أصلاً ، بل غرضهم انّ العلّة المرجّحة أمر خارج عن إدراك البشر وقدرته ، فالمعجزة لا تنافي القاعدة أصلاً ، وبعبارة اُخرى تكون العلّة أمراً غير طبيعي مرتبطاً بالقدرة الكاملة
(الصفحة28)
الإلهيّة غير المحدودة.
وثانياً: قد عرفت أنّه لا مانع من الالتزام بثبوت العلّة الطبيعيّة في باب المعجزة ، وخرق العادة إنّما هو بلحاظ إلغاء التدريج والتدرّج ، وفي الحقيقة خروجها عن حدود القدرة البشريّة إنّما هو بلحاظ هذا الإلغاء بحسب الزمان ، لا بلحاظ قطعها عن الارتباط بالعلّة الطبيعيّة ـ كما عرفت في مثال جعل الشجر اليابس خضراً ـ فتدبّر جيّداً.
ثمّ إنّه ربما يستدلّ ببعض الآيات القرآنية على أنّه لا يلزم على النبيّ الإتيان بالمعجزة وترتيب الأثر على قول من يطلبها ، وهي قوله تعالى في سورة بني إسرائيل: {وقالوا لن نؤمن لك حتّى تفجّر لنا من الأرض ينبوعاً.. قل سبحان ربّي هل كنت إلاّ بشراً رسولاً} فإنّها ظاهرة في أنّه بعد تعليقهم الإيمان على الإتيان بالمعجز لم يأت النبيّ بما هو مطلوبهم ، بل أظهر العجز بلسان كونه بشراً رسولاً ، فمنها يستفاد عدم لزوم اقتران دعوى النبوّة بما هو معجزة.
والجواب:
أمّا أوّلاً: فإنّ افتقار النبيّ في دعوى النبوّة وصدقها إلى الإتيان بالمعجز من المسلّمات العقلية التي لا يشوبها ريب ، ضرورة أنّه مع عدم الافتقار لا يبقى افتراق بين النبيّ الصادق والنبيّ الكاذب ، ولا يكون للأوّل مزيّة وفضيلة أصلاً ، وحينئذ فإنّ فرض دلالة الآية على خلافه ، وانّه لا حاجة إلى الإعجاز مع فرض صدق المدّعي ، فاللاّزم تأويلها كما هو الشأن في غيرها من الآيات الظاهرة في خلاف ما هو المسلّم عند العقل ، كقوله تعالى في سورة الفجر: {وجاء ربّك}.
(الصفحة29)
وأمّا ثانياً: فإنّ الإتيان بالمعجز لا معنى لأن يكون تابعاً لطلب الناس وهوى أنفسهم ، بحيث تكون خصوصيّاته راجعة إلى تعيين الشاكّ واختياره ، ضرورة أنّ المعجزة أمر إلهي لا يكون للنبيّ فيه إرادة واختيار ، بل كان بإرادة الله تعالى على أنّه لا معنى لطلب معجزة مخصوصة بعد الإتيان بما هو معجزة حقيقة ، وظاهر الآيات المذكورة أنّ طلبهم من النبيّ تلك الاُمور المذكورة فيها كان بعد الإتيان بالقرآن الذي هو أعظم المعجزات. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّه لا يختصّ وصف الإعجاز بمجموع القرآن ، بل يكون كلّ سورة من سوره الطويلة والقصيرة واجدة لهذا الوصف ، وحينئذ فالطلب منهم دليل على عدم كونهم بصدد الاهتداء ، بل على لجاجهم وعنادهم ، وتعصّبهم القبيح ، فإنّه لا وجه بعد الإتيان بالمعجزة لطلب معجزة اُخرى ، مع فرض كون الشخص بصدد الاهتداء وتبعيّة النبي الصادق.
وأمّا ثالثاً: فغير خفيّ على الناظر في الآيات انّ ما كانوا يطلبونه لم يكن معجزة بوجه ، إمّا لكونه من الاُمور الموافقة للعادة الطبيعيّة ، كفجر الينبوع من الأرض ، وثبوت بيت من الزخرف له ومثلهما ، وإمّا لكونه منافياً لغرض الإعجاز كسقوط السماء الموجب لهلاك طالب المعجزة ، وإمّا لكونه مستحيلاً عقلاً ، كالإتيان بالله من السماء بعنوان الشهادة ولأجلها. وقد مرّ أنّ المعجزة لا تبلغ حدّ التصرّف في المستحيلات العقليّة لعدم قابليّتها للانحزام بوجه.
وامّا رابعاً: فهذا القرآن الكريم يصرّح في غير موضع بثبوت المعجزة للأنبياء السالفين كموسى وعيسى وغيرهما وانّ تصديقهم كان لأجل الإتيان بها ، وعليه فهل يمكن أن يقال بدلالته على عدم الافتقار إلى المعجزة أو بدلالته على كذب المعجزات السالفة. نعوذ بالله من الضلالة والخروج عن دائرة الهداية.
(الصفحة30)
وجه دلالة الإعجاز على الصدق
الظاهر: أنّ الوجه في دلالة الإعجاز على صدق مدّعي النبوّة ليس إلاّ قبح الإغراء بالجهل على الحكيم على الإطلاق ، فإنّه حيث لا يمكن التصديق بنبيّ من غير جهة الإعجاز ، ضرورة انحصار الطريق العقلائي بذلك ، مع أنّ النبوّة والسفارة من المناصب الإلهيّة التي ليس فوقها منصب ، ومن هذه الجهة يكثر المدّعي لها ، والطالب للوصول إليها ، فإذا صدر منه أمر خارق للعادة الطبيعيّة ، العاجزة عنه الطبيعة البشريّة ، فإن كان كاذباً في نفس الأمر ، ومع ذلك لم يبطله الله تعالى ، والمفروض انّه ليس للناس طريق إلى إبطاله من التمسّك بالمعارضة ، فهو لا ينطبق عليه عنوان من ناحية الله ، إلاّ عنوان الإغراء بالجهل القبيح في حقّه ، ولكن ذلك إنّما يتوقّف على القول بالتحسين والتقبيح العقليّين ، كما عليه من عدى الأشاعرة ، وامّا بناء على مسلكهم الفاسد من إنكار الحسن والقبح رأساً فلا طريق إلى تصديق النبيّ من ناحية المعجزة أصلاً.
وما يقال: من أنّ فرض المعجزة ملازم لكونها من الله سبحانه ، ولا حاجة فيه إلى القول بالحسن والقبح العقليّين ، لأنّ المعجزة مفروض انّها خارجة عن حدود القدرة البشريّة فلا مناص عن كونها من الله سبحانه.
مدفوع: فإنّه ليس البحث في الاتّصاف بالإعجاز ، حتّى يقال إنّ فرضه ملازم
(الصفحة31)
لكونه من الله سبحانه ، بل البحث ـ بعد الفراغ عن كونه معجزة ـ في دلالة الإعجاز على صدق مدّعي النبوّة في دعواها ، فمن الممكن انّ الأقدار من الله لم يكن لأجل كونه نبيّاً ، بل لغرض آخر ، فمجرّد كون المعجزة من الله لا يستلزم الصدق ، إلاّ مع ضميمة ما ذكرنا من لزوم الإغراء بالجهل القبيح ، ومع إنكار القبح والحسن ـ كما هو المفروض ـ ينسدّ هذا الباب ، ولا يبقى مجال للتصديق من ناحية الإعجاز.
وما حكي عن بعض الأشاعرة من جريان عادة الله على صدور ما يخرق العادة ، وناموس الطبيعة بيد النبيّ فقط ، يدفعه أنّ العلم بذلك من غير طريق النبيّ كيف يمكن أن يحصل ، والمفروض أنّ الشكّ في أصل نبوّته ، مضافاً إلى أنّه لا دليل على لزوم الالتزام بهذه العادة ، مع إنكار القبح رأساً.
(الصفحة32)
إعجاز القرآن
(الصفحة33)
القرآن معجزة خالدة. لا يختصّ إعجاز القرآن بوجه خاصّ. التحدّي بمن أنزل عليه القرآن ، التحدّي بعدم الاختلاف والسلامة والاستقامة. التحدّي بأنّه تبيان كلّ شيء. التحدّي بالاخبار بالغيب. التحدّي بالبلاغة. القرآن ومعارفه الاعتقادية. القرآن وقوانينه التشريعية. القرآن وأسرار الخلقة.
(الصفحة34)
ليس في الكتاب العزيز ما يدلّ بظاهره على توصيفه بالإعجاز الاصطلاحي بهذه اللفظة ، بل وقع فيه التحدّي به ، الذي هو الركن الأعظم للمعجزة ، وتتقوّم به حقيقتها ، والآيات الدالّة على التحدّي بمجموع القرآن أو ببعضه لا تتجاوز عن عدّة:
أوّلها: الآية الكريمة الواردة في سورة الإسراء: {قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً}(1).
والظاهر من الآية الكريمة الإخبار عن عدم الإتيان بمثل القرآن ، لأجل عدم تعلّق قدرتهم به ، وأنّ القرآن يشتمل على خصوصيّات ومزايا من جهة اللفظ والمعنى لا يكاد يقدر عليها الإنس والجنّ ، وإن اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيراً ، فاتّصاف القرآن بأنّه معجز إنّما هو من جهة الخصوصيّة الموجودة في نفسه ، البالغ بتلك الخصوصية حدّاً يعجز البشر عن الإتيان بمثله.
وعليه: فما ذهب إليه من وصف بأنّه شيطان المتكلِّمين من القول بالصرف في إعجاز القرآن ، وانّ الله صرف الناس عن الإتيان بمثله مع ثبوت وصف القدرة لهم ،
(الصفحة35)
وتوفّر دواعيهم عليه; مناف لما هو ظاهر الآية الشريفة ، المعتضد بما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة من بلوغ القرآن علوّاً وارتفاعاً إلى حدّ لا تصل إليه أيدي الناس ، ولا محيص لهم إلاّ الاعتراف بالعجز والقصور والخضوع لديه.
فهذا القول باطل من أصله ، وإن استصوبه الفخر الرازي في تفسيره ، واختاره ـ خصوصاً ـ بالإضافة إلى السور القصيرة ، كسورتي العصر والكوثر زاعماً أنّ دعوى خروج الإتيان بأمثال هذه السور عن مقدور البشر مكابرة ، والإقدام على أمثال هذه المكابرات ممّا يطرق التّهمة إلى الدين. وسيأتي البحث معه في اتّصاف السورة القصيرة بالإعجاز.
وثانيها: ما ورد في سورة يونس من قوله تعالى: {أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين}(1).
وثالثها: ما ورد في سورة هود من قوله تعالى: {أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا فاعلموا إنّما اُنزل بعلم الله وان لا إله إلاّ هو فهل أنتم إلاّ مسلمون}(2).
وهذه السور الثلاث على ما رواه الجمهور نزلت بمكّة متتابعات ، وفي رواية عن ابن عبّاس انّ سورة يونس مدنيّة ، والرواية الاُخرى عنه الموافقة لقول الجمهور ولأسلوبها ، فإنّه اسلوب السور المكّية.
وها هنا إشكال: وهو أنّ الترتيب الطبيعي في باب التحدّي يقتضي التحدّي أوّلاً بالقرآن بجملته ، ثمّ بعشر سور مثله ، ثمّ بسورة واحدة مثله ، مع أنّه على رواية
(1) يونس: 38.
(2) هود: 13 ـ 14.
(الصفحة36)
الجمهور وقع التحدّي بالعشر متأخّراً عن التحدّي بسورة واحدة ، نعم لا مجال لهذا الإشكال بناءً على إحدى روايتي ابن عبّاس من كون سورة يونس بتمامها مدنيّة.
وحكي عن بعض في مقام التفصّي عن هذا الإشكال أنّ الترتيب بين السورة ونزول بعضها قبل بعض لا يستلزم الترتيب بين آيات السور ، فكم من آية مكّية موضوعة في سورة مدنيّة وبالعكس ، فمن الجائز ـ حينئذ ـ أن تكون آيات التحدّي من هذا القبيل ، بأن تكون آية التحدّي بعشر سور نازلة بعد آية التحدّي بالقرآن في جملته ، وقبل آية التحدّي بسورة واحدة ، بل جعل الفخر الرازي في تفسيره مقتضى النظم والترتيب الطبيعي قرينة على هذا التقديم والتأخير.
ويرد على هذا البعض: أنّ مجرّد الاحتمال لا يحسم مادّة الإشكال ، وعلى الفخر أنّ صيرورة ذلك قرينة إنّما تتمّ على تقدير عدم إمكان التوجيه بما لا يخالف الترتيب الطبيعي ، وهو لم يثبت بعد.
وحكي عن بعض آخر في مقام الجواب عن أصل الإشكال ما حاصله ـ على ما لخّصه بعض من مفسِّري العصر ـ أنّ القرآن الكريم معجز في جميع ما يتضمّنه من المعارف ، والأخلاق ، والأحكام ، والقصص وغيرها ، وينعت به من الفصاحة والبلاغة وانتفاء الاختلاف ، وإنّما تظهر صحّة المعارضة والإتيان بالمثل عند إتيان عدّة من السور يظهر به ارتفاع الاختلاف ، وخاصّة من بين القصص المودعة فيها مع سائر الجهات ، كالفصاحة والبلاغة والمعارف وغيرها ، وإنّما يتمّ ذلك بإتيان أمثال السور الطويلة التي تشتمل على جميع الشؤون المذكورة ، وتتضمّن المعرفة والقصّة والحجّة وغير ذلك ، كسورتي الأعراف والأنعام.
والتي نزلت من السور الطويلة القرآنية ممّا يشتمل على جميع الفنون المذكورة
(الصفحة37)
قبل سورة هود ـ على ما ورد في الرواية ـ هي سورة الأعراف ، وسورة يونس ، وسورة مريم ، وسورة طه ، وسورة الشعراء ، وسورة النمل ، وسورة القصص ، وسورة القمر ، وسورة ص ، فهذه تسع من السور عاشرتها سورة هود وهذا هو الوجه في التحدّي بأمرهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات.
واُورد عليه ـ مضافاً إلى عدم ثبوت الرواية التي عوّل عليها ـ بأنّ ظاهر الآية أنّ رميهم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالافتراء قول تقوّلوه بالنسبة إلى جميع السور القرآنية ، طويلتها وقصيرتها ، فمن الواجب أن يجابوا بما يحسم مادّة الشبهة بالنسبة إلى كلّ سورة قرآنية ، لا خصوص الإتيان بعشر سور طويلة جامعة للفنون القرآنية ، مع أنّ الضمير في «مثله» الواقع في الآية الشريفة إن كان راجعاً إلى القرآن ـ كما هو ظاهر هذا القائل ـ أفاد التحدّي بإتيان عشر سور مفتريات مثله مطلقاً ، سواء في ذلك الطوال والقصار ، فتخصيص التحدّي بعشر سور طويلة جامعة; تقييد من غير مقيّد ، وإن كان عائداً إلى سورة هود كان مستبشعاً من القول ، خصوصاً بعد عدم اختصاص الرمي بالافتراء بسورة هود ، لأنّه كيف يستقيم في مقام الجواب عن الرمي بأنّ مثل سورة الكوثر من الافتراء أن يقال: ائتوا بعشر سور مفتريات مثل سورة هود كما هو واضح.
وقد تفصّى عن هذا الإشكال بعض الأعاظم في تفسيره الكبير المعروف بـ «الميزان في تفسير القرآن» بكلام طويل يرجع حاصله إلى: «انّ كلّ واحدة من آيات التحدّي تؤم غرضاً خاصّاً في التحدّي ، لأنّ جهات القرآن وما به تتقوّم حقيقته وهو كتاب إلهي ـ مضافاً إلى ما في لفظه من الفصاحة ، وفي نظمه من البلاغة إنّما ترجع إلى معانيه ومقاصده ، لا ما يقصده علماء البلاغة من قولهم: إنّ البلاغة من
(الصفحة38)
صفات المعنى. لأنّهم يعنون به المفاهيم من جهة ترتّبها الطبيعي في الذهن ، من دون فرق بين الصدق والكذب والهزل والفحش وما جرى مجراها ، بل المراد من المعنى ما يصفه تعالى بأنّه كتاب حكيم ، ونور مبين ، وقرآن عظيم ، وهاد يهدي إلى الحقّ ، وإلى طريق مستقيم ، وما يضاهي هذه التعبيرات ، وهذا هو الذي يصحّ أن يتحدّى به بمثل قوله: «فليأتوا بحديث مثله» فانّا لا نسمّي الكلام حديثاً إلاّ إذا اشتمل على غرض هامّ يتحدّث به ، وكذا قوله: «فأتوا بسورة مثله» فإنّ الله لا يسمّي جماعة من آيات كتابه وإن كانت ذات عدد سورة إلاّ إذا اشتملت على فرض إلهي بها تتميّز عن غيرها ، ولولا ذلك لم يتمّ التحدّي بالآيات القرآنية ، وكان للخصم أن يختار من مفردات الآيات عدداً ذا كثرة ، ثمّ يقابل كلاًّ منها بما يناظرها من الكلام العربي من غير أن يضمن ارتباط بعضها ببعض ، فالذي كلّف به الخصم في هذه التحدّيات هو أن يأتي بكلام يماثل القرآن ، مضافاً إلى بلاغة لفظه في بيان بعض المقاصد الإلهيّة.
والكلام الإلهي ـ مع ما تحدّى به في آيات التحدّي ـ يختلف بحسب ما يظهر من خاصّته ، فمجموع القرآن الكريم يختصّ بأنّه كتاب فيه يحتاج إليه نوع الإنسان إلى يوم القيامة من معارف أصلية ، وأخلاق كريمة ، وأحكام فرعية ، والسورة من القرآن تختصّ ببيان جامع لغرض من الأغراض الإلهيّه ، وهذه خاصّة غير الخاصّة التي يختصّ بها مجموع القرآن الكريم ، والعدّة من السور كالعشر والعشرين منها تختصّ بخاصّة اُخرى ، وهي بيان فنون من المقاصد والأغراض والتنوّع فيها ، فإنّها أبعد من احتمال الاتّفاق».
إلى أن قال: «إذا تبيّن ما ذكرنا ظهر أنّ من الجائز أن يكون التحدّي بمثل قوله:
(الصفحة39)
«قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ» الآية وارداً مورد التحدّي بجميع القرآن لما جمع فيه من الأغراض الإلهيّة ، ويختصّ بأنّه جامع لعامّة ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ، وقوله: «قل فأتوا بسورة مثله» لما فيها من الخاصّة الظاهرة وهي أنّ فيها بيان غرض تامّ جامع من أغراض الهدى الإلهي بياناً فصلاً من غير هزل ، وقوله: «قل فأتوا بعشر سور» تحدّياً بعشر من السور القرآنية لما في ذلك من التفنّن في البيان ، والتنوّع في الأغراض من جهة الكثرة. والعشرة من ألفاظ الكثرة كالمائة والألف ، قال تعالى: {يودّ أحدهم لو يعمّر ألف سنة}.
إلى أن قال: «وأمّا قوله: «فليأتوا بحديث مثله» فكأنّه تحدٍّ بما يعمّ التحدّيات الثلاثة السابقة ، فإنّ الحديث يعمّ السورة والعشر سور والقرآن كلّه ، فهو تحدٍّ بمطلق الخاصّة القرآنية وهو ظاهر».
ويرد عليه: أنّ ما أفاده وحقّقه وإن كان في نفسه تامّاً لا ينبغي الارتياب فيه إلاّ أنّه يصلح وجهاً لأصل التحدّي بالواحد والكثير ، والتفنّن والتنوّع في هذا المقام وأمّا التحدّي بالعشر بعد الواحد ، المخالف للترتيب الطبيعي الذي يبتنى عليه الإشكال ، فما ذكره لا يصلح وجهاً له ، ضرورة أنّه بعد التحدّي بالواحد بما فيه من الخاصّة الظاهرة الراجعة إلى غرض تامّ جامع من الأغراض الإلهيّة ، كيف تصل النوبة إلى التحدّي بما يتضمّن التفنّن في البيان والتنوّع في الأغراض ، فإنّ العاجز من الإتيان بما فيه غرض واحد جامع كيف يتصوّر أن يقدر على ما فيه أغراض كثيرة متنوّعة بداهة أنّ التنوّع فرع الواحد ، فمجرّد اختلاف الغرض في باب التحدّي ، وكون كلّ واحدة من الآيات الواردة في ذلك الباب ـ مترتّباً عليها غرض خاصّ في مقام التحدّي ـ لا يوجب تصحيح الترتيب والنظم الطبيعي ، أترى أنّ هذا الذي
(الصفحة40)
أفاده يسوّغ أن يكون التحدّي بمجموع القرآن متأخِّراً عن التحدّي بسورة واحدة ، مع أنّ الغرض مختلف ، فانقدح أنّ مجرّد الاختلاف لا يحسم مادّة الإشكال ، وانّ التحدّي بالعشر بعد الواحدة لا يكاد يمكن توجييه بما ذكر.
ويمكن أن يقال في مقام التفصّي عن الإشكال: إنّ تقييد العشر بكونها مفتريات ، الوارد في هذه الآية فقط يوجب الانطباق على ما يوافق النظم الطبيعي.
توضيح ذلك: انّ الافتراء المدلول عليه بقوله: «مفتريات» يغاير الافتراء الواقع في صدر الآية في قوله: «أم يقولون افتراه» فإنّ الافتراء هناك افتراء بحسب نظر المدّعى ، ولا يقبله الطرف الآخر بوجه ، وفي الحقيقة يكون الافتراء المدعى افتراءً واقعيّاً غير مطابق للواقع بوجه ، ولكن الافتراء هنا افتراء مقبول للطرفين ، والغرض ـ والله أعلم ـ انّ اتّصاف القرآن بالإعجاز وإن كان ركنه الذي يتقوّم به إنّما هي المقاصد الإلهية ، والأغراض الربوبيّة ، التي يشتمل عليها ألفاظه المقدّسة ، وعباراته الشريفة ، إلاّ انّه لا ينحصر بذلك ، بل لو فرض كون المطالب غير واقعية والقصص كاذبة لكان البشر عاجزاً عن التعبير بمثل تلك الألفاظ ، مع النظم الخاصّ ، والاسلوب المخصوص.
ففي الحقيقة: يكون التحدّي في هذه الآية ـ بعد الإغماض عن علوّ المطالب ، وسموّ المعاني ، وصدق القصص ، وواقعيّة المفاهيم ـ بخلاف التحدّي الواقع في الآية الكريمة في سورة يونس ، بالإتيان بسورة مثل سور القرآن ، فإنّ ظاهره المماثلة من جهة المزايا الراجعة إلى المعنى والخصوصيّات المشتملة عليها الألفاظ معاً.
نعم ، يبقى الكلام ـ بعد ظهور عدم كون المراد بالعشرة إلاّ الكثرة لا العدد الخاصّ ـ في حكمة العناية بالكثرة ، ولعلّها عبارة عن التنبيه على اشتمال الكتاب
|