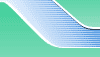(الصفحة181)
الثالث : حديث الثقلين المعروف بين الفريقين ، الدالّ على لزوم التمسّك بهما ، وانّه الطريق الوحيد للخروج عن الضلالة ، والسبيل المنحصر لعدم الابتلاء بها أبداً .
وجه الدلالة في المقام : انّه من الواضح انّ معنى التمسّك بالكتاب ـ الذي هو أحد الثقلين ـ ليس مجرّد الاعتقاد بأنّه قد نزل من عند الله حجّة على الرسالة ، ودليلاً على النبوّة ، وبرهاناً على صدق النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بل معنى التمسّك به الموجب لعدم الاتّصاف بالضلالة أصلاً هو الأخذ به ، والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي وسائر ما يشتمل عليه ، والاستناد إليه في القصص الماضية ، والقضايا السالفة .
وبعبارة اُخرى ، التمسّك به معناه يرجع إلى ما بيّنه النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ في كلامه الشريف المتقدّم ـ من جعل القرآن إماماً وقائداً ، ليسوقه إلى الجنّة ، وهذا لا يجتمع مع عدم حجّية ظاهرة ، وافتقاره إلى البيان في جميع موارده ، وكونه بنفسه غير قابل للدرك والمعرفة ، كما هو غير خفيّ على أهله .
الرابع : الروايات الكثيرة المتواترة ، الدالّة على عرض الأخبار الواصلة ، على الكتاب ، وطرح ما خالف منها ، بتعبيرات مختلفة ، وألفاظ متنوّعة ، مثل انّه يضرب ـ أي المخالف ـ على الجدار ، أو انّه زخرف ، أو انّه باطل ، أو انّه ليس منهم (عليهم السلام)ونظائره .
فإنّه من الواضح انّ تعيين «المخالف» عن غيره ، وتمييزه عمّا سواه قد أوكل إلى الناس ، فهم المرجع في التشخيص ، ولازم ذلك حجّية ظواهر الكتاب عليهم ، وإلاّ فكيف يمكن لهم تشخيص «المخالف» عن غيره .
ومن هذا القبيل الروايات الواردة في الشروط ، وانّ كلّ شرط جائز وماض
(الصفحة182)
إلاّ شرطاً خالف كتاب الله ، فإنّ المرجع في تعيين الشرط المخالف ، وتمييزه عن غيره هو العرف ، وهو لا يعرف ذلك إلاّ بعد المراجعة إلى الكتاب ، وفهم مقاصده من ألفاظه ، ودرك أغراضه من آياته .
ودعوى انّ المراد بـ «المخالف» في الموردين يمكن أن يكون هو المخالف لمصرّحات الكتاب ، دون ظواهره التي يجري فيها احتمال الخلاف ، وتكون محلّ البحث في المقام ، فسادها : غنيّ عن البيان .
الخامس : الروايات الكثيرة الدالّة على استدلال الأئمّة (عليهم السلام) بالكتاب في موارد كثيرة :
1 ـ قوله (عليه السلام) بعدما سأله زرارة بقوله : «من أين علمت انّ المسح ببعض الرأس : لمكان الباء»(1) فنّ مرجعه إلى أنّه لو كان السائل توجّه إلى هذه النكتة في آية الوضوء لما احتاج إلى السؤال أصلاً ، لأنّ ظهور «الباء» في التبعيض ، وحجّية الظهور كليهما ممّا لا يكاد ينكر .
إن قلت : لعلّ السؤال إنّما هو لأجل عدم ظهور آية الوضوء في المسح ببعض الرأس ، لعدم كون «الباء» ظاهرة في التبعيض ، وعليه لا تكون الرواية دالّة على حجّية الظاهر .
قلت : اقتصاره (عليه السلام) في الجواب على قوله : «لمكان الباء» دليل على أنّ ظهور «الباء» في التبعيض ممّا لا يكاد يخفى ، وإلاّ لما تمّ الاقتصار كما هو ظاهر .
2 ـ قوله (عليه السلام) لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء ، لاستماع الغناء اعتذاراً بأنّه لم يكن شيئاً أتاه برجله : «أما سمعت قول الله عزّوجلّ : {انّ السمع والبصر والفؤاد
(1) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، ب23 ح1 .
(الصفحة183)
كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً}» وقول المخاطب : كأنّي ما سمعت هذه الآية أصلاً(1) .
3 ـ قوله (عليه السلام) في تحليل نكاح العبد للمطلّقة ثلاثاً : قال الله عزّوجلّ : {حتّى تنكح زوجاً غيره} وقال هو أحد الأزواج(2) .
4 ـ قوله (عليه السلام) في أنّ المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ بالعقد المنقطع : «إنّ الله تعالى قال : {فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}» ولا طلاق في المتعة(3) .
5 ـ قوله (عليه السلام) فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على اصبعه مرارة : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله : {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ثمّ قال : امسح عليه(4) .
6 ـ عن تفسير العيّاشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوّجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة ، أو هجرها أو أتى عليها سريّة فإنّها طالق ، فقال (عليه السلام) : «شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته وتزوّج عليها ، وتسرّى وهجرها إن أتت بسبب ذلك ، قال الله تعالى : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} وقال : {أو ما ملكت أيمانكم} وقال : {واللاّتي تخافون نشوزهنّ} الآية .
7 ـ وما عن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر عن أبي عبدالله (عليهما السلام) قال :
(1) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، ب23 ح1 .
(2) وسائل الشيعة ، أقسام الطلاق وأحكامه ، ب12 ح12 .
(3) وسائل الشيعة ، أقسام الطلاق وأحكامه ، ب9 ح4 .
(4) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، ب39 ح5 .
(الصفحة184)
«المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلاّ بإذن سيِّده قلت : فإن كان السيِّد زوجة بيده من الطلاق؟ قال : بيد السيِّد ـ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ـ فشيء الطلاق» .
8 ـ وغير ذلك من الموارد الكثيرة المتفرّقة في أبواب الفقه التي قد استدلّ فيها الإمام (عليه السلام) بالكتاب سيّما في قبال المخالفين المنكرين لإمامتهم ، فإنّه لو كان مذاقهم عدم حجّية ظاهر الكتاب لغيرهم لما كان للاستدلال به في مقابلهم وجه أصلاً .
أدلّة منكري حجّية ظواهر الكتاب
وامّا المنكرون لحجّية ظواهر الكتاب الذين هم جماعة من المحدِّثين فاستندوا في ذلك إلى اُمور :
أحدها : انّه قد ورد في الروايات المتواترة بين الفريقين ، النهي عن تفسير القرآن بالرأي ، وفي بعضها : «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار» أي فليتّخذ مكاناً من النار لأجل القعود ولا محيص له عنهاو والأخذ بظواهر القرآن من مصاديق التفسير بالرأي ، فإنّه وإن لم يكن مصداقه منحصراً بذلك لشموله ـ قطعاً ـ لحمل المتشابه والمبهم على أحد معنييه أو معانيه مستنداً إلى الظنّ أو الاستحسان ، إلاّ أنّ الظاهر شموله لحمل الظواهر على ظاهرها ، والعمل بما تقتضيه .
والجواب :
أوّلاً : انّ التفسير بحسب اللغة والعرف بمعنى : كشف القناع وإظهار أمر مستور ، ومن المعلوم انّ الأخذ بظاهر اللفظ لا يكون من التفسير بهذا المعنى ، فلا يقال لمن أخذ بظاهر كلام من يقول ـ مثلاً ـ : رأيت أسداً ، وأخبر بأنّ فلاناً قد رأى
(الصفحة185)
الحيوان المفترس انّه فسّر كلامه ، وقد شاع في العرف انّ الواقعة أمر وتفسير الواقعة أمر آخر .
وبالجملة : لا ينبغي الارتياب في أنّ «التفسير» لا يشمل حمل اللفظ على ظاهره ، فالمقام خارج عن مورد تلك الروايات موضوعاً .
وثانياً : انّه على فرض كون الأخذ بالظاهر تفسيراً ، فلا يكون تفسيراً بالرأي حتّى تشمله الروايات المتواترة الناهية عن التفسير بالرأي .
وبعبارة اُخرى : يستفاد من تلك الروايات انّ التفسير يتنوّع إلى نوعين وينقسم إلى قسمين : تفسير بالرأي وتفسير بغيره ، ولابدّ للمستدلّ بها للمقام من إثبات أنّ الأخذ بظاهر اللفظ من مصاديق القسم الأوّل ، ومع عدمه يكفي مجرّد الشكّ لعدم صلاحية الروايات الناهية للشمول للمقام ، لعدم إحراز موضوعها ، وعدم ثبوت عنوان «التفسير بالرأي» .
مع أنّه من الواضح عدم كونه من مصاديقه ـ على فرض كونه تفسيراً ـ فإنّ من يترجم خطبة من خطب «نهج البلاغة» مثلاً بحسب ما يظهر من عباراتها ، وعلى طبق ما يفهمه العرف العارف باللغة العربيّة ، مع مراعاة القرائن الداخلية والخارجية لا يعدّ عمله هذا تفسيراً بالرأي بوجه من الوجوه أصلاً .
فالتفسير بالرأي معناه الاستقلال في المراجعة إلى الكتاب ، من دون السؤال عن الأوصياء الذين هم قرناء الكتاب في وجوب التمسّك ، ولزوم المراجعة إليهم :
إمّا بحمل المتشابه على التأويل الذي تقتضيه آراؤهم كما يشير إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) : «إنّما هلك الناس في المتشابه لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة
(الصفحة186)
الأوصياء فيعرِّفونهم» .
وإمّا بحمل اللفظ على ظاهره من العموم أو الإطلاق أو غيرهما ، من دون الأخذ بالتخصيص ، أو التقييد ، أو القرينة الواردة عن الأئمّة (عليهم السلام) وقد عرفت انّ محلّ النزاع في حجّية ظواهر الكتاب غير ذلك .
وثالثاً : انّه على فرض كون الأخذ بظاهر القرآن من مصاديق التفسير بالرأي لتشمله الروايات الناهية عنه نقول : لابدّ من الجمع بين هذه الطائفة والروايات المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في حجّية ظواهر الكتاب بحمل التفسير بالرأي الوارد في الروايات الناهية على غير هذا المصداق من المصاديق الظاهرة الواضحة كحمل المتشابه على التأويل الذي يقتضيه الرأي ، أو حمل الظاهر عليه من دون المراجعة إلى القرينة على الخلاف ، ولا مجال لغير هذا النحو من الجمع بعد ظهور الروايات المتقدّمة ، بل صراحتها في حجّية ظواهر الكتاب كما هو غير خفيّ .
ثانيها : دعوى اختصاص فهم القرآن بأهل الكتاب الذين اُنزل عليهم ، وهم الأئمّة المعصومون ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ ومنشأ هذه الدعوى الروايات الظاهرة في ذلك مثل :
مرسلة شعيب بن أنس عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال لأبي حنيفة : «أنت فقيه أهل العراق؟! قال : نعم ، قال (عليه السلام) : فبأيّ شيء تفتيهم؟ قال : بكتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حقّ معرفته ، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟! قال : نعم ، قال : يا أبا حنيفة لقد ادّعيت علماً ويلك ما جعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين اُنزل عليهم ، ويلك ما هو إلاّ عند الخاصّ من ذرّية نبيّنا (صلى الله عليه وآله وسلم) وما ورَّثك الله تعالى من كتابه حرفاً» .
(الصفحة187)
ورواية زيد الشحّام قال : «دخل قتادة على أبي جعفر (عليه السلام) فقال له : أنت فقيه أهل البصرة؟! فقال : هكذا يزعمون ، فقال : بلغني أنّك تفسِّر القرآن؟ قال : نعم ، إلى أن قال : يا قتادة إن كنت فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، يا قتادة ويحك إنّما يعرف القرآن من خُوطِبَ به» وغيرهما من الروايات الدالّة على هذا النحو من المضامين .
والجواب :
انّه إن كان المدّعى اختصاص معرفة القرآن حقّ معرفته ، الراجع إلى معرفة القرآن بجميع شؤونها وخصوصيّاتها من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والظاهر والباطن ، وغير ذلك من الجهات ، بالأئمّة الذين اُنزل عليهم الكتاب فهو حقّ ولكن ذلك لا ينافي حجّية الظواهر بالنحو الذي عرفت انّه محلّ البحث ومورد النزاع على سائر الناس .
وإن كان المدّعى عدم استفادة سائر الناس من القرآن ولو كلمة ، حتّى يكون القرآن بالإضافة إلى من عدى الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) من الألغاز ، وغير قابل للفهم والمعرفة بوجه ، فالدعوى ممنوعة والروايتان قاصرتان عن إثبات ذلك :
امّا الرواية الاُولى : فظاهرة في أنّ اعتراض الإمام (عليه السلام) على أبي حنيفة إنّما هو لأجل ادّعائه معرفة القرآن حقّ معرفته ، وتشخيص الناسخ من المنسوخ وغيره ممّا يتعلّق بالقرآن ، وليس معنى قوله (عليه السلام) : «وما ورّثك الله تعالى من كتابه حرفاً» انّه لا تفهم شيئاً من القرآن ولا تعرف ـ مثلاً ـ معنى قوله تعالى : {انّ الله على كلّ شيء قدير} ضرورة انّه لو كان المراد ذلك لكان لأبي حنيفة ـ مضافاً إلى وضوح بطلانه ـ الاعتراض على الإمام وإن لا يخضع لدى هذا الكلام مع أنّ الظاهر من الرواية
(الصفحة188)
خضوعه لديه وتسليمه دونه .
فالمراد منه : انّ الله تعالى قد خصّ أوصياء نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بإرث الكتاب ، وعلم القرآن بجميع خصوصيّاته ، وليس لمثل أبي حنيفة حظّ من ذلك ، ولو بالإضافة إلى حرف واحد ، فهذا القول مرجعه إلى قوله تعالى في سورة فاطر : 32 {ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} فالرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه من البحث والنزاع .
وامّا الرواية الثانية فالتوبيخ فيها إنّما هو على تصدّي قتادة لتفسير القرآن ، وقد عرفت انّ الأخذ بظاهر القرآن لا يعدّ تفسيراً أصلاً ، ولا تشمله هذه الكلمة بوجه ، وعلى تقديره فمن الواضح انّ قتادة إنّما كان يفسّر القرآن بالرأي أو الآراء غير المعتبرة ، والتوبيخ إنّما هو على مثل ذلك . وقد مرّ أنّ حمل اللفظ على ظاهره لا يكون من مصاديق التفسير بالرأي قطعاً ، وعلى فرض احتماله لابدّ للمستدلّ من الإثبات وإقامة الدليل على الشمول ، ويكفي في إبطاله مجرّد احتمال العدم ، وقد شاع وثبت انّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
ثالثها : انّ القرآن مشتمل على المعاني الشامخة ، والمطالب الغامضة ، والعلوم المتنوّعة ، والأغراض الكثيرة التي تقصر أفهام البشر عن الوصول إليها ودركها ، كيف ولا يكاد يصل افهامهم إلى درك جميع معاني «نهج البلاغة» الذي هو كلام البشر ـ ولكنّه كيف بشر ـ بل وبعض كتب العلماء الأقدمين إلاّ الشاذّ من المطّلعين ، فكيف بالكتاب المبين الذي فيه علم الأوّلين والآخرين ، وهو تنزيل من ربّ العالمين نزل به الروح الأمين على من هو سيِّد المرسلين صلّى الله عليه وآله الطيّبين المعصومين ، على مرور الأيّام وكرور الدهور ، وبقاء السماوات والأرضين .
(الصفحة189)
والجواب :
إنّ اشتمال القرآن على مثل ذلك ، وإن كان ممّا لا ينكر ، واختصاص المعرفة بذلك بأوصياء نبيّه تبعاً له ، وإن كان أيضاً كذلك ، إلاّ أنّه لا يمنع عن اعتبار خصوص الظواهر التي هي محلّ البحث ـ على ما عرفت ـ بالإضافة إلى سائر الناس ، فهذا الدليل أيضاً لا ينطبق على المدّعى .
رابعها : انّا نعلم إجمالاً بورود مخصّصات كثيرة ومقيّدات غير قليلة لعمومات الكتاب وإطلاقاته ، وكذلك نعلم إجمالاً بأنّ الظواهر التي يفهمها العارف باللغة العربية الفصيحة بعضها غير مراد قطعاً ، وحيث انّه لا تكون العمومات والإطلاقات وهذه الظواهر معلومة بعينها لفرض العلم الإجمالي ، فاللاّزم عدم جواز العمل بشيء منها قضية للعلم الإجمالي ، وحذراً عن الوقوع في مخالفة الواقع ، كالعلم الإجمالي في سائر الموارد ، بناءً على كونه منجزاً كما هو مقتضى التحقيق .
والجواب :
امّا أوّلاً : فبالنقض بالروايات ، ضرورة وجود هذا العلم الإجمالي بالإضافة إليها أيضاً ، لأنّه يعلم بورود مخصّصات كثيرة لعموماتها ، ومقيّدات متعدّدة لمطلقاتها فاللاّزم ـ بناءً عليه ـ خروج ظواهرها أيضاً عن الحجّية ، مع أنّ المستدلّ لا يقول به .
وامّا ثانياً : فبالحلّ ، بأنّ هذا العلم الإجمالي إن كان متعلّقاً بورود مخصّصات كثيرة ، ومقيّدات متعدّدة ، وقرائن متكثّرة على إرادة خلاف بعض الظواهر ووقوعها في الروايات ، بحيث لو فحصنا عنها لظفرنا بها ، فوجود هذا العلم الإجمالي وإن كان ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، إلاّ أنّه لا يمنع عن حجّية الظاهر الذي
(الصفحة190)
لم يظفر على دليل بخلافه بعد الفحص التام ، والتتبّع الكامل ، لخروجه عن دائرة العلم الإجمال حينئذ على ما هو المفروض ـ وقد عرفت أنّ محلّ البحث في باب حجّية الظواهر إنّما هو هذا القسم منها . وإن كان متعلّقاً بورودها مطلقاً ، بحيث كانت دائرة المعلوم أوسع من هذه الاُمور الواقعة في الروايات ، فنمنع وجود هذا النحو من العلم الإجمالي ، فإنّ المسلّم منه هو النحو الأوّل الذي لا ينافي حجّية الظواهر بوجه أصلاً .
خامسها : انّ الكتاب بنفسه قد منع عن العمل بالمتشابه ، فقد قال الله تعالى في سورة آل عمران 7 : {منه آيات محكمات هنّ اُمّ الكتاب واُخر متشابهات فامّا الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} .
وحمل اللفظ على ظاهره من مصاديق اتباع المتشابه ، ولا أقلّ من احتمال شموله للظاهر ، فيسقط عن الحجّية رأساً .
والجواب :
انّه إن كان المدّعى صراحة لفظ «المتشابه» في الشمول لحمل الظاهر على معناه الظاهر فيه ، بمعنى كون الظواهر من مصاديق المتشابه قطعاً ، فبطلان هذه الدعوى بمكان من الوضوح ، بداهة أنّه كيف يمكن ادّعاء كون أكثر الاستعمالات المتداولة المتعارفة في مقام إفهام الأغراض ، وإفادة المقاصد من مصاديق المتشابهات ، نظراً إلى كون دلالتها على المرادات بنحو الظهور دون الصراحة .
وإن كان المدّعى : ظهور لفظ «المتشابه» في الشمول للظواهر ، فيرد عليه ـ مضافاً إلى منع ذلك لما ذكرنا من عدم كون الظواهر لدى العرف واللغة من مصاديق المتشابه ـ انّه كيف يجوز الاستناد إلى ظاهر القرآن ، لإثبات عدم حجّية ظاهره ،
(الصفحة191)
فإنّه يلزم من فرض وجوده العدم ، ولا يلزم على القائل بحجّية الظواهر رفع اليد عن مدّعاه ، نظراً إلى ظهور الآية في المنع عن اتباع المتشابه الشامل للظواهر أيضاً ، فإنّك عرفت عدم ظهوره عنده في الشمول لغةً ولا عرفاً بوجه أصلاً .
وإن كان المدّعى : احتمال شمول «المتشابه» للظواهر ، الموجب للشكّ في الحجّية ، المساوق لعدم الحجّية رأساً ، لما تقرّر في علم الاُصول من أنّ الشكّ في حجّية المظنّة يستلزم القطع بعدمها ، وعدم ترتّب شيء من آثار الحجّية عليها .
فيرد عليه ـ مضافاً إلى منع الاحتمال أيضاً ـ انّه لو فرض تحقّق هذا الاحتمال لما كان موجباً لخروج الظواهر عن الحجّية ، بداهة انّه مع قيام السيرة القطعية العقلائية على العمل بالظواهر والتمسّك بها ، واحتجاج كلّ من الموالي والعبيد على الآخر بها لا يكون مجرّد احتمال شمول لفظ «المتشابه» للظواهر موجباً لرفع اليد عن السيرة .
بل لو كان العمل بظواهر الكتاب غير جائز لدى الشارع ، وكانت طريقته في المحاورة في الكتاب مخالفة لما عليه العقلاء في مقام المحاورات ، وإبراز المقاصد والأغراض ، لكان عليه الردع الصريح عن اعمال السيرة في مورد الكتاب ، والبيان الواضح الموجب للفرق البيّن بين الكتاب ، وبين الروايات ، وانّه لا يجوز في الأوّل الاتّكال على الظواهر دون الثاني ، ومجرّد احتمال شمول لفظ المتشابه لا يجدي في ذلك .
وبعبارة اُخرى : لو كان للكتاب من هذه الجهة الراجعة إلى مقام الافهام والإفادة خصوصية ومزيّة لدى الشارع ، مخالفة لما استمرّت عليه السيرة العقلائية في محاوراتهم ، هل يكفي في بيانه مجرّد احتمال شمول لفظ «المتشابه» الذي نهى عن
(الصفحة192)
اتّباعه ، أو انّه لابدّ من البيان الصريح ، وحيث انّ الثاني منتف ، والأوّل غير كاف قطعاً ، فلا محيص عن الذهاب إلى نفي الخصوصية وعدم ثبوت المزية ، كما هو واضح .
سادسها : وقوع التحريف بالنقيصة في الكتاب العزيز المانع عن حجّية الظواهر واتباعها ، لاحتمال كونها مقرونة بما يدلّ من القرائن على إرادة خلافها ، وقد سقطت من الكتاب ، فالتحريف الموجب لتحقّق هذا الاحتمال يستلزم المنع عن الأخذ بظواهر الكتاب كما هو ظاهر .
والجواب :
منع وقوع التحريف المدّعى في الكتاب وعدم تحقّقه بوجه . وسيأتي البحث عنه مفصّلاً في حقل مستقلّ نختتم به أبحاث الكتاب بإذن الله تعالى بعنوان : عدم تحريف الكتاب وشبهات القائلين بالتحريف .
(الصفحة193)
الأمر الثاني : قول المعصوم
لا إشكال في أنّ قول المعصوم ـ نبيّاً كان أو إماماً ـ حجّة في مقام كشف مراد الله تبارك وتعالى من ألفاظ كتابه العزيز ، وآيات قرآنه المجيد ، لما ثبت في محلّه من حجّية قوله; امّا النبي فواضح ، وامّا الإمام فلأنّه أحد الثقلين الذين اُمرنا بالتمسّك بهما ، والاعتصام بحبلهما ، فراراً عن الجهالة ، واجتناباً عن الضلالة ، فمع ثبوت قوله في مقام التفسير ، ووضوح صدوره عنه (عليه السلام) لا شبهة في لزوم الأخذ به ، وإن كان مخالفاً لظاهر الكتاب ، لأنّ قوله ـ في الحقيقة ـ بمنزلة قرينة صارفة ، ولكن ذلك مع ثبوت قوله امّا بالتواتر ، أو بالخبر المحفوف بالقرينة القطعية .
وقد وقع الإشكال والخلاف في أنّه هل يثبت قوله من طريق خبر الواحد ، الجامع للشرائط ، المعتبر في ما إذا أخبر عن المعصوم بحكم شرعي عمليّ ، لقيام الدليل القاطع على حجّيته ، واعتباره أم لا؟
ربما يقال بعدم الثبوت في مقام التفسير ، وإن كان يثبت به في مقام بيان الأحكام الفقهية ، والفروع العمليّة ، ففي الحقيقة إذا كان قوله المنقول بخبر الواحد في تفسير آية متعلّقة بالحكم يكون حجّة معتبرة ، وأمّا إذا كان مورد التفسير آية لا تتعلّق بحكم من الأحكام العمليّة ، فلا يكون خبر الواحد الحاكي له بحجّة أصلاً وذلك لأنّ معنى حجّية خبر الواحد ، وكذا كلّ أمارة ظنّية يرجع إلى وجوب ترتيب
(الصفحة194)
الآثار عليه في مقام العمل .
وبعبارة اُخرى : الحجّية عبارة عن المننجزية في صورة الموافقة ، والمعذرية في فرض المخالفة وهما ـ أي المنجزية والمعذّرية ـ لا تثبتان إلاّ في باب التكاليف المتعلّقة بالأعمال ـ فعلاً أو تركاً ـ فإذا كان مفاد الخبر حكماً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم شرعي يكون الخبر حجّة ، لاتّصافه في هذه الصورة بوصف المنجزيّة والمعذّرية ، وامّا إذا لم يكن كذلك ـ كما في المقام ـ فهذا المعنى غير متحقّق ، لعدم تعقّل هذا الوصف في غير باب الأحكام ، إذن فلا محيص عن الالتزام بعدم حجّية خبر الواحد في تفسير آية لا تتعلّق بحكم عملي أصلاً .
والتحقيق : انّه لا فرق في الحجّية والاعتبار بين القسمين ، لوجود الملاك في كلتا الصورتين .
توضيح ذلك : انّه ـ تارةً ـ يستند في باب حجّية خبر الواحد إلى بناء العقلاء واستمرار سيرتهم على ذلك ، كما هو العمدة من أدلّة الحجّية ـ على ما حقّق وثبت في محلّه ـ واُخرى إلى الأدلّة الشرعية التعبّدية من الكتاب والسنّة والإجماع ، لو فرض دلالتها على بيان حكم تعبّدي تأسيسي .
فعلى الأوّل ـ بناء العقلاء ـ لابدّ من ملاحظة انّ اعتماد العقلاء على خبر الواحد ، والاستناد إليه هل يكون في خصوص مورد يترتّب عليه أثر عملي ، أو انّهم يعاملون معه معاملة القطع في جميع ما يترتّب عليه؟ الظاهر هو الثاني فكما أنّهم إذا قطعوا بمجيء زيد من السفر يصحّ الاخبار به عندهم ، وإن لم يكن موضوعاً لأثر عملي ولم يترتّب على مجيئه ما يتعلّق بهم في مقام العمل ، لعدم الفرق من هذه الجهة بين ثبوت المجيء وعدمه ، فكذلك إذا أخبرهم ثقة واحد بمجيء زيد يصحّ
(الصفحة195)
الأخبار به عندهم ، إستناداً إلى خبر الواحد ، ويجري هذا الأمر في جميع الأمارات التي استمرّت سيرة العقلاء عليها ، فإنّ اليد ـ مثلاً ـ أمارة لديهم على ملكيّة صاحبها ، فيحكمون معها بوجودها ، كما إذا كانوا قاطعين بها ، فكما أنّهم يرتّبون آثار الملكية في مقام العمل فيشترون منه ـ مثلاً ـ فكذلك يخبرون بالملكيّة استناداً إلى اليد .
وبالجملة : إذا كان المستند في باب حجّية خبر الواحد هو بناء العقلاء ، لا يبقى فرق معه بين ما إذا أخبر عادل بأنّ المعصوم (عليه السلام) فسّر الآية الفلانية بما هو خلاف ظاهرها ، وبين نفس ظواهر الكتاب ، التي لا دليل على اعتبارها إلاّ بناء العقلاء على العمل بظواهر الكلمات ، وتشخيص المرادات من طريق الألفاظ والمكتوبات ، فكما أنّه لا مجال لدعوى اختصاص حجّية الظواهر من باب بناء العقلاء ، بما إذا كان الظاهر مشتملاً على إفادة حكم من الأحكام العملية ، بل الظواهر مطلقاً حجّة ، فكذلك لا ينبغي توهّم اختصاص اعتبار الرواية الحاكية لقول المعصوم (عليه السلام) في باب التفسير ، بما إذا كان في مقام بيان المراد من آية متعلّقة بحكم من الأحكام العملية بل الظاهر انّه لا فرق من هذه الجهة بين هذه الصورة وبين ما إذا كان في مقام بيان المراد من آية غير مرتبطة بالأحكام أصلاً ، وعليه فلا خفاء في حجّية الرواية المعتبرة في باب التفسير مطلقاً .
وعلى الثاني ـ الذي يكون المستند هي الأدلّة الشرعية التعبّدية ـ فالظاهر أيضاً عدم الاختصاص ، فإنّه ليس في شيء منها عنوان «الحجّية» وما يشابهه حتّى يفسّر بالمنجزيّة والمعذّرية الثابتتين في باب التكاليف المتعلّقة بالعمل ، فإنّ مثل مفهوم آية النبأ على تقدير ثبوته ودلالته على حجّية خبر الواحد ، إذا كان المخبر
(الصفحة196)
عادلاً يكون مرجعه إلى جواز الاستناد إليه ، وعدم لزوم التبيّن عن قوله ، والتفحّص عن صدقه ، وليس فيه ما يختصّ بباب الأعمال .
نعم لا محيص عن الالتزام بالاختصاص ، بما إذا كان له ارتباط بالشارع ، وإضافة إليه بما انّه شارع ، ولكن ذلك لا يستلزم خروج المقام ، فإنّ الاسناد إلى الله تبارك وتعالى وتشخيص مراده من الكتاب العزيز ، ولو لم يكن متعلّقاً بآية الحكم ، بل بالمواعظ والنصائح أو القصص والحكايات أو غيرهما من الشؤون التي يدلّ عليها الكتاب أمر يرتبط بالشارع لا محالة ، فيجوز الاسناد إلى الله تعالى بأنّه أخبر بعدم كون عيسى (عليه السلام) مقتولاً ، ولا مصلوباً ، وإن لم يكن لهذا الخبر ارتباط بباب التكاليف أصلاً .
وبالجملة : لا مجال للإشكال في حجّية خبر الواحد في باب التفسير مطلقاً .
نعم ، قد وقع النزاع في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ـ بعد الاتّفاق على عدم جواز نسخه به ـ على أقوال وحيث انّ المسألة محرّرة في الاُصول لا حاجة إلى التعرّض لها هنا ، مضافاً إلى أنّ القائل بالعدم فريق من علماء السنّة على اختلاف بينهم أيضاً ، وأدلّتهم على ذلك واضحة البطلان ، فراجع .
(الصفحة197)
الأمر الثالث : حكم العقل
لا إشكال في أنّ حكم العقل القطعي ، وإدراكه الجزمي من الاُمور التي هي أصول التفسير ، ويبتنى هو عليها ، فإذا حكم العقل ـ كذلك ـ بخلاف ظاهر الكتاب في مورد لا محيص عن الالتزام به ، وعدم الأخذ بذلك الظاهر ، ضرورة أنّ أساس حجّية الكتاب ، وكونه معجزة كاشفة عن صدق الآتي به ، إنّما هو العقل الحاكم بكونه معجزة خارقة للعادة البشرية ، ولم يؤت ، ولن يؤتى بمثلها ، فإنّه الرسول الباطني الذي لا مجال لمخالفة حكمه ووحيه .
ففي الحقيقة يكون حكمه بخلاف الظاهر وإدراكه الجزمي لذلك بمنزلة قرينة لفظيّة متّصلة ، موجبة للصرف عن المعنى الحقيقي ، وانعقاد الظهور في المعنى المجازي ، فإنّ الظهور الذي هو حجّة ليس المراد منه ما يختصّ بالمعنى الحقيقي ، ضرورة أنّ أصالة الحقيقة قسم من أصالة الظهور ، الجارية في جميع موارد انعقاد الظهور ، سواء كان ظهوراً في المعنى الحقيقي ـ كما فيما إذا كان اللفظ الموضوع خالياً عن القرينة على الخلاف مطلقاً ـ أو ظهوراً في المعنى المجازي ـ كما فيما إذا كان مقروناً بقرينة على خلاف المعنى الحقيقي .
فكما أنّ قوله : «رأيت أسداً» ظاهر في المعنى الحقيقي ، فكذلك قوله : «رأيت أسداً يرمي» ظاهر في المعنى المجازي ضرورة أنّ المتفاهم العرفي منه هو الرجل
(الصفحة198)
الشجاع ، من دون فرق بين أن نقول بأنّه ليس له إلاّ ظهور واحد ينعقد للجملة بعد تمامها ، نظراً إلى أنّ ظهور «أسد» في معناه الحقيقي متوقّف على تمامية الجملة ، وخلوّها عن القرينة على الخلاف .
وفي صورة وجود تلك القرينة لا ظهور له أصلاً ، بل الظهور ينعقد ابتداءً في خصوص المعنى المجازي ، أو نقول بوجود ظهورين : ظهور لفظ «الأسد» في معناه الحقيقي وظهور «يرمي» في المعنى المجازي ، غاية الأمر كون الثاني أقوى ، ولأجله يتقدّم على الظهور الأوّل ، وفي الحقيقة كلّ من اللّفظين ظاهر في معناه الحقيقي ، لكن يكون ظهور القرينة فيه ، الذي يكون معنى مجازيّاً بالإضافة إلى المعنى الأوّل أقوى وأتمّ ، فإنّه على كلا القولين تكون الجملة ظاهرة في المعنى المجازي الذي هو عبارة عن الرجل الشجاع .
وبالجملة : أصالة الظهور الراجعة إلى أصالة تطابق الإرادة الجدّية ، مع الإرادة الاستعمالية ، وكون المقصود الواقعي من الكلام هو ما يدلّ عليه ظاهر اللفظ جارية في كلا الصورتين ، من دون أن يكون هناك تفاوت في البين ، وحينئذ فإذا حكم العقل في مورد بخلاف ما هو ظاهر لفظ الكتاب يكون حكمه بمنزلة قرينة قطعية متّصلة ، موجبة لعدم انعقاد ظهور له واقعاً ، إلاّ فيما حكم به العقل .
فقوله تعالى في سورة الفجر 33 : {وجاء ربّك والملك صفّاً صفّاً} وإن كان ظهوره الابتدائي في كون الجائي هو الربّ بنفسه ، وهو يستلزم الجسميّة الممتنعة في حقّه تعالى ، إلاّ أنّ حكم العقل القطعي باستحالة ذلك ـ لاستلزام التجسّم للافتقار ، والاحتياج المنافي لوجوب الوجود ، لأنّ المتّصف به غنيّ بالذات ـ يوجب عدم انعقاد ظهور له في هذا المعنى ، وهو اتّصاف الرّب بالمجيء .
(الصفحة199)
وهكذا قوله تعالى في سورة طه 5 : {الرحمن على العرش استوى} ومثله الآيات الظاهرة على خلاف حكم العقل .
فانقدح : حكم العقل ، مع كونه من الاُمور التي هي اُصول التفسير ، ولا مجال للإغماض عنه في استكشاف مراد الله تعالى من كتابه العزيز يكون مقدّماً على الأمرين الآخرين ، ولا موقع لهما معه ، امّا تقدّمه على الظهور فلما عرفت من عدم انعقاده مع حكم العقل على الخلاف ، لأنّه بمنزلة قرينة متّصلة ، وامّا تقدّمه على الأمر الآخر ، فلأنّ حجّية قوله إنّما تنتهي إلى حكم العقل ، وتستند إليه ، فكيف يمكن أن يكون مخالفاً له ، فالمخالفة تكشف عن عدم صدوره عن المعصوم (عليه السلام) أو عدم كون ظاهر كلامه مراداً له ، فكما أنّه يصير صارفاً لظاهر الكتاب يوجب التصرّف في ظاهر الرواية بطريق أولى ، كما لا يخفى .
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الذي يبتني عليه التفسير إنّما هو خصوص الاُمور الثلاثة المتقدّمة; الظاهر ، وقول المعصوم ، وحكم العقل ، ولا يسوغ الاستناد في باب التفسير إلى شيء آخر .
نعم ، في باب الظواهر لابدّ من إحراز الصغرى ، وهي الظهور الذي مرجعه إلى الإرادة الاستعماليّة ، ضرورة أنّ التطابق بين الإرادتين لا يتحقّق بدون تشخيص الإرادة الاستعمالية ، وإحراز مدلول اللفظو ويقع الكلام ـ حينئذ ـ في طريق هذا التشخيص لمن لا يكون عارفاً بلغة العرب ، ولا يكون من أهل اللّسان ، ولا يجوز الاتّكال في ذلك على قول المفسّر ، أو اللّغوي ، مع عدم إفادة قولهما اليقين ، أو الاطمئنان الذي هو علم عرفي ، وذلك لعدم الدليل على حجّية قولهما أصلاً ، فالرجوع إلى التفسير لا يكاد يترتّب عليه فائدة إلاّ إذا حصل منه اليقين ، أو ما
(الصفحة200)
يقوم مقامه بظهور اللفظ في المعنى الفلاني ، وكونه مراداً بالإرادة الاستعماليّة ، كما هو غير خفيّ .
|