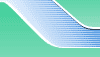والظاهر أنّه إن كان الشرط بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة ، لا دليل على الاستثناء ، فإنّ مجرّد التزام المشتري بأن يعتقه لا يخرجه عن السبيل المنفي ، ولا دليل على الخروج عن الحكم . نعم ، إذا كان بنحو شرط النتيجة يصير هذا المورد من قبيل كون المبيع ممّن ينعتق على المشتري .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا يوجد مورد يكون خروجه عن آية نفي السبيل بنحو التخصيص ، وأنّ الموارد الخارجة إنّما يكون خروجها بنحو التخصّص .
هذا تمام الكلام في قاعدة نفي السبيل .
19 ذي القعدة الحرام 1408 هـ
الصفحة 265
قاعدة الجبّ
وهي أيضاً من القواعد الفقهية التي يستند إليها في كثير من أبواب الفقه ; كقضاء الصلاة والصوم ، وأصل الحجّ والزكاة ، وبعض من أبواب الضمانات وباب الحدود والديات وغيرها ، والتكلّم فيها أيضاً في مقامات :
المقام الأوّل : في مدركها ، والعمدة في هذا المقام الحديث النبويّ المعروف الذي رواه العامّة(1) والخاصّة(2) ; وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : الإسلام يجبّ ما قبله .
ففي المحكيّ عن الطبقات لابن سعد في حكاية إسلام المغيرة بن شعبة ، أنّه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلمّا رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق ، وفرّ إلى المدينة مسلماً ، وعرض خمس أموالهم على النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فلم يقبله ، وقال : لا خير في غدر ، فخاف المغيرة على نفسه وصار يحتمل ما قرب وما بعد ،
(1) المسند لابن حنبل : 6 / 232 قطعة من ح 17792 و ص 243 ح 17829 و ص 246 ح 17844 ، دلائل النبوّة : 4 / 351 ، كنز العمال : 1 / 66 ح 243 .
(2) عوالي اللئالي : 2 / 54 ح 145 ، مستدرك الوسائل : 7 / 448 أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2 و ج 18 / 220 كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 9 ح 3 .
الصفحة 266
فقال (صلى الله عليه وآله) : الإسلام يجبّ ما قبله(1) .
وحكى مثله ابن هشام في السيرة في قصة إسلام عمرو بن العاص و خالد بن الوليد(2) .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي في تفسير قوله تعالى : {وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاَْرْضِ يَنْبُوعاً}(3) إلى آخر الآية ، قال : فإنّها نزلت في عبدالله ابن أبي اُميّة أخي اُمّ سلمة ـ رحمة الله عليها ـ وذلك أنّه قال : هذا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكّة قبل الهجرة ، فلمّا خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى فتح مكّة استقبله عبدالله بن أبي اُميّة ، فسلّم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يردّ (عليه السلام) ، فأعرض عنه ولم يجبه بشيء ، وكانت اُخته اُمّ سلمة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فدخل إليها وقال :
يا اُختي إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل إسلام الناس كلّهم وردّ عليّ إسلامي ، وليس يقبلني كما قبل غيري .
فلمّا دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على اُمّ سلمة قالت : بأبي أنت واُمّي يا رسول الله سعد بك جميع الناس إلاّ أخي من بين قريش والعرب ، رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس كلّهم .
فقال (صلى الله عليه وآله) : يا اُمّ سلمة إنّ أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذّبني أحد من الناس ، هو الذي قال لي : {وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاَْرْضِ يَنْبُوعاً} ، إلى آخر الآيات ، قالت اُمّ سلمة : بأبي أنت واُمّي يا رسول الله ألم تقل : إنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله؟ قال (صلى الله عليه وآله) : نعم ، فقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إسلامه(4) .
وفي السيرة الحلبيّة أنّ عثمان لمّا شفع في أخيه ابن أبي سرح قال (صلى الله عليه وآله) : أما بايعته
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد : 4 / 284 ـ 286 ، وذكره أبو الفرج في الأغاني : 16 / 80 ـ 82 .
(2) السيرة النبويّة لابن هشام: 3/289 ـ 291.
(3) سورة الإسراء 17 : 90 .
(4) تفسير القمّي : 2 / 26 ـ 27 .
الصفحة 267
وآمنته؟ قال : بلى ، ولكن يذكر ما جرى منه معك من القبيح ويستحي ، قال (صلى الله عليه وآله) : الإسلام يجبّ ما قبله(1) .
وفي السيرة المذكورة حكى هذا القول عنه (صلى الله عليه وآله) في إسلام هبار بن أسود(2) .
وروي ذلك في كتب اللّغة أيضاً ، ففي مجمع البحرين رواه هكذا : الإسلام يجبّ ما قبله ، والتوبة تجبّ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب(3) .
وفي البحار نقل ذلك عن عليّ (عليه السلام) ; حيث روى في ذكر قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه جاء رجل إلى عمر فقال : إنّي طلّقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى؟ فسكت عمر ، فقال له الرجل : ما تقول؟ قال : كما أنت حتى يجيء عليّ بن أبي طالب ، فجاء عليّ (عليه السلام) فقال : قصّ عليه قصّتك ، فقصّ عليه القصّة ، فقال عليّ (عليه السلام) : هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة(4) .
وبالجملة : شهرة هذا الحديث والرواية عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) توجب انجبار ضعف السند ، كما صرّح به صاحب الجواهر في كتاب الزكاة(5) ، وكذا المحقّق الهمداني (قدس سره) في ذلك الكتاب أيضاً في مقام الجواب عن صاحب المدارك لأجل تضعيفه للرواية(6)حيث قال : المناقشة في سند مثل هذه الرواية المشهورة المتسالم على العمل بها بين الأصحاب فممّا لا ينبغي الالتفات إليها ، بل وكذا في دلالتها(7) ، بل ذكر صاحب
(1) السيرة الحلبية : 3 / 36 ـ 37 .
(2) السيرة الحلبيّة : 3 / 39 .
(3) مجمع البحرين : 1 / 264 .
(4) بحار الأنوار : 40 / 230 عن مناقب آل أبي طالب (عليهم السلام) لابن شهر آشوب : 2 / 364 نقلا من شرح الأخبار : 2 / 317 ح 654 .
(5) جواهر الكلام : 15 / 62 .
(6) مدارك الأحكام: 5 / 42 .
(7) مصباح الفقيه : 13 / 93 .
الصفحة 268
العناوين : أنّ هذا الحديث من الأحاديث المسلّمة الصدور(1) .
ثمّ إنّه ربما يستدلّ لهذه القاعدة أيضاً بقوله تعالى : {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الاَْوَّلِينَ}(2) . وصرّح صاحب الجواهر في كتاب الزكاة بأنّه موافق لقوله (صلى الله عليه وآله) الإسلام يجبّ ما قبله(3) ، ويظهر منه ذلك في كتاب الصوم أيضاً(4) . واستدلّ به في كنز العرفان على عدم وجوب القضاء ; أي قضاء الصلاة على الكافر الأصلي ، واستشكل في شموله للمرتدّ ; لظهور قوله تعالى : {الَّذِينَ كَفَرُوا} في الكافر الأصلي (5) .
وحكي عن بعض مفسّري المتأخّرين من العامة(6) أنّه ذكر في ذيل هذه الآية ما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص أنّه قال بعد كلام طويل : لمّا جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقلت : ابسُط يمينك فلاُبايعك ، فبسط يمينه . قال : فقبضت يدي . قال : مالك يا عمرو؟ قال : قلت : أردت أن أشترط . قال : تشترط بماذا؟ قلت : أن يُغفر لي . قال : أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأنّ الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأنّ الحجّ يهدم ما كان قبله(7)؟ فيظهر منه أنّه جعل الرواية موافقة للآية في المفاد والدلالة .
ولكنّ الظاهر بلحاظ التعبير بالغفران في الآية انحصار مفادها بالمعاصى العملية والمخالفة الاعتقادية في الفروع والاُصول ، ولازمه عدم ترتّب أثر عليها ،
(1) العناوين : 2 / 499 .
(2) سورة الأنفال 8 : 38 .
(3) جواهر الكلام : 15 / 62 .
(4) جواهر الكلام : 17 / 10 .
(5) كنز العرفان : 1 / 241 .
(6) تفسير المنار : 9 / 664 ـ 665 .
(7) صحيح مسلم : 1 / 104 ب 54 ح 121 .
الصفحة 269
فلا يترتّب عليها الحدود والديات التي موضوعها المعصية . وأمّا دلالتها على عدم وجوب قضاء ما فات من عباداته مثل الصلاة والصوم وغيرهما ، وعلى سقوط الزكاة بالإسلام وإن كان النصاب موجوداً وأمثالهما ، فغير ظاهرة ، ولعلّه لأجل ذلك لم يستدلّ بها للقاعدة كثير من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .
وممّا يدلّ على هذه القاعدة سيرة النبيّ (صلى الله عليه وآله) ومعاملته مع من أسلم من الكفّار ، حيث إنّه لم يكلّف أحداً بقضاء العبادات التي فاتت منه في حال كفره ، وكذلك بأداء الزكاة مع أنّ العين الزكويّة كانت موجودة عندهم ، ومع ذلك لم يطلب منهم زكاة السنين التي كانوا فيها على الكفر . نعم ، لو كان حلول الحول بعد إسلامه فلا يسقط ، ويجب عليه لتعلّق التكليف بعد الإسلام به ، فالسيرة مع قطع النظر عن الرواية أيضاً دليل على القاعدة .
المقام الثاني : في مفاد القاعدة ومدلول الحديث .
فنقول : لا خفاء في أنّ الحديث وارد في مقام الامتنان على من أسلم والتحريص والترغيب إلى قبول الإسلام ، وأنّ قبوله يمنع عن بقاء آثار ما فعل أو قال أو اعتقد ، وفي الحقيقة تسهيل لطريق قبول الإسلام وتشويق إلى ما يترتّب على قبوله من الآثار والبركات ، ويظهر ذلك من ملاحظة الموارد المتقدّمة التي ورد الحديث فيها ، كقصّة إسلام المغيرة، وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد، وعبدالله ابن أبي اُميّة ، وشفاعة عثمان في أخيه من الرّضاعة ، وهبار .
وبالجملة : هذه العبارة حاكية عن منّة الإسلام وتفضّله على من يقبله ويتشرّف به ، خصوصاً بعد كثرة المعاصي العملية والاعتقادات السخيفة في الجاهلية من الشرك في العبادة ، وقتل النفس ، وارتكاب الفجور والمعاصي ، من الزنا واللّواط والسرقة وشرب الخمر وغيرها .
وبعد ذلك نقول : إنّ مفاد الحديث أنّ كلّ فعل أو قول أو تركهما ، أو اعتقاد ، إذا
الصفحة 270
كان يترتّب عليه في الإسلام ضرر أو عقوبة ، فالإسلام يوجب عدم ترتّب ذلك الضرر أو العقوبة ، وينظر بذلك بنظر العدم ويجعله كأنّه لم يتحقق ولم يصدر ، لكن هذا فيما إذا كان الضرر والعقوبة ثابتاً في الإسلام فقط ; بمعنى أنّه لو كان مسلماً ويصدر منه ذلك العمل لكان يترتّب عليه الضرر أو العقوبة ، ولكنّه حيث لا يكون في الكفر محكوماً بهذا الحكم ، فالإسلام يجبّ ويقطع ويهدم ما قبله ويجعله كأنّه لم يصدر أصلا ، فإذا تحقّق منه الزنا في حال الكفر فحيث أنّه لا يكون الزنا في الكفر محكوماً بترتّب الحدّ عليه ، فالإسلام يهدمه ويجعله كأنّه لم يتحقّق ، وهكذا .
وكذلك الترك الصادر منه في حال الكفر إذا ترتّب عليه أثر في الإسلام ، كالقضاء والكفارة ، لا يترتّب عليه الأثر بعد الإسلام ، فلا يترتّب على ترك الصلاة قضاء ، وإن كان الكافر مكلّفاً بها في حال الكفر ، بناءً على أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع أيضاً . وكذا لا يترتّب على ترك الصوم قضاء ولا كفّارة . هذا إجمال معنى الرواية .
وأمّا التفصيل بلحاظ المسائل الواقعة من الكافر في حال الكفر ، فنقول :
منها : الشرك والكفر الواقع من الكافر ، ولا ريب في أنّ الإسلام يجبّه ويفرضه كالعدم ، فلا يترتّب عليه العذاب الاُخروي ، فإذا أسلم ثمّ مات بلا فصل ، فكأنّه لم يتحقق منه الشرك ـ الذي هو ظلم عظيم ـ والكفر في مدّة حياته أصلا ، بل يلقى الله مسلماً طاهراً وإن كان زمان إسلامه بالإضافة إلى زمان كفره في غاية القلّة .
ومنها : المحرّمات الشرعية والمعاصي التي رتّب عليها الحدّ أو التعزير ، كالأمثلة المتقدمة ; فإنّه لا يترتّب عليها بعد إسلامه ، ولو زنى في السابق ألف مرّة أو سرق كذلك .
ومنها : العبادات والحقوق المختصة بالله تعالى مع عدم اعتقادهم بها في حال
الصفحة 271
الكفر ، كالصلاة والصيام بل الحجّ ، فتركها لا يترتّب عليه بعد الإسلام شيء من القضاء والكفّارة ، حتى الحج في ما إذا كان مستطيعاً حال كفره واستقرّ عليه ولم يأت به ، فصار غير مستطيع ثمّ أسلم .
نعم ، لو كانت الاستطاعة باقية بعد الإسلام فالظاهر هو الوجوب ; لتوجهه إليه بعده ، وقد استدلّ جمع من الفقهاء لسقوط القضاء بهذه القاعدة(1) ، بل يظهر من صاحب العناوين أنّ هذا القسم واضح الدخول تحت الخبر(2) ، وقد عرفت جريان السيرة النبويّة القطعية على عدم تكليف أحد من الكفّار الذين أسلموا بقضاء ما فات منه من الصلاة والصيام وغيرهما .
ومنها : حقوق الله مع اعتقادهم باشتغال الذمّة بها في كفرهم ، كما لو كان في دينهم مثلا أنّ قتل الخطأ يجب فيه عتق رقبة ، فتحقق منه القتل كذلك ثمّ أسلم ، فهل الإسلام يجبّ ذلك أيضاً؟ الظاهر هو الجبّ وعدم وجوب عتق الرّقبة عليه .
ودعوى أنّ الإسلام يجبّ ما يلزم الإنسان من جهة الإسلام ، فإذا أسلم الكافر فالشيء الذي اشتغلت ذمّته به من جهة دين الإسلام فهو يسقط عنه ، لا ما اشتغلت ذمّته بسبب آخر ، مدفوعة بأنّ اشتغال ذمّته به بعد الإسلام لابدّ وأن يكون مستنداً إلى ما كان عليه من الكفر ، والمفروض أنّه رجع عنه واعتقد خلافه الذي هو الإسلام ، ومجرّد اعتقاده في السابق لا يوجب ثبوته .
نعم ، مقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث إجمالا عدم السقوط هنا ، لأنّا ذكرنا أنّ مفاد القاعدة سقوط الآثار المترتبة في الإسلام فقط ، ولم تكن تلك الآثار ثابتة في حال الكفر ، وأمّا مع ثبوتها في حال الكفر أيضاً فالحديث لا يدلّ على سقوطها ،
(1) تذكرة الفقهاء : 2 / 349 مسألة 49 (طبع جديد) ، منتهى المطلب : 7 / 90 ، مدارك الأحكام : 6 / 201 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 182 ، كشف اللثام : 5 / 130 ، جواهر الكلام : 13 / 6 .
(2) العناوين : 2 / 496 .
الصفحة 272
كما لا يخفى .
ومنها : حقوق الله المشتركة بين الله وبين المخلوقين كالزكاة والخمس ، والظاهر شمول الحديث لها ، وقال في الجواهر في باب الزكاة : ومنه يستفاد ما صرّح به جماعة من سقوطها بالإسلام وإن كان النصاب موجوداً ; لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، المنجبر سنداً ودلالة بعمل الأصحاب ـ إلى أن قال : ـ بل يمكن القطع به بملاحظة معلوميّة عدم أمر النبيّ (صلى الله عليه وآله) لأحد ممّن تجدّد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية ، بل ربما كان ذلك منفرّاً لهم عن الإسلام ، كما أنّه لو كان شيء منه لذاع وشاع ، ثمّ قال : فمن الغريب ما في المدارك من التوقّف في هذا الحكم ; لضعف الخبر المزبور سنداً ومتناً(1) .
وقد عرفت أنّ الإشكال في الحديث من جهة السند ممّا لا مجال له أصلا(2) ، وأمّا من جهة الدلالة فلا وجه له ; لظهور شموله لهذه الموارد ، والإشكال فيها من جهات اُخرى سيأتي البحث عنه ، فانتظر .
نعم ، استشكل في السقوط في هذه الحقوق تارة : من جهة ما عرفت من مجمع البحرين من العطف على الحديث قوله : والتوبة تجبّ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب(3) ; نظراً إلى اتّحاد السياق ، وذكر الكفر في عداد المعاصي والذنوب ، مع أنّ التوبة لا أثر لها إلاّ بالإضافة إلى العقوبة ، فجبّ الإسلام أيضاً يكون بهذه الملاحظة فقط .
واُخرى : من جهة أنّ الحديث إنّما هو في مقام الامتنان ، كحديث الرفع، ودليل نفي العسر والحرج ، وهو إنّما يتمّ إذا لم يعارض بالامتنان في مورد آخر ، وفي المقام
(1) جواهر الكلام : 15 / 62 .
(2 ، 3) في ص 267 ـ 268 .
الصفحة 273
يكون الامتنان على الكافر بإسقاط الزكاة عنه معارضاً لحقّ مستحقّي الزكاة من الأصناف الثمانية المذكورة في الكتاب(1) .
وثالثة : بأنّ البعث سبب إلى العمل المبعوث إليه ، فإذا كان العمل المبعوث إليه مقيّداً بالإسلام ، وكان الإسلام مسقطاً للتكليف يلزم علّية الشيء لعدم نفسه ، وهو مستحيل .
والجواب : أنّ عطف التوبة لا يقتضي الإتّحاد بعد كونهما حكمين مستقلّين ، خصوصاً بعد ملاحظة الموارد المتقدّمة التي ورد فيها الحديث والامتنان في المقام ، حيث أنّه يرجع إلى أساس الإسلام في مقابل الكفر ، وإلى التحريض والترغيب في رفع اليد عن الكفر ، فلا يقاس بالامتنان الذي يتضمّنه جعل الزكاة للأصناف الثمانية خروجاً عن الفقر والمسكنة وغيرهما ، مع أنّه ليس بالإضافة إلى كلّ واحد من الأصناف امتناناً ، فإنّ العاملين عليها إنّما يأخذون اُجرة عملهم ، ولو لا الزكاة لكانوا يعملون في بعض الاُمور الاُخرى ، فالاشكال من هذه الجهة مندفع .
وأمّا الاستحالة ، فربما يجاب عنها بأنّ مقتضى الحديث أنّ الإسلام يكون علّة لإثبات التكاليف عليه في المستقبل فقط لا بالنسبة إلى الماضي .
ومرجع هذا الجواب إلى أنّ ما اشتهر من كون الكفّار مكلّفين بالفروع كالاُصول(2) ، إنّما هو بالنسبة إلى الكافر الذي بقي على كفره إلى آخر عمره ، وأمّا الكافر الذي أسلم فلا يكون مكلّفاً بالفروع في زمن كفره ، وهذا في غاية الضعف والوهن ; فإنّه لا دلالة لحديث الجبّ على ذلك بوجه ، بل مفاده أنّ الكافر وإن كان
(1) سورة التوبة : 9 / 60 .
(2) غنية النزوع ، بحث الاُصول : 304 ، المعتبر : 2 / 595 ، إرشاد الأذهان : 1 / 271 ، منتهى المطلب : 2 / 188 ، الحدائق الناضرة : 3 / 39 ، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : 563 ، معتمد الشيعة : 235 ، عوائد الأيّام : 279 عائدة 30 ، العناوين : 2 / 714 ، جواهر الكلام : 17 / 10 .
الصفحة 274
مكلّفاً ، إلاّ أنّ الإسلام رفع اليد عمّا سبق وجعله كالعدم ، فالتكليف كان ثابتاً ، ولكنّه رفع عنه بعد الإسلام ، كحديث الرفع(1) بالإضافة إلى الاُمور المذكورة فيه .
والحقّ في الجواب أن يقال ـ مضافاً إلى النقض بالصلاة والصيام والحجّ ، فإنّ تركها مجبوب بالإسلام ، مع أنّها لا تصحّ في حال الكفر ; لمدخليّة الإسلام في صحّتها ـ : إنّ هذه الاستحالة إنّما تتحقّق إذا كان الخطاب متوجّها إلى خصوص الكفّار ، كالخطاب المتوجّه إلى العاجز ، وأمّا لو كان الخطاب متوجّها إلى العموم من دون فرق بين المسلم والكافر ، فلا تكون صحّة هذا الخطاب متوقّفة على صحّته بالنسبة إلى كلّ واحد من المخاطبين ، ألا ترى أنّه يصحّ الخطاب إلى جماعة بخطاب واحد أن يعملوا عملا ولو مع العلم بعدم قدرة بعضهم على إيجاد العمل؟ نعم ، لو كان الجميع أو الأكثر غير قادرين لما صحّ الخطاب .
وأمّا مع عجز البعض فلا مانع منه ، مع أنّه لو إنحلّ الخطاب الواحد إلى خطابات متعدّدة لما صحّ ; لاستحالة بعث العاجز مع العلم بعجزه ، وفي المقام أيضاً كذلك ; فإنّ قوله تعالى : {أَقِيمُوا الْصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ}(2) عامّ يشمل المسلم والكافر ، ولا ينحلّ إلى خطاب خاصّ بالكافر حتى يقال بالاستحالة ; نظراً إلى علّيّة الشيء لعدم نفسه ، فالكافر مادام كافراً يكون مكلّفاً بالعبادات المذكورة ، ومن شرائط صحّتها الإسلام ، وبعد الإسلام لا يجب عليه إتيان ما فات في حال الكفر ، فتدبّر جيّداً .
ومنها : الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع اعتقادهم بثبوتها في أديانهم ، كالدّين وضمان المغصوب وضمان الإتلاف ونحو ذلك ، والظاهر أنّه لا دلالة للحديث على
(1) تقدم في ص 58 .
(2) سورة البقرة : 2 / 43 ، سورة النساء 4 : 77 ، سورة النور 24 : 56 .
الصفحة 275
سقوطها ; لما ذكرنا(1) من أنّ مفاده سقوط الآثار المترتّبة في الإسلام فقط ، وأمّا الآثار الثابتة في حال الكفر أيضاً بمقتضى الدين ، أو بمقتضى حكم العقل وقضاء ضرورته ، فلا دلالة للحديث على سقوطها ، والحقوق المذكورة من هذا القبيل ، فيلزم على الكافر الذي تجدّد إسلامه أداء ديونه والخروج عن عهدة الغصب والإتلاف ونحوها ، وظاهر الأصحاب أيضاً عدم السقوط .
ومنها : الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع عدم اعتقادهم بثبوتها في أديانهم ، كما لو لم يعتقدوا أنّ قتل العمد فيه القصاص ، أو أنّ قتل الخطأ فيه الدية على العاقلة ، فإذا أسلم الكافر وقد ارتكب القتل عمداً أو خطأً فهل يسقط القصاص أو الدية عنه في الإسلام ، أم لا؟
ظاهر كلمات الأصحاب عدم السقوط ; لإطلاقهم أنّ حقّ المخلوق لا يسقط(2) . ولكنّ الظاهر بمقتضى ما ذكرنا في مفاد الحديث إجمالا هو السقوط ; لأنّ المفروض ثبوت القصاص مثلا في الإسلام ، ولم يكن له سابقة في سائر الأديان ، وليس ثبوته بمقتضى حكم العقل والعقلاء ، وقوله تعالى : {وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ}(3) يشعر بعدم تخضّع أولي الألباب في أنفسهم لهذا الحكم الإلهي ، بل يحتاج إلى إرشاد الله تبارك وتعالى ، خلافاً لما يحكم به العقل البدوي من كون القصاص ضمّ موت إلى موت آخر ، وإعدام زائد على إعدام آخر .
وعليه : فمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله) : «الإسلام يجبّ ما قبله» ، هو السقوط ، خصوصاً في مسألة ثبوت الدية على العاقلة ، الذي لا يتطرّق إليه العقل بوجه .
نعم ، هنا إشكال ; وهو أنّ الظاهر ثبوت القصاص في النفس في الأديان
(1) في ص 271 .
(2) العناوين : 2 / 498 ـ 500 .
(3) سورة البقرة 2 : 179 .
الصفحة 276
السّابقة أيضاً ، دون القصاص في ما دون النفس ; فإنّه ثابت في الإسلام ومن أحكامه ، ومقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث عدم جبّ الإسلام ما كان ثابتاً فيه وفي الأديان السابقة ، بل يختصّ الجبّ بخصوص ما ثبت في الإسلام من الآثار والأحكام ، فاللازم حينئذ عدم رفع الإسلام للقصاص الذي هو من حقوق المخلوقين ، وكان ثابتاً عند الكافر وعلى حسب اعتقاده أيضاً ، مع أنّ الظاهر أنّه (صلى الله عليه وآله) لم يحكم بقصاص من أسلم من الكفّار القاتلين ، بل يظهر من قصّة إسلام المغيرة بن شعبة المحكيّة في الطبقات لابن سعد المتقدّمة(1) عدم حكمه (صلى الله عليه وآله) بقصاصه، مع أنّه غدر بأصحابه وقتلهم وفرّ إلى المدينة .
ودعوى أنّ عدم الحكم بالقصاص لا يكون مستنداً إلى قاعدة الجبّ ، بل مستند إلى قوله (صلى الله عليه وآله) : كلّ دم كان في الجاهلية فهو تحت قدميّ هاتين(2) ، مدفوعة باستناد النبيّ (صلى الله عليه وآله) : في قصّة المغيرة إلى أنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وهو ظاهر في دلالة القاعدة على سقوط القصاص أيضاً .
واللازم أن يقال بعدم دلالة الحديث على سقوط القصاص كما ذكرنا في معناه ، وقصّة المغيرة لا تكون معتبرة بجميع خصوصياتها ، بل حكايتها إنّما هي للاشتمال على القاعدة . وبعبارة اُخرى : حجّيتها بالإضافة إلى القاعدة المذكورة فيها لا تستلزم حجّيتها بالإضافة إلى جميع الخصوصيات الواقعة فيها ، التي منها القتل الموجب للقصاص ، كما لا يخفى .
فالحقّ أنّ سقوط القصاص كان مستنداً إلى أمر آخر ، من دون فرق بين القتل الواقع في القضايا الشخصية والموارد الجزئية ، وبين القتل الواقع في الغزوات الواقعة
(1) في ص265 ـ 266 .
(2) الكافي : 8 / 246 ح 342 ، مسند أحمد بن حنبل : 5 / 248 ح 15388 و ج 7 / 376 قطعة من ح 20720 ، سنن ابن ماجة : 3 / 504 قطعة من ح 3074 .
الصفحة 277
بين المسلمين والكفّار ، حيث لم ينقل الحكم بالقصاص في شيء منها ، بل المعلوم من عمل النبيّ (صلى الله عليه وآله) وسيرته الخلاف ، كما لا يخفى على من رجع إلى التاريخ .
ومنها : العقود والايقاعات ، كالبيع والنكاح والطلاق الصادر من الكافر حال كفره ، فإذا باع داره في تلك الحال ببيع فاقد لبعض شرائط الصحّة في الإسلام ، كما لو فرض أنّه باعه بثمن مجهول ، أو تزوّج بنكاح كذلك ، أو طلّق زوجته بطلاق كذلك ، كما إذا كان فاقداً لشرط حضور العدلين مثلا ، فمقتضى إطلاق القاعدة تماميّة تلك العقود والايقاعات بعد كون الشرائط من خصائص الإسلام ، فلا يبطل بيعه ولا نكاحه ولا طلاقه .
وما مرّ في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) من عدم الاعتبار بالتطليقة الواحدة الواقعة في حال الشرك(1) ، فهو ليس بمعنى بطلان ذلك الطلاق بالمرّة ، بل بمعنى عدم عدّه من الطلقات الثلاث المؤثّرة في الحرمة والافتقار إلى المحلّل ، وعدم كونه جزءاً للسّبب من هذه الجهة .
ثمّ إنّ معنى صحّة النكاح الواقع منه في حال كفره لا يرجع إلى صحّته ولو بالإضافة إلى ما يمكن رعايته بقاءً في حال الإسلام أيضاً ، فإذا أسلم المجوسيّ وقد نكح اُمّه أو اُخته أو بنته ، فمعنى القاعدة يرجع إلى ملاحظة هذا النكاح بالنسبة إلى ما مضى كالعدم ، وأمّا بقاءً فلا مجال لتوهّم اقتضاء القاعدة صحّة النكاح ، بحيث كان المجوسيّ المسلم باقياً على نكاح إحدى محارمه ، كما أنّه إذا أسلم الزوج الكافر دون زوجته، وقلنا بعدم صحّة هذا النكاح بقاءً أيضاً ، لا يكون مفاد القاعدة الصحّة ولو بحسب البقاء ، كما لا يخفى .
ومنها : الأسباب الواقعة في حال الكفر ; كأسباب الوضوء والغسل ، وأسباب الغسل ـ بالفتح ـ وأسباب تحريم النكاح من رضاع أو مصاهرة أو وطء في عدّة أو
(1) في ص 267 .
الصفحة 278
لذات بعل ، أو لواط بالنسبة إلى اُمّ الموطوء وبنته واُخته ، وتطليقات موجبة للتحريم حتى تنكح زوجاً غيره ، أو للتحريم المؤبّد كما لو كانت تسعاً ، فهل مقتضى القاعدة الجبّ في الجميع ، أو أنّها لا تقتضي الجبّ في شيء منها ، أو اللازم هو التفصيل؟ وجوه واحتمالات .
أمّا الوجه الأوّل : فيبتني على إطلاق القاعدة ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ القاعدة كما عرفت إنّما هي لطف ومنّة ، والغرض منها التحريص والترغيب بقبول الإسلام ورفع اليد عن الكفر(1) ، وهذا الغرض موجود في هذا المقام ، مع أنّ الشارع إذا أسقط الزكاة والخمس ـ مع ثبوت حقّ الفقراء والسّادة ـ ترغيباً وتشويقاً إلى الإسلام ، فإسقاط هذه الأسباب عن السببيّة يكون بطريق أولى ، ومع أنّ رواية البحار المتقدّمة(2) قد دلّت على عدم كون التطليقة الواحدة الواقعة في حال الشرك جزء سبب للتحريم حتى تنكح زوجاً غيره ، وللتحريم المؤبّد ، ولا فرق بينها وبين سائر الأسباب ، خصوصاً مع ذكر القاعدة الكلية قبل الحكم بعدم اعتبار التطليقة في حال الشرك ، فمن هذه الرواية يستفاد إسقاط جميع الأسباب عن السببيّة .
وأمّا الوجه الثاني : فيبتني على عدم ثبوت إطلاق معتدّ به لهذه القاعدة ، ولم يعلم العمل بها في هذه الموارد ، بل هذه الموارد تكون كالحقوق المختصّة بالمخلوقين كالديون وضمان الغصب والإتلاف وأشباهها ، ورواية البحار ضعيفة غير مجبورة حتى بالإضافة إلى صدور القاعدة من أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فلا مجال للاعتماد عليها ، فيبقى الحكم في هذه الموارد على طبق القاعدة الأوّلية المقتضية لتأثير هذه الأسباب في مسبّباتها وترتّب أحكامها عليها ، كما لا يخفى .
وأمّا التفصيل ، فيظهر من المحقق البجنوردي (قدس سره) في قواعده الفقهية ; حيث
(1) في ص 269 ـ 273 .
(2) في ص 267 .
الصفحة 279
اختار في مثل الوطء في العدّة أو لذات البعل وكذا اللواط عدم كونه سبباً لتحقّق التحريم ; لجريان القاعدة فيه ، وفي مسألة الأحداث الموجبة للغسل أو الوضوء أو التيمّم عدم جريانها ، نظراً إلى أنّ الشارع جعل الطهارة شرطاً لأشياء كالصلاة والطواف ومسّ المصحف مثلا ، وتلك الأحداث حيث لا ترتفع آثارها إلاّ بإحدى الطهارات الثلاث ، فبعد إسلامه إذا أراد إيجاد ما هو مشروط بالطهارة ، لابد وأن يتطهّر من ذلك الحدث ; لعدم إمكان امتثال ما هو مشروط بالطهارة بدونها ، ولا وجه لإجراء القاعدة هنا ; لأنّه لا أثر لها لإثبات الشرط .
كما أنّ الرضاع الحاصل في حال الكفر يوجب حصول أحد العناوين المحرّمة ; كالاُمومة والبنتيّة والاُختيّة ، ومع حصول أحد هذه العناوين لا يمكن أن يكون إسلامه رافعاً للحرمة عن اُخته الرّضاعي مثلا ، وكما أنّه لم يتوهّم أحد أنّ هذه العناوين إذا حصلت في حال الكفر عن النسب فإسلامه لا يوجب التحريم ، فكذلك الرضاع .
والسرّ في ذلك أنّ هذه العناوين إضافات تكوينيّة قد تحصّل بواسطة الولادة ، وقد تحصّل بواسطة الرضاع ، وقد جعلها الشارع موضوعاً لحرمة نكاحهنّ ، وإذا وجد الموضوع واُحرز وجوده وجداناً أو تعبّداً فيترتّب عليه الحكم قهراً(1) .
ونقول : أمّا مسألة الأحداث ، فيظهر من كثير من الفقهاء عدم ارتفاع آثارها بالإسلام ، قال الشيخ في محكيّ الخلاف : الكافر إذا تطهّر أو اغتسل عن جنابة ثمّ أسلم لم يعتدّ بهما ، وبه قال الشافعي(2) ، وقال أبو حنيفة : إنّه يعتدّ بهما(3) ، دليلنا ما بيّناه من أنّ هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نيّة القربة ، والكافر لا يصحّ منه نيّة
(1) القواعد الفقهية للمحقّق البجنوردي : 1 / 55 ـ 56 .
(2) المهذّب في فقه الشافعي : 1 / 119 ، المجموع شرح المهذّب : 2 / 171 ـ 172 .
(3) المغني لابن قدامة : 1 / 206 ، نيل الأوطار : 1 / 224 .
الصفحة 280
القربة في حال كفره ; لأنّه غير عارف بالله تعالى ، فوجب أن لا يجزئه(1) ; فإنّ التعبير بعدم الاعتداد في الصدر ، وبعدم الإجزاء في الذيل ، يدلّ على لزوم الوضوء والغسل عليه بعد الإسلام ، كما أنّ مراده بالتطهّر في الصدر هو الوضوء بقرينة اعتبار قصد القربة فيه .
وقال الشهيد الثاني في المسالك في باب غسل الجنابة : إنّه يمكن أن يقال : على هذا يحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان الإسلام في غير وقت عبادة مشروطة به ; لأنّ الوجوب من باب خطاب وضع الشرع ، ثمّ إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل إعمالا للسبب المتقدّم ، كما لو أجنب الصبيّ بالجماع ; فإنّه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة(2) .
وقال في مفتاح الكرامة في البحث عن سقوط قضاء الصلاة عن الكافر : واستثنى المحقّق الثاني في حاشيته حكم الحدث كالجنابة وحقوق الآدميّين ، قال : والمعلوم أنّ الذي يسقط ما خرج وقته(3) ، وكذلك الشهيد الثاني(4) ، وفي الذخيرة : أنّ ذلك محلّ وفاق(5) ، وكذا مجمع البرهان ، قال : إنّ حقوق الآدميّين مستثنى بالإجماع(6)(7) .
وقال صاحب الجواهر في كتاب الطهارة : فإذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده ، ويصحّ منه لموافقته للشرائط جميعها ; إذ الظاهر أنّ المراد بكونه
(1) الخلاف : 1 / 127 مسألة 70 .
(2) مسالك الأفهام 1 : 51 .
(3) حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني : 125 .
(4) روض الجنان : 2 / 948 و 961 .
(5) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : 388 .
(6) مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 236 .
(7) مفتاح الكرامة : 9 / 597 ط ج.
|