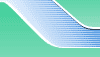(الصفحة 61)
حجّة إلى العضدي وغيره ، مع أنّ تعريف العضدي كما عرفت إنّما هو الأخذ ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد بالأخذ هو العمل كما في كثير من المقامات ; مثل الأخذ بما وافق الكتاب ، والأخذ بما خالف العامّة ، والأخذ بقول أعدلهما ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات ، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة ، ولعلّه كان هو المراد من القبول المذكور في كلام بعضهم .
ولكنّ الظاهر عدم كون النزاع لفظيّاً ; لأ نّه ـ مضافاً إلى أنّ تفسير الأخذ بالعمل مع احتمال أن يكون المراد به التعلّم أو أخذ الرسالة ممّا لا شاهد له ، وكذا تفسير القبول به ـ على تقدير تسليم ذلك لا يرجع النزاع إلى اللفظ ; لتصريح القائل بالالتزام بعدم لزوم العمل في تحقّق التقليد كما في العروة(1) . وصرّح به صاحب الفصول(2) على ما حكي ، فكيف يجتمع مع القول بأنّ التقليد هو نفس العمل ، وعدم التعرّض للخلاف لا دلالة فيه على عدم كون المسألة خلافية ، كما هو ظاهر .
مضافاً إلى أنّهم رتّبوا الثمرة على هذا النزاع وبنوا مسألة البقاء على تقليد الميّت ، وكذا مسألة العدول عن الحيّ إلى الآخر المساوي له في الفضل على الخلاف في معنى التقليد ; فإنّه وإن كان ترتّب الثمرة والابتناء محلّ نظر بل منع ـ كما سيأتي في المسألتين إن شاء الله تعالى ـ إلاّ أنّ البناء على الخلاف في معنى التقليد دليل على كون الاختلاف فيه لا ينحصر باللفظ ، بل النزاع في أمر حقيقي كما هو غير خفيّ .
الأمر الثاني : أنّه ـ بعد البناء على كون الاختلاف في مفهوم التقليد ومعناه اختلافاً معنوياً ـ يقع الكلام في تحقيق ما هو الحقّ في معناه .
(1) العروة الوثقى : 1 / 7 مسألة 8 .
(2) الفصول الغرويّة : 411 .
(الصفحة 62)
فنقول : ربما يقال كما قيل بأ نّه لا يمكن أن يكون التقليد هو نفس العمل(1) ، والأصل في ذلك ما أفاده في الفصول ، حيث قال على ما حكي : واعلم أ نّه لا يعتبر في ثبوت التقليد العمل بمقتضاه ; لأنّ العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقاً عليه ، ولئلاّ يلزم الدور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقّف على قصد القربة ، وهو يتوقّف على العلم بكونها عبادة ، فلو توقّف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دوراً(2) .
وتقريب الوجه الأوّل : أنّ كلّ مكلّف لابدّ وأن يكون عمله مستنداً إلى معذّر ، وناشئاً عنه ومسبوقاً به ، فالمجتهد يكون عمله مستنداً إلى اجتهاده واستنباطه الحكم من الحجّة المعتبرة ، والعامي يكون عمله مستنداً إلى تقليده ، فكلّ عمل إمّا أن يكون ناشئاً ومسبوقاً بالاجتهاد ، وإمّا أن يكون مستنداً إلى التقليد ، وعلى هذا الوجه اعتمد المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفاية ، حيث قال : ولا يخفى أ نّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ; ضرورة سبقه عليه وإلاّ كان بلا تقليد ، فافهم(3) .
وتقريب الوجه الثاني : أ نّه لا إشكال في أنّ مشروعيّة العمل تتوقّف على التقليد ; لأ نّه لا يتمكّن بدون التقليد من الإتيان بصلاة الجمعة مثلا بما أنّها مقرّبة ، ولا يتمشّى منه قصد القربة بدون التقليد ، فالشروع فيها بقصد كونها هي الوظيفة الثابتة بعد الزوال يوم الجمعة والعبادة المقرّبة يتوقّف على التقليد ، فلو كان التقليد متوقّفاً على العمل ومنتزعاً عنه كما هو ظاهر تفسيره به يتحقّق الدور ، فلا محيص عن الالتزام بكونه أمراً سابقاً على العمل .
(1) كفاية الاُصول: 539.
(2) الفصول الغرويّة : 411 .
(3) كفاية الاُصول : 539 .
(الصفحة 63)
والجواب عن الوجه الأوّل : أنّ غاية مقتضاه لزوم استناد العمل إلى المعذّر أو إلى العلم ، كما في عبارة الفصول المتقدّمة . وأمّا كون الأمر السابق على العمل مسمّى بالتقليد وراجعاً إليه فلم يقم عليه دليل .
وبعبارة أُخرى : لو كان هناك نصّ أو إجماع على لزوم مسبوقيّة العمل بالاجتهاد أو التقليد لكان مرجعه إلى سبق التقليد في مورد العامّي على العمل ، ولكنّه لم يقم على هذا العنوان دليل ، بل اللازم هو مسبوقيّة العمل بالحجّة والعلم ، وهو لا يلازم كون التقليد عبارة عن الأمر السابق .
ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثاني ; فإنّ توقّف مشروعيّة العمل على التقليد لم يدلّ عليه دليل ، بل المشروعيّة تتوقّف على العلم بكونها عبادة مقرّبة ، إمّا من طريق الاجتهاد ، أو من طريق فتوى المجتهد . وأمّا كون الموقوف عليه هو الذي ينطبق عليه عنوان التقليد فلا يقتضيه هذا الوجه بوجه .
فانقدح من ذلك إمكان كون التقليد عبارة عن نفس العمل ، لكنّه بمجرّده لا يكفي، بل لابدّ من إقامة الدليل على ترجيح هذا التفسير على غيره .
فنقول : إنّ هنا أُموراً مرجّحة لكون التقليد بمعنى نفس العمل :
أحدها : مناسبة التقليد بمعنى العمل للمعنى اللغوي ; فإنّ الظاهر أنّ المراد منه هو جعل القلادة في عنق الغير ، وهذا يلائم مع كونه في الاصطلاح بمعنى العمل ; فإنّ المقلّد حينئذ يجعل أعماله المستندة إلى فتوى المجتهد في عنقه ، فهي بمنزلة القلادة يقلّدها في عنق الغير وهو المجتهد .
وأمّا لو فسّر التقليد بمجرّد الالتزام والتعهّد النفساني فلابدّ من توجيه المناسبة بأنّ المقلّد بسبب الالتزام والتعهّد يجعل قلادة المتابعة للمجتهد في عنق نفسه ، وهذا لا يناسب مع المعنى اللغوي الراجع إلى جعل القلادة في عنق الغير .
(الصفحة 64)
ومن العجيب بعد ذلك ما حكي عن شيخنا الأعظم الأنصاري(قدس سره) في رسالة الاجتهاد والتقليد ; من أنّ التقليد بمعنى الالتزام أوفق بمعناه اللغوي(1) . وإن كان لايرد عليه ما اُورد من أنّ مقتضى ذلك هو صدق المقلَّد ـ بالفتح ـ على العاميّ لا على المجتهد ، مع أنّ الحديث يقول : فللعوام أن يقلّدوه(2) (3) .
وجه عدم الورود أنّ صدق المقلَّد ـ بالفتح ـ لا ينافي صدق المقلِّد ـ بالكسر ـ أيضاً ; لعدم قيام الدليل على تحقّق التقابل والتغاير بين الأمرين ، بل التقابل إنّما هو بين التقليد والاجتهاد ، والحديث إنّما يدلّ على صدق المقلَّد ـ بالفتح ـ على المجتهد لو قرئ بصيغة المبني للفاعل ، ولم يدلّ دليل عليه ، فهذا الإيراد غير وارد عليه .
نعم ، يرد عليه ما ذكرنا من عدم الملائمة بين معناه الاصطلاحي على هذا التقدير ، وبين معناه اللغوي الراجع إلى جعل القلادة في عنق الغير ، ويؤيّد ما ذكرنا أنّ صاحب الفصول بعد العبارة المتقدّمة حكى عن العلاّمة التفسير بالعمل ، ثمّ قال : هذا بيان لمعناه اللغوي كما يظهر من ذيل كلامه ، وإطلاقه على هذا شائع في العرف العام(4) ; فإنّه ظاهر في أنّ التفسير بالعمل مطابق لمعناه اللغوي ، لكنّ الذي أوجب عدوله عن التفسير المذكور استلزامه للإشكالين المتقدّمين في كلامه ، وحيث عرفت عدم الاستلزام بوجه فلا مجال للعدول عمّا يلائم المعنى اللغوي .
ثانيها : إشارة بعض الروايات إليه ; مثل ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : كان
(1) رسالة في الاجتهاد والتقليد للشيخ الأنصاري ، ضمن مجموعة رسائل : 46 ـ 47 .
(2) والمورد هو السيّد الخوئي(قدس سره) في دروس في فقه الشيعة: 1/39.
(3) يأتي في ص66.
(4) الفصول الغرويّة : 411 .
(الصفحة 65)
أبو عبدالله(عليه السلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابيّ ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه ، فلمّا سكت قال له الأعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردّ عليه شيئاً ، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابيّ : أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : هو في عنقه . قال : أو لم يقل : وكلّ مفت ضامن؟!(1)
فإنّ تعبير الأعرابي وسؤاله بقوله : «أهو في عنقك ؟» وتقريره(عليه السلام) بقوله : «هو في عنقه» ظاهر في إضافة العنق إلى المجتهد المفتي ، وهو لا يلائم إلاّ مع كون المستفتي جاعلا أعماله في عنق المفتي ، كما أنّ قوله(عليه السلام) في الذيل : «كلّ مفت ضامن» مشعر بأنّ التقليد هو العمل ; لأ نّه قبل تحقّق العمل ليس هنا شيء مستند إلى المفتي حتى يكون هو ضامناً له ، كما هو غير خفيّ .
ومثل الروايات المستفيضة الدّالّة على أنّ من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به(2) ; فإنّه وإن لم يقع التعبير بالتقليد فيها ولا دلالة فيها على انطباق عنوان التقليد على نفس العمل ، إلاّ أنّ إشعارها بل دلالتها على أ نّه ليس هنا عدا فتوى المفتي شيء سوى عمل المستفتي ممّا لا مجال للارتياب فيه ، كما هو ظاهر .
ثالثها : أ نّه لم يرد عنوان التقليد في شيء من الأدلّة الدالّة على حجّية فتوى المجتهد وجواز رجوع العامي إليه إلاّ في رواية ضعيفة طويلة محكيّة عن التفسير المنسوب إلى مولانا الإمام العسكري ـ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وعلى إبنه ـ الواردة في الفرق بين تقليد اليهود علماءهم وتقليد عوام الشيعة لعلمائهم ،
(1) الكافي : 7/409 ح1 ، تهذيب الأحكام : 6/223 ح530، وعنهما وسائل الشيعة: 27/220 ، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي ب7 ح2 .
(2) وسائل الشيعة : 27 / 20 ـ 31 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب4 .
(الصفحة 66)
المشتملة على قوله(عليه السلام) : فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه(1) . ولا يجوز الاعتماد على هذه الرواية في الحكم بوجوب الالتزام نظراً إلى أ نّه معنى التقليد ، بل اللازم ملاحظة سائر الأدلّة الواردة في هذا الباب .
فنقول :لا ينبغي الإشكال في أنّ حكم العقل بجواز التقليد إنّما هو لأجل تحقّق الامتثال بالنسبة إلى التكاليف المعلومة بالإجمال ، وكون الاستناد إلى العالم أحد الطرق ، ففي الحقيقة الواجب بحكم العقل هو الامتثال وتحقّق موافقة التكاليف ، ولا حكم له بالنظر إلى الالتزام أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .
وأمّا بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم ، فغير خفيّ أنّ سيرة العقلاء إنّما استقرّت على الرجوع العملي ، وتطبيق العمل على قول العالم العارف والالتزام القلبي سيّما مع تجرّده عن العمل الخارجي بعيد عن مقاصد العقلاء .
وأمّا الأدلّة اللفظية من الآيات والروايات ، فالنظر في مفادها والتأمّل في مدلولها ـ بناءً على دلالتها على جواز التقليد ـ يقتضي عدم كونها ناظرة إلاّ إلى مقام العمل ; فإنّ المراد من الحذر الواجب في آية النفر(2) مثلا ليس إلاّ هو الحذر في مقام العمل ، وترتيب الأثر على قول المنذر بالإتيان بما أفتى بوجوبه وترك ما حكم بحرمته .
ضرورة أنّ الحذر القلبي والالتزام النفساني لا يكون غاية للإنذار الواجب ،
(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(عليه السلام) : 299 ـ 300 ح143 ، وعنه وسائل الشية: 27/131، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب10 ح20 .
(2) سورة التوبة : 9 / 122 .
(الصفحة 67)
وكذا سائر الآيات والأدلّة على ما سيجيء(1) ; فإنّه من الواضح أنّ المراد من
الجميع هو الاستناد في مقام العمل إلى من له الحجّة وتطبيق العمل على طبق ما
يقول به .
هذا ، مضافاً إلى أ نّه أيّ فرق بين المجتهد والعامّي من هذه الجهة ، فكما أ نّه لايجب على المجتهد بعد قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا ، إلاّ الإتيان بها وتطبيق العمل على طبق الأمارة ، ولا يلزم توسيط الالتزام بوجه ، كذلك لا يجب على المقلّد بعد قيام الأمارة ـ وهي فتوى المجتهد ورأي العارف ـ إلاّ ذلك ، أي تطبيق العمل عليها والإتيان بصلاة الجمعة خارجاً ، فالتفكيك بينهما من حيث لزوم الالتزام على المقلّد ووقوعه وسطاً بين الفتوى وعمل المقلّد ممّا لا وجه له أصلا .
وإلى أنّ مورد التقليد كما عرفت هي الأحكام العمليّة التي متعلّقها نفس
العمل ، بحيث لو كانت معلومة بالتفصيل لما كان الواجب إلاّ الامتثال والعمل على طبقها ، من دون أن يكون هنا تكليف بالإضافة إلى القلب والالتزام ، فالمناسب للتقليد في خصوص هذه الأحكام مع عدم كونها ناظرة إلاّ إلى مقام العمل هو كون التقليد أيضاً راجعاً إلى نفس هذا المقام ، من دون أن يكون هنا شيء
مسمّى بالالتزام .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التقليد كما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ هو العمل مع الاستناد ، ولا مدخلية للالتزام في شيء من الأحكام .
(1) في ص71 ـ 88 .
(الصفحة 68)
في أدلّة جواز التقليد
الجهة الثالثة : فيما يدلّ على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في باب التكاليف والأحكام ، وفي هذه الجهة تارة : يبحث عمّا هو مستند العامّي في التقليد وحامل له عليه ، وبعبارة أُخرى : ما يكون محرّكاً للجاهل على أن يرجع إلى العالم بعد علمه بثبوت التكاليف إجمالا ، وأُخرى : فيما هو مقتضى الأدلّة ممّا يستنبطه المجتهد منها في هذا الباب .
أمّامن الحيثيّة الاُولى : فمن الواضح أنّ ما يمكن أن يكون مستنداً للعامي وحاملا له على التقليد ليس إلاّ حكم عقله بذلك ، قال المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفاية : إنّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيّاً جبلّياً فطرياً لا يحتاج إلى دليل ، وإلاّ لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقاً غالباً ; لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتاباً وسنّة ، ولا يجوز التقليد فيه أيضاً ، وإلاّ لدار أو تسلسل(1) .
وهذا الكلام وإن نوقش فيه بمنع كون هذا الحكم فطرياً ، نظراً إلى أنّ القضايا الفطريّة ما كانت قياساتها معها ككون الأربعة زوجاً لانقسامها إلى متساويين ، وما هو فطريّ بهذا المعنى إنّما هو كون العلم نوراً لا لزوم رفع الجهل بالعلم فضلا عن التقليد ، وبمنع كونه جبلّياً ; فإنّ ما هو جبلّي في الاصطلاح إنّما هو شوق النفس إلى كمالها لا مثل المقام(2) ، إلاّ أنّ وضوح حكم العقل بذلك وبداهة إدراكه جواز الرجوع ممّا لا تنبغي المناقشة فيه أصلا .
وأمّا من الحيثيّة الثانية : فالدليل عليه مضافاً إلى حكم العقل المذكور أُمور :
(1) كفاية الاُصول : 539 .
(2) الناقش هو المحقّق الإصفهاني في بحوث في الاُصول، الاجتهاد والتقليد: 16.
(الصفحة 69)
أحدها : بناء العقلاء على رجوع الجاهل في كلّ صنعة إلى العالم بها ، ولا إشكال في أصل ثبوت هذا البناء وتحقّق هذه السيرة المستمرّة العمليّة ، إنّما الإشكال في أنّ بناء العقلاء على شيء لا يكون بمجرّده دليلا على ذلك الشيء ، وجريانه في محيط الشرع ما لم يكن مورداً لإمضاء الشارع وتصويبه المستكشف نوعاً من عدم الردع عنه ، مع أ نّه قد يقال في المقام : إنّ بناء العقلاء على رجوع الجاهل بالأحكام الشرعيّة إلى المجتهد المستنبط والعارف بها ، وبعبارة أُخرى : بناء العقلاء على التقليد الاصطلاحي أمر حادث بعد الغيبة الكبرى ، ولم يكن ثابتاً في زمان النبيّ والائمّة ـ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ـ بوجه حتى يكون عدم الردع عنه كاشفاً عن كونه مرضيّاً للشارع ، كما هو الشأن في جميع الأُمور التي كان بناء العقلاء عليها حادثاً في الأزمنة المتأخّرة ; فإنّه لا يكون عدم ردعه دليلا على إمضائه ; لعدم ثبوته في زمانه كما هو واضح .
وأنت خبير بما في هذا الإشكال من النظر والمنع :
أمّا أوّلا : فلأنّ أصل بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم العارف في أُمورهم الدنيويّة لا يكون أمراً حادثاً في الزمان المتأخّر ; فإنّ العقلاء بما هم عقلاء لا يزال يرجع عوامهم إلى علمائهم في كلّ فنّ وصنعة ، بحيث صار هذا مرتكزاً لهم ومبنى جميع اُمورهم ، فإذا لم يردع الشارع عن إعمال هذه الطريقة ، ولم يمنع عن إجرائها في محيط الشريعة يكشف ذلك عن إمضائه وتبعيّته عن هذه السيرة ، ولا حاجة في دلالة عدم الردع على الإمضاء على إجرائها أوّلا في محيط الشرع ومصادفته مع عدم الردع .
ألا ترى أ نّه لو قيل : إنّ ظاهر الكتاب حجّة لثبوت بناء العقلاء على العمل بظواهر كلمات المتكلّمين في فهم مقاصدهم وكشف مراداتهم ، والشارع لم يردع عن
(الصفحة 70)
إعمال هذه الطريقة في الشريعة ، ليس مرجعه إلى أنّ عدم الردع قد استكشف من تحقّق العمل بظاهر الكتاب خارجاً وهو لم يردع عنه ، بل معناه أ نّه لو كانت هذه الطريقة غير مرضيّة للشارع في ألفاظ الكتاب مثلا ، لكان عليه الردع وتنبيه العقلاء المتديّنين الذين كان مقتضى بنائهم التمسّك بظاهر الكلام ، فمع عدم التنبيه يستكشف رضاه بذلك .
وأمّا ثانياً : فلأنّ الظاهر ثبوت التقليد والاجتهاد بهذا النحو في زمن الأئمّة(عليهم السلام) ، وعلى ذلك تدلّ روايات كثيرة بين ما يكون مفاده جواز الاجتهاد والاستنباط ، وبين ما يدلّ على إرجاع العوام من الناس إلى الخواصّ من الأصحاب .
فمن الطائفة الاُولى: ماحكي عن مستطرفات السرائرنقلامن كتاب(1) هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إنّماعليناأن نلقي إليكم الاُصول ، وعليكم أن تفرّعوا(2) .
ومنها : ما رواه داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب(3) .
ومنها : غير ذلك من الأخبار التي يأتي بعضها في ذكر الروايات الدالّة على جواز التقليد(4) .
ويستفاد من هذا القبيل أنّ شأن الرواة عنهم(عليهم السلام) ليس مجرّد النقل والإخبار عن القول أو الفعل أو التقرير ، بل كان فيهم الفقهاء المتصدّون للتفريع على الأُصول
(1) كذافي الوسائل،لكنّ الظاهرأنّه اشتباه،إذ رواه في مستطرفات السرائر:من جامع البزنطي عن هشام بن سالم.
(2) مستطرفات السرائر:57ح20، وعنهوسائل الشيعة:27/61، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب6 ح51.
(3) معاني الأخبار : 1 ح1 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 117 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب9 ح27 .
(4) في ص82 ـ 88 .
(الصفحة 71)
المتلقّاة عنهم ، وردّ المتشابهات إلى المحكمات; وهو حقيقة الاجتهاد والاستنباط .
وأمّا ثالثاً : فلأنّه على تقدير عدم ثبوت التقليد والاجتهاد في زمانهم(عليهم السلام)نقول : إنّ عدم الردع عن هذه الطريقة المستحدثة كاشف عن رضا الشارع بذلك .
توضيحه : أ نّه لم يكن بناء الشارع في تبليغ الأحكام وهداية الأنام إلاّ على التوسّل بالطرق العقلائية والأُمور العادية ، ولم يكن بناؤه في هذا المقام على الرجوع إلى علمه بالمغيباتوتبليغ الأحكام حسب ما يعطيه ذلك العلم، وحينئذفليس دعوانا أنّ الشارع كان عليه أن يردع عن هذه الطريقة الفعليّة لو كانت غير مرضيّة له راجعة إلى أ نّه لأجل كونه عالماً بالمغيبات لابدّ له من الردع أو الإمضاء بالنسبة إلى الأُمور المستقبلة والمتأخّرة عن زمانه ، وإذا لم يردع يكشف ذلك عن رضاه ، بل نقول :
إنّ هذه المسألة وهي مسألة الاجتهاد والاستنباط والرجوع إلى العالم بهذا النحو المعمول ممّا يقتضي طبع الأمر حدوثه في هذه الأزمنة ، بحيث لم يكن حدوثها مخفيّاً على العارفين بمسألة الإمامة وجهات ختم الوصاية ، وأ نّه يغيب الثاني عشر (عجل الله فرجه الشريف) من شموس الهداية مدّة طويلة عن أعين الناس وأنظار العامّة ، بحيث لا يكاد يمكن لهم الرجوع إليه والاستضاءة من نور الولاية ، وفي ذلك الزمان لابدّ للناس من الرجوع إلى علماء الأُمّة وأخذ الأحكام والفتاوى من فقهاء الشريعة ، ومع وضوح هذا الأمر بحسب اقتضاء الطبع وانجراره إلى ذلك يكون عدم الردع كاشفاً قطعيّاً عن إمضاء الشارع وتنفيذه لهذه الطريقة .
فانقدح من جميع ذلك أنّ التمسّك ببناء العقلاء واستمرار سيرتهم على جواز التقليد والرجوع إلى الفقيه تامّ لا ينبغي الارتياب فيه .
ثانيها : بعض الآيات التي يستفاد منها ذلك :
منها : آية النفر المعروفة ، قال الله تبارك وتعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا
(الصفحة 72)
كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَـآلـِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَ لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}(1) .
والاستدلال بهذه الآية على حجّية فتوى المجتهد وجواز رجوع العامّي إليه يتوقّف :
أوّلا : على دلالة الآية على وجوب النفر ; بأن كان مسوقاً لإفادة الوجوب وناظراً إلى جعل هذا الحكم الإلزامي ، واللزوم مستفاد من كلمة «لولا» التحضيضيّة .
وثانياً : على كون المراد من التفقّه خصوص التفقّه الاصطلاحي ، الذي مرجعه إلى استنباط الأحكام الفرعيّة العمليّة ، لا الأعمّ منه ومن التفقّه فى أُصول الدين وتعلّم الأُمور الاعتقاديّة ، وعلى لزوم التفقّه من جهة كونه غاية للنفر الواجب ، وغاية الواجب واجبة .
وثالثاً : على كون الإنذار من سنخ ما يتفقّه فيه ، وبعبارة أُخرى : صدق الإنذار على مجرّد الفتوى بالوجوب أو الحرمة ، نظراً إلى أنّ الحكم بأحدهما يستلزم التوعيد باستحقاق العقوبة على المخالفة ، وعليه : فيصدق على المجتهد عنوان المنذِر ـ بالكسر ـ لهذه الجهة .
ورابعاً : على كون المراد بالحذر هو الحذر العملي الذي مرجعه إلى العمل على طبق قول المجتهد وعلى وجوب التحذّر ، إمّا لأجل استعمال كلمة «لعلّ» الدالّة على محبوبيّة التحذّر الملازمة للوجوب شرعاً واللزوم عقلا ، أمّا الأوّل : فلعدم الفصل ، وأمّا الثاني : فلأنّ العقل يحكم باللزوم مع وجوب المقتضي ، وعدم المحبوبيّة مع
(1) سورة التوبة : 9 / 122 .
(الصفحة 73)
العدم . وإمّا لأجل كونه غاية للإنذار الواجب ، وغاية الواجب واجبة كما مرّ .
وخامساً : على ثبوت الإطلاق لوجوب التحذّر ; بأن يكون مفادها وجوب العمل على طبق قول المنذر مطلقاً; سواء أفاد قوله العلم أم لا . فإذا تمّت هذه المقدّمات يصحّ الاستدلال بالآية الشريفة على حجّية فتوى المجتهد ولزوم العمل على طبقه ، مع أنّ جلّها لولا كلّها مخدوش بل ممنوع .
أمّا المقدّمة الاُولى : فيمكن الخدشة فيها ; بأن يقال : إنّ الآية لا تكون مسوقة لإفادة وجوب النفر على طائفة من كلّ فرقة ، بل غرضها الردع عن النفر العمومي ; بأن يكون قوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً} إخباراً في مقام الإنشاء ، ويؤيّده ما ورد من أنّ القوم كانوا ينفرون كافّة للجهاد ، وبقي رسول الله(صلى الله عليه وآله) وحده ، فورد النهي عن النفر العمومي ، والأمر بنفر طائفة للجهاد(1) . ويؤيّده أيضاً ما قيل : من أنّ كلمة «النفر» في القرآن المجيد لم تستعمل في سائر الموارد إلاّ في الجهاد .
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذه المقدّمة تامّة وظاهر الآية يساعدها ، كما لا يخفى .
وأمّا المقدّمة الثانية : فممنوعة ; لعدم الدليل على اختصاص التفقّه وانحصاره بالفرعيّات ، بل الظاهر أ نّه أعمّ منه ومن التفقّه في الأُصول ، ومن المعلوم أنّ وجوب القبول تعبّداً لا يجري فى هذا القسم من التفقّه ، فتصير هذه قرينة على عدم كون الآية بصدد إيجاب القبول كذلك ، إلاّ أن يقال بأنّ إطلاق الآية يقتضي وجوب القبول تعبّداً مطلقاً ، خرج منه الأُصول وبقي الفروع .
(1) مجمع البيان : 5 / 131 .
(الصفحة 74)
ويؤيّد التعميم ما ورد في تفسير الآية من الأخبار(1) الدالّة على وجوب النفر لأجل معرفة الإمام اللاّحق إذا مات الإمام السابق ، وأنّ النافرين في عذر ما داموا في الطلب ، والمنتظرين في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم .
وأمّا المقدّمة الثالثة : فكذلك ; لعدم الدليل على كون الإنذار من سنخ ما يتفقّه فيه لو لم نقل بظهور الآية في خلافه ، نظراً إلى أ نّه لم يجعل الإنذار مترتّباً على التفقّه ، بل جعل غاية للنفر في عرض التفقّه ، ففي الحقيقة يترتّب على النفر أمران : التفقّه والإنذار في رتبة واحدة ، مضافاً إلى أنّ صدق الإنذار على مجرّد الفتوى بالحكم الوجوبي أو التحريمي من دون أن يكون مقروناً بالتوعيد والتخويف ممنوع ; فإنّه لا يصدق عنوان المنذِر ـ بالكسر ـ على الحاكم بمثل ذلك ، فضلا عن المجتهد الذي استنبط الحكم .
وأمّا المقدّمة الرابعة : فيردّها أنّ حمل الحذر في الآية على مجرّد العمل على طبق فتوى المجتهد بالإتيان بما أفتى بوجوبه ، وترك ما أفتى بتحريمه خلاف الظاهر ، بل الظاهر أ نّه عبارة عن الخوف أو الترك الناشئ عن الخوف ، فيقال للمريض الذي اجتنب عن أكل غذاء مخصوص مثلا أ نّه تحذّر عنه لأجل تركه الناشئ عن خوف إدامة المرض أو شدّته، وإلاّ فمجرّد الترك لايصدق عليه هذاالعنوان فضلا عن الفعل.
ومن المعلوم أنّ مثل هذا الأمر القلبي أمر غير اختياريّ لا يمكن أن يتعلّق به الحكم الإلزامي . نعم ، يمكن إيجاده بمقدّمات يترتّب عليها ذلك قهراً ، وليس مثل الأفعال الاختياريّة القابلة لتعلّق الإرادة بها كما لا يخفى ، ومع هذا الوصف لا يبقى مجال لاستفادة الوجوب منها .
(1) الكافي : 1 / 378 ـ 380 ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام(عليه السلام).
(الصفحة 75)
وأمّا المقدّمة الخامسة : فيردّها وضوح عدم ثبوت الإطلاق للآية من حيث وجوب الحذر ; لأنّها ليست إلاّ مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غايتيّة التحذّر مطلقاً ، فلا دلالة لها على وجوب التحذّر ولو مع عدم حصول العلم للمنذَر ـ بالفتح ـ .
بل يمكن أن يقال بظهورها في خصوص هذه الصورة ، إمّا لأجل دلالتها على وجوب الإنذار على كلّ واحد من الطائفة النافرة بالنسبة إلى جميع القوم والفرقة . وبعبارة أُخرى : يجب إنذار جميع القوم على كلّ واحد من الطائفة المتعدّدة النافرة المتفقّهة ، وفي هذه الصورة يحصل للمنذَرين ـ بالفتح ـ العلم غالباً لأجل تعدّد المنذِرين ـ بالكسر ـ ، وإمّا لِما أفاده في الكفاية(1) من أنّ وجوب الحذر إنّما هو مع إحراز أنّ الإنذار إنّما هو بما تفقّهوا فيه لا بشيء آخر موضوع أو مجعول ، فلا يجب التحذّر إلاّ مع حصول العلم ، فتدبّر .
ثمّ إنّه مع تسليم هذه المقدّمات لا يبقى مجال للإشكال على الاستدلال بالآية ; لوجوب التقليد بما أفاده بعض المحقّقين في رسالته في الاجتهاد والتقليد ، حيث قال : إن كان التفقّه موقوفاً على إعمال النظر كانت الآية دليلا على حجّية الفتوى وإلاّ فلا ، ومن الواضح صدق التفقّه في الصدر الأوّل بتحصيل العلم بالأحكام بالسماع من النبي(صلى الله عليه وآله) أو الإمام(عليه السلام) ، فلا دلالة لها حينئذ إلاّ على حجّية الخبر فقط ، والإنذار بحكاية ماسمعوه من المعصوم(عليه السلام) من بيان ترتّب العقاب على شيءفعلاأوتركاً لاينبغي الريب فيه ، بل الإفتاء والقضاء أيضاً كان في الصدر الأوّل بنقل الخبر ، فتدبّر(2) .
(1) كفاية الاُصول: 343.
(2) بحوث في الاُصول، الاجتهاد والتقليد: 18 .
(الصفحة 76)
وذلك ; لأ نّه ـ مضافاً إلى عدم كون التفقّه في الصدر الأوّل صادقاً بمجرّد السماع عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو الإمام(عليه السلام) ; لِما عرفت من وجود التفقّه بمعناه الحقيقي الملازم لإعمال النظر في الصدر الأوّل ، لمثل الرواية المتقدّمة(1) الدالّة على أنّ وظيفة أصحابهم(عليهم السلام)التفريع على الاُصول المتلقّاة عنهم، وأنّ من عرف معاني كلامهم يكون أفقه الناس ـ يردعليه: أنّ اختلاف مراتب التفقّه من حيث السهولةوالصعوبة لايوجب اختصاص الآية بخصوص المرتبة الموجودة في الصدر الأوّل ; لعدم وجود ما يدلّ عليه.
ودعوى عدم كون تلك المرتبة صادقاً عليها عنوان التفقّه ، يدفعها استعمال التفقّه في الآية الشريفة ، فمجرّد نقل الخبر إن كان مصداقاً للتفقّه فالآية غير مختصّة به ، وإن لم يكن مصداقاً له فالآية غير شاملة له ، بل لابدّ من الالتزام بوجود التفقّه الملازم لإعمال النظر في عصر النزول لئلا تكون الآية الشريفة بلا مورد، كما لايخفى.
وقد انقدح من جيمع ما ذكرنا أ نّه لا دلالة للآية على حجيّة فتوى المجتهد بالإضافة إلى المقلد ، وأنّ معناها(2) بحسب الظاهر ـ والله العالم ـ أ نّه يجب على الفقيه الإنذار والتخويف والتوعيد ليحصل للناس حالة التخوّف والتحذّر النفساني ، فيصير ذلك موجباً للقيام بما هو وظيفتهم والتعرّض لامتثال ما على عهدتهم من التكاليف الإلهيّة ، والتناسب بين الإنذار والتفقّه لأجل كون الفقيه عالماً بشؤون
(1) في ص70 .
(2) بل معناها بحسب التحقيق هو تفقّه النافرين بسبب ما يرونه في الجهاد من النصرة الإلهيّة والإمدادات الغيبيّة وقوّة الإيمان ، وإنذار القوم الذين هم الكفّار الموجودون في المدينة لعلّهم يحذرون ويدخلون في دين الله ، أو يصون الإسلام والمسلمون من شرورهم ، ويؤيّد ذلك رجوع الضمير في «ليتفقّهوا» وما بعده إلى النافرين لا المتخلّفين ; لعدم كونهم مذكورين ، وأيضاً لا يناسب الحذر بالنسبة إلى المجاهدين ، المؤلّف أدام الله ظلّه على رؤس المسلمين .
(الصفحة 77)
الإنذار وحدوده وكيفيّته وخصوصيّاته ; لأ نّه الذي يكون عارفاً بشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبالعقوبات المترتّبة على ترك الأوّل وفعل الثاني ، فالإنذار المطابق للواقع إنّما يتحقّق منه كما هو ظاهر .
ومنها : آية السؤال قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : {وَ مَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَسْـَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}(1) .
وتقريب الاستدلال بها أنّها تدلّ على وجوب السؤال على الجاهل غير العالم ، ومن المعلوم أنّ فائدة السؤال إنّما هي ترتيب الأثر على الجواب ; لأنّ السؤال بما هو لا يكون له موضوعيّة ، فإيجابه من دون وجوب العمل على طبق الجواب يكون لغواً ظاهراً ، وحيث إنّ الفقيه من المصاديق الواضحة لأهل الذكر فالآية تدلّ بإطلاقها على حجّية فتواه إذا كانت مسبوقة بالسؤال ، وفيما إذا لم تكن مسبوقة تكون فتواه أيضاً حجّة ; لعدم الفصل أو لدلالة نفس الآية ـ على ما هو المتفاهم منها عند العرف ـ على عدم دخالة سبق السؤال بوجه ، كما هو ظاهر .
واُورد على الاستدلال بها بأ نّه إنّما يتمّ لو كان الحكم فيها عامّاً شاملا لكلّ جاهل ، وكان المراد من أهل الذكر عنوانه العامّ الشامل للفقيه أيضاً ، مع أ نّه لو اقتصر النظر على ظاهرها يكون مقتضاها اختصاص الحكم بالمشركين ، حيث استغربوا أن يخصّص الله ـ تبارك وتعالى ـ رجلا بالنبوّة والسفارة ، ويحصل لبشر هذه المزيّة والفضيلة ، وعليه : فالحكم بوجوب السؤال متوجّه إليهم ويكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود والنصارى(2) .
(1) سورة الأنبياء : 21/ 7 .
(2) المورد هو المحقّق الخراساني في كفاية الاُصول: 540 ، والمحقّق الإصفهاني في بحوث في الاُصول، الاجتهاد والتقليد: 18.
(الصفحة 78)
والمعنى حينئذ أنّكم أيّها المشركون إن كنتم لا تعلمون ولا يكون إنكاركم ناشئاً عن العناد واللجاج ، بل عن الجهل وعدم الاطّلاع فاسألوا علماء اليهود والنصارى المطّلعين على الكتب السماوية المبشّرة برسالة خاتم النبيّين ، والمشتملة على ذكر الأمارات والعلائم . ولو راجعنا إلى الأخبار الواردة في تفسير الآية(1) يكون المستفاد منها أنّ أهل الذكر هم الأئمّة المعصومون ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ لا غير ، فلا مجال معها لدعوى كون الفقيه أيضاً من أهل الذكر .
وبالجملة : فالآية لا دلالة فيها على شمول الحكم لكلّ جاهل وعلى عموم أهل الذكر للفقيه ونحوه .
وقد أُجيب عن هذا الإيراد بأنّ الآية قد تضمّنت كبرى كلّيّة قد تنطبق على أهل الكتاب ، وقد تنطبق على الأئمّة(عليهم السلام) ، وقد تنطبق على العالم والفقيه حسبما تقتضيه المناسبات على اختلافها باختلاف المقامات ، فإنّ المورد إذا كان من الاعتقاديّات كالنبوّة وما يرجع إلى صفات النبيّ(صلى الله عليه وآله) فالمناسب السؤال عن علماء أهل الكتاب ، ولو كان من الأحكام الفرعيّة فالمناسب الرجوع إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة(عليهم السلام) مع التمكّن ، ومع عدمه إلى الفقهاء ، فالآية تضمّنت كبرى رجوع الجاهل إلى العالم المنطبقة على كلّ من أهل الكتاب وغيرهم(2) .
ويمكن الخدشة في هذا الجواب بأ نّه تارة يقال : إنّ الآية لا تكون بصدد تحميل تعبّديّ وإيجاب مولويّ ، بل غرضها الإرشاد إلى ما هو المرتكز عند العقلاء من رجوع الجاهل إلى العالم . واُخرى يقال : بأنّها بصدد إفادة حكم مولويّ تعبّديّ .
(1) الكافي : 1 / 210 ـ 212 ، باب أنّ أهل الذكر . . . هم الأئمّة(عليهم السلام) .
(2) المجيب هو المحقّق الاصفهاني في نهاية الدراية: 2/229، والسيّد الخوئي في مصباح الاُصول: 2 / 189 ـ190 ودروس في فقه الشيعة: 1/12 والتنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 89 ـ 90 .
(الصفحة 79)
فعلى الأوّل: يكون المتّبع هي السيرة العقلائيّة الجارية في سائر الموارد .
وعلى الثاني : الذي يبتني عليه الجواب لا مجال لدعوى أنّ الآية تتضمّن كبرى كلّيّة قد تنطبق على أهل الكتاب وعلمائهم ، وقد تنطبق على الأئمّة(عليهم السلام) ; فإنّه على تقدير كون المخاطب هم المشركين ، وأهل الذكر علماء اليهود والنصارى كيف يمكن دعوى اشتمال الآية على كبرى كلّيّة وإفادتها أمراً عامّاً ، كما أ نّه مع ملاحظة الروايات الدالّة على أنّ أهل الذكر هم خصوص الأئمة(عليهم السلام) لا مجال لدعوى عموم الحكم في الآية ، بعد فرض كونه حكماً مولويّاً تعبّدياً .
ثمّ إ نّه اُورد على الاستدلال بها أيضاً بأنّ المراد من الآية الكريمة وجوب السؤال عنهم حتى يحصل العلم للسائل من الجواب ويعمل على طبق علمه ; لأنّ تعليق وجوب السؤال على عدم العلم ظاهر في ارتفاع عدم العلم ـ الذي هو المعلّق عليه الإيجاب ـ بالسؤال والجواب عقيبه ، كما هو ظاهر(1) .
وأُجيب عنه بوجهين :
أحدهما : أنّ مثل هذا الخطاب إنّما هو لبيان الوظيفة عند عدم العلم والمعرفة في قبال العلم بالحال ، لا أ نّه مقدّمة لتحصيل العلم ، مثلا يقال: إذا لست بطبيب فراجع الطبيب في العلاج ; فإنّ المتفاهم العرفي من مثله أنّ الغاية من الأمر بالمراجعة إنّما هو العمل على طبق قول الطبيب ، لا أنّ الغاية صيرورة المريض طبيباً وعالماً بالعلاج حتى يعمل على طبق علمه ونظره(2) .
ويرد على هذا الوجه ـ مضافاً إلى أنّ المقام نظير ما يقال : «إذا كنت مريضاً
(1) المورد هو المحقّق الخراساني في كفاية الاُصول: 540.
(2) المجيب هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد: 89.
(الصفحة 80)
فراجع الطبيب» فإنّ المتفاهم العرفي من مثله أنّ الغاية من الأمر بالمراجعة هو ارتفاع المرض ، فالغاية من الأمر بمراجعة المبتلى بمرض الجهل إلى العالم هو ارتفاع مرضه ورفع جهله بالرجوع إلى العالم ، كما لا يخفى ـ : أنّ مقتضى ذلك تكرّر السؤال ولزومه ثانياً وثالثاً ، وهكذا إلى أن يحصل العلم ; لصدق عنوان الجهل ما دام عدم العلم ، فيجب عليه التكرار لحصول المعلّق ما دام المعلّق عليه متحقّقاً ، ومن الواضح خلافه ، فلا محيص من أن يقال : إنّ الغاية هو حصول العلم .
ثانيهما : ما أفاده بعض المحقّقين(قدس سره) في رسالة الاجتهاد والتقليد من أنّ الظاهر وجوب السؤال حتى يحصل له العلم بمجرّد الجواب لا بأمر زائد عليه، وهذا لا يتمّ إلاّ مع كون الجواب مفيداً للعلم تعبّداً ، وعليه : فيستفاد من الآية وجوب قبول قول المجيب وترتيب الأثر العملي عليه ; لأ نّه علم تعبّدي(1) .
ويرد عليه: أنّ الظاهر كون المراد بالعلم الحاصل بالجواب هو العلم الذي علّق وجوب السؤال على عدمه ، ومن المعلوم أنّ المراد به هو العلم الواقعي الحقيقي ، فالغاية من الأمر بالسؤال إنّما هو تحقّق هذا العلم لا علم تعبّدي ، كما هو غير خفي .
وأُورد على الاستدلال بالآية بإيراد ثالث ; وهو أنّ موردها ينافي القبول التعبّدي ; لأ نّه من الاُصول الاعتقادية التي يكون الواجب فيها تحصيل العلم(2) .
وقداعترف بورود هذاالإيراد من أجاب عن الإيراد الأوّل; بماعرفت من تضمّن الآية للكبرى الكلّيّة ، مع أنّ مقتضى ذلك الجواب عدم هذا الاعتراف ، فتأمّل .
وقد تحصَّل من جميع ما ذكرنا عدم تماميّة الاستدلال بآية السؤال أيضاً .
(1) بحوث في الاُصول، الاجتهاد و التقليد: 18.
(2) المورد هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 90.
|