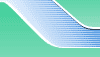الصفحة 202
مسألة 11 ـ لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب 1.
1 ـ هذه المسألة مبتنية على ما قدّمناه في العصير الزبيبي والتمري وحيث قلنا بطهارتهما وحلّيتهما فلا مجال للإشكال في جواز أكلهما في الصور المذكورة في المتن.
وامّا على تقدير القول بالنجاسة في العصيرين فلابدّ من أن يفصل في المقام بين ما إذا اختلط الزبيب أو التمر مع ما كان فيه ماء أو شبهه وصار حلواً بذلك ولو كانت حلاوته قليلة فينجس وبين غيره سواء لم يكن فيه ماء أو كان ولكن لم يصرّ حلواً بذلك أصلاً فلا تتحقّق النجاسة لعدم كونه من العصير بوجه.
كما انّه على تقدير القول بالحرمة لابدّ أن يفصل ـ في خصوص ما كان فيه ماء بين ما إذا صار جميع الماء حلواً فيحرم لصيرورته عصيراً مغلياً ـ إلاّ أن يقال بأنّ العصير الزبيبي الذي يحرم بالغليان هو الذي صار حلواً قبل الغليان لا ما يصير كذلك حاله ـ وبين ما إذا صار المقدار القليل المجاور لهما من الماء حلواً فلا يحرم ويجوز الانتفاع بالجميع لاستهلاك المقدار القليل الحرام ولكن الذي يسهل الخطب انّ العصيرين محكومان بالطهارة والحلّية فضلاً عمّا إذا اختلط الزبيب والتمر بهذا النحو.
الصفحة 203
التاسع: الفقاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً، امّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّي فقاعاً، إلاّ إذا كان مسكراً 1.
1 ـ لا ريب في نجاسة الفقاع وقد حكى ـ مستفيضاً ـ الإجماع عليها، وعن المدارك التأمّل في نجاسته حيث قال: وردت به رواية ضعيفة ، والظاهر انّ مراده منها هي رواية أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب يونس فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمّد ألا تصلّي؟ قال، فقال لي: ليس أريد أن اُصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فانّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
وهذه الرواية وإن نوقش فيها بضعف السند والإرسال إلاّ انّه يكون في المقام روايات معتبرة ظاهرة الدلالة:
كموثقة ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر. والمراد من قوله (عليه السلام) : «هو الخمر» انّه خمر تنزيلاً فيترتّب عليه جميع آثار الخمر وأحكامه التي منها النجاسة والتصريح بثبوت حدّ شارب الخمر فيه انّما هو لاحتياجه إلى التصريح به دفعاً لاستبعاد ثبوته فيه.
وموثقة عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر.
ورواية محمد بن سنان عن حسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانّه من الخمر.
وما عن حسن بن الجهم وابن فضّال قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حدّ شارب الخمر.
الصفحة 204
وهل هذه التعبيرات تدلّ على كون الفقاع خمراً واقعاً بحيث كانت الروايات بصدد بيان انّ الخمر له عنوان عام يشمل الفقاع، وعليه فلابدّ في استفادة حكمه من الرجوع إلى الأدلّة الواردة في الخمر أيضاً أو انّها تدلّ على مجرّد التنزيل منزلته حكماً؟ والحق هو الثاني لعدم كون الفقاع خمراً حقيقة ولم يسم باسم الخمر عرفاً ولغةً ومن أجله قد اتّفق أهل الخلاف على عدم حرمته مع اتّفاقهم على حرمة الخمر. مضافاً إلى انّه يستفاد ذلك من الأخبار وكلمات الأصحاب:
امّا الأخبار فقد تقدّم الكلام فيها وعرفت انّ الظاهر منها انّ الخمر اسم للمادّة المأخوذة من العنب، وفي بعضها انّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها بل حرّمها لعاقبتها وقد وردت جملة منها في منازعة آدم وابليس في شجر العنب.
وامّا كلمات الأصحاب فبعضها ظاهرة في ذلك لأنّ مقابلة المسكرات للفقاع في كلماتهم ظاهرة في انّ الفقاع بعنوانه موضوع للحكم لا للإسكار، ولا لصدق اسم الخمر عليه، ولذا لم يستدلّوا في مقابل العامّة القائلين بالحلّية بالكتاب الظاهر في حرمة الخمر مع انّه لو أمكن لاستدلّوا به بل كان هذا الاستدلال واقعاً في الروايات أيضاً، وبعضها كالصريحة في ذلك فعن الانتصار: «ممّا انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقاع وانّه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام».
ثمّ إنّه بعد عدم كونه من مصاديق الخمر حقيقة فلا محيص من حمل الروايات الدالّة على انّ الفقاع خمر أو من الخمر أو خمر استصغره الناس كما في رواية الوشاء قال: قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): حدّه ـ أي الفقاع ـ حدّ شارب الخمر وقال: هي خمرة استصغرها الناس. على نحو من التنزيل فيدور الأمر بين احتمالين:
أحدهما: البناء على التنزيل بلحاظ جميع الآثار والأحكام.
وثانيهما: التنزيل بلحاظ أظهر الخواص والآثار. ربّما يقال بأولية الثاني لأنّ
الصفحة 205
التنزيل لو لم يبين وجهه لكان ظاهراً في كونه بلحاظ الأثر الظاهر والحكم المعروف فإذا قيل: زيد أسد فهو ظاهر في كون التشبيه بلحاظ الشجاعة التي هي المعروفة في المشبه به لا سائر الجهات وهكذا في المقام فإنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «الفقاع خمر» انّه كالخمر في أظهر خواصّه وآثاره وليس ذلك إلاّ الحرمة لأنّها هي التي يدلّ عليها الكتاب وأجمع كلا الفريقين عليها، وامّا النجاسة فلا دلالة للكتاب عليها ولم يقل بها جماعة من العامّة، ولعل ما ذكرنا هو الوجه في تأمّل صاحب المدارك في النجاسة فانّ رواية أبي جميلة الظاهرة في النجاسة ـ على تقدير كون «فإذا أصاب...» من تتمّة كلام الإمام (عليه السلام) كما هو الظاهر لا من كلام يونس ـ لا تكون معتبرة سنداً والروايات المعتبرة فاقدة للظهور من حيث الدلالة لاحتمال كون التنزيل في خصوص الحرمة لو لم يكن ظاهراً في ذلك.
والإنصاف انّه ولو سلم كون التنزيل بلحاظ خصوص الأثر الظاهر لكن نقول إنّ النجاسة مثل الحرمة في كونه أثراً ظاهراً بحسب المذهب وتشتركان في الاتّصاف بالأظهرية وإن كانت مرتبة الظهور مختلفة. نعم غيرهما من الآثار يحتاج ثبوته إلى التصريح ولذا عرفت انّه لو لم يقع التصريح بثبوت حدّ شرب الخمر فيه لم يكن يستفاد ذلك من التنزيل بمجرّده لعدم كون الحدّ أثراً ظاهراً وبالجملة الظاهر هو ما استفاده الأصحاب من الروايات من دلالتها على التنزيل في النجاسة أيضاً.
وهل يفصل في الحكم بنجاسة الفقاع بين ما إذا تحقّق الغليان له وبين ما إذا لم يتحقّق؟ يظهر من كلمات بعض أهل اللغة انّه لا يصدق ما لم يتحقّق الغليان، فعن القاموس: «الفقاع كرمان الذي يشرب سمّي به لما يرتفع في رأسه من الزبد» ونحوه ما عن «المجمع» وعن الشهيد أيضاً اعتبار الغليان في الصدق، وعليه فلا إشكال في اختصاص الحكم بالحرمة والنجاسة بما بعد الغليان.
الصفحة 206
ولو فرض صدقه مطلقاً فظاهر بعض الأخبار التفصيل بين الصورتين كصحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلى. والظاهر انّ ابن أبي عمير كان بصدد دفع توهّم عمل الفقاع الحرام.
وموثّقة عثمان بن عيسى قال: كتب عبدالله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : إن رأيت أن تفسّر لي الفقاع فانّه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب (عليه السلام) : لا تقرب الفقاع إلاّ ما لم يضرّ آنيته أو كان جديداً. فأعاد الكتاب إليه: كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حدّ الضرارة والجديد وسُئل أن يفسّر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني. فكتب (عليه السلام) : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثمّ لا يعدّ منه بعد ثلاث عملات إلاّ في إناء جديد والخشب مثل ذلك.
والظاهر انّ النهي عن هذه الظروف انّما هو لأجل حصول النشيش والغليان له إذ نبذ فيها، ويمكن أن يكون لأجل حصول الإسكار له فيها إلاّ انّه مجرّد احتمال لا يمكن رفع اليد به عن إطلاق الأدلّة وشمولها للمسكر منه وغيره مع جعل الفقهاء إيّاه في مقابل المسكرات عنواناً مستقلاًّ ونجساً على حدة، وتصريح بعض أهل اللغة بأنّه ليس بمسكر أصلاً فالحرمة والنجاسة فيه كل واحدة مشروطة بالغليان فقد دون الإسكار، وعدم تفصيل الفقهاء بين الحالتين لعلّه لعدم كونه فقاعاً عندهم قبل الغليان والله أعلم.
ثمّ إنّه وقع الاختلاف بينهم ـ بعد الاتفاق على كون المتّخذ من الشعير على وجه مخصوص فقاعاً ـ في اختصاص عنوان الفقاع بذلك وعدمه، والأوّل محكي عن
الصفحة 207
علم الهدى (قدس سره) قال في الانتصار: «قد روى أصحاب الحديث من طرق معروفة انّ قوماً من العرب سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشراب المتّخذ من القم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يسكر؟ قالوا: نعم، فقال: لا تقربوه ولم يسئل عن الشراب المتّخذ من الشعير عن الإسكار بل حرم ذلك على الإطلاق».
ويظهر من المحكي عن الشهيد (قدس سره) انّ الفقاع كان يعمل في السابق من ماء الشعير، وفي زمانه (قدس سره) قد يعمل من الزبيب أيضاً. وعن «مخزن الأدوية» انّه يعمل من أكثر الحبوبات ومن العسل والخبز.
والحاصل: انّه مفهوم مردّد بين خصوص ما يعمل من ماء الشعير وبين ما يعمّ ذلك وما يتّخذ من غيره والمرجع ـ حينئذ ـ البراءة عن لزوم الاجتناب عن غير ما هو القدر المتيقّن منه وقاعدتا الطهارة والحلّية ـ كما هو الحال في جميع الموارد التي يدور الأمر فيها بين الأقلّ والأكثر ـ .
ودعوى استعمال الفقاع في غير ما يتّخذ من ماء الشعير أيضاً فيدور الأمر بين كونه حقيقة فيه أيضاً أو مجازاً أو منقولاً والأصل عدم النقل وعدم تحقّق المجاز.
مدفوعة: بأنّ تقديم الاشتراك على المجاز أو العكس أو تقديمه على النقل أو النقل عليهما وكذا ما يشابه ذلك من الترجيحات المشهورة المذكورة في الكتب الاُصولية سيّما القديمة منها ممّا لا يرجع إلى محصل ولم يدل عليه دليل كما اعترف به المحقّق الخراساني (قدس سره) في مباحث الألفاظ من «الكفاية» مع انّ هذه الاُصول لا تكون شرعية بوجه ولا عقلائية. نعم أصالة عدم النقل من الاُصول العقلائية لكن لا يلتزم العقلاء بمثبتاتها ولا يتمسّكون بها في جميع الموارد كما لا يخفى.
ثمّ إنّه قد انقدح ممّا ذكرنا انّ المتّخذ من الشعير على وجه مخصوص الذي يسمّى بالفقاع يكون حراماً وإن لم يكن مسكراً فلا فرق بين ثبوت السكر الخفيف فيه كما
الصفحة 208
ربّما يقال وعدمه، كما انّه ظهر انّ المتّخذ من غير ماء الشعير ليس بحرام ولا نجس إلاّ إذا كان مسكراً لعدم ظهور إطلاق عنوان الفقاع عليه، وامّا ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم فهو ليس من الفقاع بل طاهر وحلال فانّ الفقاع هو المتّخذ من ماء الشعير على وجه مخصوص يعرفه أهله ولا يكون كلّ ماء الشعير فقاعاً.
الصفحة 209
العاشر: الكافر: وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي، الحربي والذمّي، وامّا النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة، وامّا الغالي فإن كان غلوّه مستلزماً لإنكار الإلوهية أو التوحيد أو النبوّة فهو كافر وإلاّ فلا 1 .
1 ـ الكلام في هذا النوع يقع في مقامات:
المقام الأوّل: هل الكافر في الجملة نجس أم لا؟ وبعبارة اُخرى هل يكون الكافر نوعاً من أنواع النجاسات في مقابل الأنواع الاُخر أم لا؟ ونقول: إنّ الحكم بنجاسة الكفّار ـ في الجملة ـ ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، وهو ممّا انفردت به الإمامية ـ كما قال به السيّد المرتضى ـ ، ومن شعار الشيعة بحيث إنّ جميع الشيعة يعرفون انّ هذا مذهبهم ـ كما عن حاشية المدارك ـ ، وممّا انعقد عليه إجماع الشيعة ـ كما عن صريح المنتهى وظاهر التذكرة ـ وعليه إجماع المسلمين المفسّر بالمؤمنين ـ كما عن التهذيب ـ وبالجملة لا يرى مخالف في المسألة من الإمامية.
نعم ذهب العامّة إلى طهارتهم ولم يلتزم بنجاسته منهم إلاّ القليل كالفخر الرازي فانّه نقل عن صاحب الكشّاف عن ابن عبّاس ان أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير ثمّ نقل اتّفاق الفقهاء على الطهارة ثمّ قال ظاهر القرآن يدلّ على كونهم أنجاساً فلا يرجع عنه إلاّ بدليل منفصل ولا يمكن ادّعاء الإجماع فيه لما بيّنا انّ الاختلاف فيه حاصل.
وكيف كان يدلّ على نجاسته ـ في الجملة ـ بعد الإجماع بل ضرورة المذهب، من
الصفحة 210
الكتاب، الآية الكريمة: (انّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)(1) الآية. وقد وقعت هذه الآية الكريمة مورد التنازع بين الأصحاب من جهة انّ المراد من المشركين فيها هل هو جميع المشركين، أو صنف مخصوص منهم، ومن جهة انّها هل تدلّ على نجاستهم بالنجاسة المصطلحة عند المتشرّعة أم لا، وبعبارة اُخرى هل المراد من النجس ـ بالفتح ـ هو النجس ـ بالكسر ـ الاصطلاحي أو يكون بينهما فرق؟
والتحقيق في هذه الجهة الأخيرة ثبوت الفرق بينهما فانّ النجس ـ بالكسر ـ صفة مشبهة كالقذر ـ بالكسر ـ ويقوم مقام اسم الفاعل بخلاف النجس ـ بالفتح ـ فانّ الظاهر انّه اسم المصدر وعنوانه عنوان المصدر كالنجاسة، وإذا حمل على ذات فهو من باب حمل المعنى على الذات ويشعر بالمبالغة نحو زيد عدل.
فانّه يدلّ على انّ زيداً متمحّض في العدالة ولا مغايرة بينه وبينها وهذا واضح لا كلام فيه.
انّما الكلام في انّه هل للشارع في النجس ـ بالفتح ـ اصطلاح مخصوص وله معنى عنده غير معناه الحقيقي بأن يكون له حقيقة شرعية مغايرة للمعنى اللغوي والعرفي أم لا؟
والإنصاف: انّه لا دليل لنا على إثبات هذا المطلب ومن البعيد أن يكون للشارع في النجاسة والقذارة اصطلاح خاص مغاير للمعنى المقصود لدى العرف لا سيّما مع ملاحظة انّه لم تستعمل هذه المادّة في الكتاب الكريم إلاّ في هذه الآية الشريفة فانّه كيف يتحقّق مع استعماله دفعة واحدة وكيف يثبت الاصطلاح بمثل ذلك، فمعنى
1 ـ التوبة : 28 .
الصفحة 211
النجاسة والقذارة في كلمات الشارع ـ خصوصاً في القرآن الكريم ـ ليس إلاّ المعنى العرفي لهما وهو الأمر المستكره عند العقلاء ومورد التنفّر بينهم، نعم لا تنبغي المناقشة في انّه قد تصرّف الشارع في بعض المصاديق بالتوسعة والتضييق فأدخل بعض ما ليس في نظر أهل العرف قذراً في النجاسات والقذارات كالمشرك والخمر والخنزير ونحوها وإخراج بعض ما كان بنظر العرف قذراً عنهما كالنخامة والوذي ونحوهما.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ حمل النجس ـ بالفتح ـ الذي يكون بمعنى النجاسة على المشركين يفيد انّ المشركين لا يكون لهم شأن وحقيقة إلاّ النجاسة بالمعنى المصدري وحيث إنّ النجاسة في كلام الشارع تكون بالمعنى العرفي لها على ما مرّ، والعرف لا يفهم من النجاسة إلاّ الظاهرية منها فتدلّ الآية الكريمة على انّ المشركين نجس بالنجاسة الظاهرية ولا يناسب كونهم نجاسة مع كونهم طاهراً ظاهراً ونجساً باطناً كما هو شأن المشرك من حيث كونه مشركاً.
وبهذا يندفع ما قد يقال من انّ الآية تدلّ على انّ المشركين نجس معنى وقذر باطناً لا يصلح قربهم إلى المسجد الحرام الذي هو محل العبادة الخالصة لله تعالى فانّ الشرك لا يلائم العبادة الخالصة، فانّه من بشاعة القول أن يقال: إنّ الكافر ليس إلاّ عين النجاسة والقذارة لكنّه طاهر ونظيف في ظاهره كسائر الأعيان الطاهرة.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا انّ الآية الكريمة تدلّ على نجاسة المشركين بالنجاسة الظاهرية العرفية فلابدّ وأن لا يقربوا المسجد الحرام لعدم مناسبة الموجود النجس القذر مع البيت الحرام والمسجد الحرام الذي لابدّ وأن يكون طاهراً كما إذا قيل: إنّ الكلب نجس فلا يقرب المسجد.
وقد يستدلّ على نجاسة الكافر بقوله تعالى: (كذلك يجعل الله الرجس على
الصفحة 212
الذين لا يؤمنون)(1) بتقريب انّ الرجس فيها بمعنى النجاسة.
ولكنّه يرد عليه انّ الرجس في هذه الآية كسائر الموارد التي استعمل فيها في الكتاب يكون بمعنى القذارة الباطنية التي يعبّر عنها في الفارسية بـ «پليدى» والإجماع المدّعى على كونه في الآية بمعنى النجاسة غير حجّة لأنّه لا معنى لحجّية الإجماع في اللغة إلاّ أن يرجع إلى الإجماع في الحكم.
المقام الثاني: في أنّه هل الكافر نجس بجميع أقسامه فيشمل الحكم بالنجاسة أهل الكتاب أيضاً كما هو ظاهر المتن أم لا؟ ولابدّ من النظر ـ أوّلاًـ في الآية الكريمة المذكورة، و ـ ثانياً ـ إلى الأقوال الواردة من أصحابنا الإمامية في أهل الكتاب، و ـ ثالثاً ـ في الروايات الكثيرة المختلفة الواردة في أهل الكتاب بعمومهم أو بعض أقسامهم فنقول:
امّا الآية الكريمة فيبحث فيها في هذا المقام من جهتين:
الاُولى: في كلمة «انّما» التي هي من أداة الحصر وان مفادها في الآية الشريفة هل هو حصر المشركين في النجاسة وانّه ليس لهم شأن ولا حقيقة سوى النجاسة فلا ينافي نجاسة غيرهم أيضاً، أو انّ مفادها حصر النجاسة في المشركين وانّه ليس غير المشرك نجساً فتصير الآية دليلاً على طهارة غير المشركين؟
الظاهر هو الأوّل وانّ سياق الآية يعطي كونها في مقام بيان حصر المشركين في النجاسة ولذا فرع عليه قوله: «فلا يقربوا المسجد الحرام...» وبعبارة اُخرى الظاهر كون الآية في مقام بيان حال المشركين ووصفهم وهذا لا يلائم إلاّ مع كون الحصر على النحو الأوّل ضرورة انّه على النحو الثاني لابدّ من الالتزام بكونها مسوقة
1 ـ الأنعام : 125 .
الصفحة 213
لإفادة نفي نجاسة غير المشرك ـ كما هو شأن الحصر على هذا النحو ـ وهو لا يلائم ظاهر الآية أصلاً، مع انّه يمكن أن يقال بأنّ الحصر على النحو الثاني لا دلالة له على عدم كون غير المشرك نجساً ـ بالكسر ـ فانّ مقتضى الآية على هذا التقرير حصر النجس ـ بالفتح ـ الذي هو بمعنى النجاسة في المشرك فلا يكون غيره نجساً ـ بالفتح ـ وهذا لا ينافي أن يكون نجساً ـ بالكسر ـ لأنّ النجاسة لها مراتب ومن الممكن أن تكون المرتبة الكاملة من النجاسة ثابتة للمشرك بحيث يصحّ أن يقال إنّه نجاسة، وامّا غيره من فرق الكفّار فلا يكون لها هذه المرتبة بل المرتبة المتوسطة أو الضعيفة ولا ينطبق عليه النجاسة بل يطلق عليهالنجس ـ بالكسر ـ فتأمّل.
الثانية: في المراد من المشركين في الآية الكريمة وانّه هل يكون للمشرك معنى وسيع يشمل أهل الكتاب أيضاً فنقول:
المشرك في الحقيقة من يعتقد بثبوت الشريك لله تعالى امّا في الذات ووجوب الوجود وامّا في الفعل، وامّا في العبادة والخضوع لديه كالمشركين الذين كانوا يعيشون في عصر البعثة وزمان نزول الوحي والقرآن الكريم فانّهم كانوا يعتقدون بأنّ الله خالق السماوات والأرضين لقوله تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنَّ الله)(1) ومع ذلك كانوا يعبدون غير الله من الأصنام والآلهة ليقرّبوهم إلى الله زلفى قال الله تعالى ـ حكاية عنهم ـ : (ما نعبدهم إلاّ ليقرّبونا إلى الله زلفى)(2) ومن المعلوم انّ اليهود والنصارى ليسا بما هم كذلك بمشركين.
نعم قد يقال إنّ مقتضى بعض الآيات الواردة فيهم انّهم من المشركين وعليه
1 ـ لقمان : 25 .
2 ـ الزمر : 3 .
الصفحة 214
فتشملهم الآية الدالّة على نجاستهم كقوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ـ إلى قوله سبحانه ـ وما اُمروا إلاّ ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلاّ هو سبحانه عمّا يشركون)(1).
وفيه: انّ قوله تعالى: (سبحانه عمّا يشركون) قد وقع عقيب قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما اُمروا)الآية والمراد من اتخاذهم أرباباً ليس ما هو ظاهره لعدم قولهم بإلوهيتهم لما روى عن الثعلبي عن عدي بن حاتم في حديث قال: انتهيت إليه ـ يعني إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)ـ وهو يقرأ سورة البراءة هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية حتّى فرغ منها فقلت له: لسنا نعبدهم؟ فقال: أليس يحرِّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه ويحلّون ما حرّم الله فتستحلّونه؟ قال: قلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم. فانّ المستفاد من الرواية انّ إطلاق المشرك على النصارى انّما كان بنحو من العناية والتسامح لا بنحو الحقيقة فانّ تبعيتهم في التحليل والتحريم لا تكون عبادتهم حقيقة فلا يتحقّق الشرك في العبادة كذلك. ومن المعلوم انّ المراد من المشركين في الآية الكريمة ـ التي هي محلّ البحث ـ هو المشركون بالمعنى الحقيقي فلا تشمل الآية من يطلق عليه المشرك مجازاً ومسامحة.
مع انّ النصارى ـ على ما يستفاد من الآيات الواردة فيهم ـ طوائف مختلفة، قال الله تعالى مخاطباً لعيسى: (ءأنت قلت للناس اتخذوني واُمّي من دون الله)(2)وقال تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة)(3) وقال: (لقد كفر الذين
1 ـ البراءة : 31 .
2 ـ المائدة : 116 .
3 ـ المائدة : 73 .
الصفحة 215
قالوا انّ الله هو المسيح بن مريم)(1) وغير ذلك من الآيات الواردة فيهم ولا يمكن لنا إثبات الشرك لجميع طوائفهم ولا إثباته أيضاً لليهود مطلقاً وإن كان اليهود والنصارى بأجمعهم كفّاراً قاتلهم الله أنّى يؤفكون.
مضافاً إلى انّ محطّ النظر في آية (انّما المشركون نجس) انّما هو المشركون في ذلك العصر لا اليهود والنصارى وبعبارة اُخرى: عنوان «المشرك» في الآية عنوان مشير إلى المشركين المعاصرين للنبي (صلى الله عليه وآله) الواقعين في مقابل اليهود والنصارى وإن كان الحكم ثابتاً لمن كان مشركاً اصطلاحياً ولو لم يكن في ذلك العصر.
أضف إلى ذلك كلّه انّ توجّه اليهود والنصارى وقربهم إلى المسجد الحرام والكعبة المعظّمة ودخولهم فيهما غير معلوم بل مظنون العدم وعليه فلا وجه لشمول الآية لهم لأنّها مسوقة لبيان حكم المشركين الذين كانوا يتوجّهون إلى المسجد الحرام كما هو مقتضى قوله تعالى: (فلا يقربوا المسجد الحرام).
وقد انقدح من جميع ذلك انّ الآية الكريمة الدالّة على نجاسة المشركين لا تشمل اليهود والنصارى بما هم كذلك، نعم يشمل المشركين منهم في إحدى الجهات المتقدّمة.
هذا بالنظر إلى الآية الكريمة.
وامّا بالنظر إلى أقوال علمائنا الإمامية ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ فلم يقل بطهارة أهل الكتاب منهم إلاّ القليل، والنجاسة هي المشهورة بين المتقدّمين والمتأخّرين بل لعلّها تعدّ من الاُمور الواضحة عندهم حتّى ألحقها بعضهم بالبديهيات، وقال بعضهم إنّ نجاسة الكفّار بأجمعهم من شعار الشيعة أو من
1 ـ المائدة : 72 .
الصفحة 216
متفرّدات الإمامية.
نعم قد نسب إلى جمع من الأصحاب كابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ والمفيد ـ من المتقدّمين ـ ، وصاحب المدارك والمحدِّث الكاشاني ـ من المتأخّرين ـ القول بطهارة أهل الكتاب، وفي النسبة نظر:
امّا ابن الجنيد فلم يعلم منه ذلك والعبارة المنقولة عنه غير ظاهرة في المخالفة للمشهور.
وامّا ابن أبي عقيل فانّه قد خصّص عدم النجاسة باسئارهم ولعل نظره إلى عدم انفعال الماء القليل وعدم تأثّره بالملاقاة كما هو اعتقاده فيه.
وامّا ما نسب إلى نهاية الشيخ (قدس سره) ففي غير محلّه قطعاً قال فيها: «ولا تجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم، ولا استعمال آنيتهم إلاّ بعد غسلها بالماء وكلّ طعام تولاّه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله لأنّهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه إلى أن قال: ويكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفّار إلى طعامه فيأكل منه وان دعاه فليأمر بغسل يديه».
وهذا الكلام كما ترى أوّله صريح في نجاسة الكفّار على اختلاف مللهم، وامّا آخره فانّه وإن كان موهماً للخلاف إلاّ انّه لابدّ من التأويل والحمل على الطعام اليابس كالّتمر والخبز ونحوهما والأمر بغسل اليد لدفع القذارة العرفيّة فتأمّل.
وامّا المفيد (قدس سره) فانّه قال: تكره الاستفادة عن سؤر اليهود والنصارى. ولعلّه أراد بالكراهة معناها اللغوي الذي يلائم مع الحرمة أيضاً هو الاستقذار.
وامّا صاحب المدارك فلا يستفاد من مداركه هذا القول أصلاً.
وامّا المحدِّث الكاشاني فمخالفته مع المشهور في «المفاتيح» غير معلومة بل الوحيد البهبهاني (قدس سره) قال في شرح المفاتيح: إنّ نجاسة أهل الكتاب من شعار الشيعة
الصفحة 217
وامتيازاتهم، نعم يظهر ذلك عن كتاب «الوافي» له فانّه بعد ذكر الأخبار الواردة في الباب قال ـ على ما حكى عنه ـ : «وقد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي، والتطهير من مسّهم ممّا لا ينبغي تركه» وفيه إشعار على رجحان التطهير منه لا اللزوم والوجوب.
وامّا الأخبار الواردة فما يمكن أن يستدلّ به على النجاسة منها تكون على طوائف:
الطائفة الاُولى: ما ورد في النهي عن مصافحتهم والأمر بغسل اليد إن صافحهم وهي كثيرة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً، فقال: يغسل يده ولا يتوضّأ. فإنّ الظاهر انّ الأمر بغسل اليد انّما هو لأجل سراية النجاسة الحاصلة بالمصافحة.
وفيه: انّه لا محيص من التصرّف في الرواية امّا بإضافة قيد الرطوبة في المصافحة أي صافح رجلاً مجوسياً مع الرطوبة ـ أي رطوبة يده أو يد المجوسي ـ ضرورة انّ المصافحة مع المجوسي مع عدم رطوبة اليد لا توجب النجاسة وإن كان المجوسي نجساً، وامّا بحمل الأمر بغسل اليد على الاستحباب، أي استحباب غسل اليد بعد المصافحة معه مطلقاً ـ سواء كانت المصافحة مع الرطوبة أو بدونها ـ فلابدّ من التصرّف بأحد الوجهين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر لو لم نقل بكون الترجيح مع التصرّف في الأمر بالغسل لكون استعمال الأمر وما بمعناه في الندب شائعاً في لسان الأئمّة (عليهم السلام) مع انّ تقييد الأمر بالغسل وتخصيصه بالمصافحة المشتملة على الرطوبة تقييد بالفرد النادر لندرة المصافحة مع رطوبة اليد وقلّتها بالإضافة إلى غيرها.
الصفحة 218
وبالجملة الظاهر دلالة الرواية على استحباب غسل اليد بعد المصافحة مع المجوسي مطلقاً لإظهار التنفّر والانزجار عنهم ولأنّ الشارع لا يرضى بالمحبّة والمودّة معهم التي يشعر بها المصافحة بين المسلم وغيره، مع انّ مقتضى خواص المصافحة وآثارها التي منها شمول رحمة الله للمتصافحين ووقوع يد الله تبارك وتعالى في يديهما أو مع أيديهما، اختصاصها بالمؤمنين وكونها من خواص الاخوّة في الدين فلا يشمل مصافحة المؤمن والكافرين كما يظهر ذلك لمن تتبّع الروايات الواردة في المصافحة وتأمّل فيها، فإذا اتّفقت المصافحة مع غير الأخ في الدين فليغسل يده استحباباً تنفّراً منهم وانزجاراً عمّا يعتقدونه.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وارقد معه على فراش واحد، واُصافحه؟ قال: لا.
وهذه الرواية أيضاً كسابقتها لا تدلّ على نجاستهم لأنّ الرقود معهم على فراش واحد والمصافحة معهم لا يوجب نجاسة المسلم وإن كان المجوسي نجساً لأنّه يعتبر في التأثّر السراية التي لا تتحقّق بدون الرطوبة ولم يفرض وجودها في الرواية، والنهي عن المؤاكلة معهم في قصعة واحدة أيضاً لا دلالة له على النجاسة لأنّه يمكن أن يكون الطعام يابساً فالنهي عن المؤاكلة معهم والرقود في فراش واحد والمصافحة معهم انّما هو لأجل ترك المحابّة والموادّة معهم لا لأجل النجاسة كيف والنجاسة لا تقتضي النهي بوجه لأنّ غايتها السراية وهي ترتفع بالغسل فلا موجب للتحريم بل ولا الكراهة فتدبّر جيّداً.
ومنها: صحيحته الاُخرى عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولا يصلّى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا
الصفحة 219
يصافحه، قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.
وهذه الرواية أيضاً لا تكون في مقام بيان نجاسة اليهود والنصارى والمجوس بل تكون مسوقة لبيان ترك الموادّة معهم، والشاهد له ـ مضافاً إلى ما عرفت في بيان مفاد الروايتين السابقتين ـ نفي البأس في هذه الرواية عن النوم على فراش اليهودي والنصراني، والنهي عن إقعاد المجوسي على فراشه أو مسجده فانّه لو كان النهي عن إقعاده عليه لنجاسته فما وجه عدم النهي عن النوم على فراش اليهودي والنصراني ولا مجال لتوهّم الفرق بينهما وبين المجوسي من جهة الطهارة والنجاسة كما انّ النهي عن الصلاة في ثيابنهما أو في ثوب اشتراه من نصراني حتّى يغسله انّما هو لأجل تنجّسه بالنجاسات الاُخر غالباً لا لأجل نجاستهما العينية مع قطع النظر عن النجاسات العرضية، وما ذكرنا من كون الرواية مسوقة لبيان ترك الموادّة معهم لا ينافي نفي البأس عن النوم على فراش اليهودي والنصراني فانّه ليس مجرّد النوم على فراشهما دليلاً على الموادّة والمحابّة لإمكان أن لا يكون مجانياً بل بطريق الإجارة أو شبهها كما انّه يمكن أن يكون بعد الاشتراء منهما كما يدلّ عليه ذيل الرواية. وبالجملة لا دلالة للرواية على ما هو محل البحث في هذا المقام من نجاسة المجوسي واليهودي والنصراني.
ومنها: رواية خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ألقى الذمّي فيصافحني قال: امسحها بالتراب وبالحائط، قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها.
وفي الرواية احتمالات:
أحدها: التفصيل بين الذمّي والناصب في النجاسة وعدمها.
الصفحة 220
ثانيها: انّها لا ترتبط بباب النجاسة والطهارة أصلاً بل نظره (عليه السلام) إلى انّه حيث كانت المصافحة المفروضة مبتدئة من جانبهما فأجبهما وصافح معهما ولكنّك اغسل يدك بعد المصافحة مع الناصبي وامسحها بالتراب أو بالحائط بعد المصافحة مع الذمّي انزجاراً وتنفّراً والفرق اختلاف مرتبتي التنفّر والانزجار الظاهر بالغسل والمسح.
ثالثها: أن تكون الرواية في مقام بيان نجاسة الذمّي أيضاً، غاية الأمر انّه لابدّ من حملها على كون المصافحة مقرونة برطوبة إحدى اليدين، والفرق بين نجاسة الذمّي ونجاسة الناصب انّ الاُولى ترتفع بالمسح بالتراب أو الحائط والثانية لا تزول إلاّ بالغسل بالماء.
والاستدلال بالرواية انّما يبتني على هذا الاحتمال الأخير وحمل الرواية عليه مشكل في نفسه وعلى تقدير العدم فلا مرجح له على الاحتمالين الأوّلين فلا مجال للاستدلال بها على المقام.
ومنها: رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في مصافحة المسلم، اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب، فانّ صافحك بيده فاغسل يدك.
وهذه الرواية نظير الرواية الاُولى من هذه الطائفة في انّه يلزم التصرّف فيها امّا بتقييد المصافحة بكونها مقرونة بالرطوبة في إحدى اليدين، أو بحمل الأمر بالغسل الظاهر في الوجوب على الاستحباب فلا يكشف ـ حينئذ ـ عن النجاسة، ولا مرجح للأوّل لو لم نقل بثبوت الترجيح للثاني في هذه الرواية من جهة وجود القرينة عليه وهي انّه لو كانت المصافحة مقرونة بالرطوبة وكان اليهودي والنصراني نجسين لكان اللازم غسل الثوب أيضاً فيما كانت المصافحة من ورائه مع انّه لم يؤمر بغسله في الرواية فيصير ذلك قرينة على انّ الأمر بالغسل يكون المراد به
الصفحة 221
هو الاستحباب لأجل التنفّر والانزجار كما انّ المصافحة من وراء الثوب تشعر بذلك.
فانقدح ممّا ذكرنا انّ هذه الطائفة من الروايات الواردة في أهل الكتاب لم تنهض لإثبات نجاستهم أصلاً.
الطائفة الثانية: ما ورد في المؤاكلة معهم وهي كثيرة أيضاً:
منها: صحيحتا علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمتان في الطائفة الاُولى.
ومنها: صحيحة هارون: قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : انّي اُخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: لا.
وهذه أيضاً لا دلالة لها على نجاسة المجوس ولا تكون في مقام بيانها أصلاً بل تكون مسوقة لبيان ترك الموادة والمخالطة معهم بحيث ينتهي إلى المواكلة من طعامهم، فإنّ الأكل من طعامهم لا يكون مستلزماً لنجاسة الإنسان دائماً ـ على تقدير نجاستهم ـ لأنّه لا يمكن الحكم بنجاسة طعامهم مطلقاً لاختلاف الأطعمة من حيث مسّ الإنسان لها وعدمه فالنهي عن الأكل من طعامهم مطلقاً ناظر إلى ما ذكرنا من مبغوضية الموادّة والمخالطة بالنحو المذكور فتدبّر.
ومنها: حسنة الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: امّا أنافلا أواكل المجوسي، وأكره أن أحرّم عليكم شيئاً تصنعون في بلادكم.
وهذه الرواية أيضاً كما ترى ظاهرة في كراهة دعوة المجوسي إلى الطعام كراهة لا يرتكبها الإمام (عليه السلام) لبشاعة شركة إمام المسلمين مع مجوسي مخالف لمرامه في الأكل والجلوس على مائدة واحدة سيّما إذا كانت مسبوقة بدعوته فالرواية لا ارتباط لها بباب النجاسة والطهارة أصلاً وليس في كلام السائل إشعار بكون النظر إلى ذلك
|