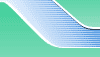(الصفحة221)
أنزل الله إليكم ان ذكر رسولاً .
وبالجملة : فلم يثبت كون المراد من «الذكر» في هذه الآية هو الرسول لو لم نقل بظهورها ـ بقرينة ذكر الإنزال ـ في كونه هو الكتاب .
وثانياً : انّه على تقدير كون المراد بالذكر في تلك الآية هو الرسول ، لكنّه لايتمّ احتماله في المقام ـ وهي آية الحفظ ـ لكونها مسبوقة بما يدلّ على أنّ المراد به هو الكتاب ، وهو قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لََمجْنُونٌ* لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلاَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنْ الصَّادِقِينَ* مَا نُنَزِّلُ الْمَلاَئِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ}(1) .
فكأنّ هذه الآية وقعت جواباً عن قولهم السخيف وافترائهم العنيف وهو أنّ المجنون لا يمكن له حفظ الذكر ولا يليق بأن ينزل عليه فأجابهم الله تبارك وتعالى بأنّ التنزيل إنّما هو فعل الله وهو الحافظ له عن التحريف والتغيير : «أنّا نحن نزّلنا الذكر وانّا له لحافظون» .
فانقدح ممّا ذكرنا وضوح كون المراد بالذكر في آية الحفظ هو الكتاب ، ولا مجال للاحتمال المذكور بوجه أصلاً .
ومن الغريب ـ بعد ذلك ـ ما ذكره المحدّث المعاصر في مقام المناقشة على الاستدلال بالآية من : «انّه قد أجمع الاُمّة على عدم جواز التمسّك بمتشابهات القرآن إلاّ بعد ورود النصّ الصريح في بيان المراد منها ، ولا شكّ أنّ المشترك اللفظي إذا لم يكن معه قرينة تعيّن بعض أفراده ، والمعنوي إذا علم عدم إرادة القدر المشترك منها ، بل اُريد منه أحد أفراده ولم يقترن بما يعيّنه ، من أقسام المتشابهات ،
(1) الحجر : 6 ـ 8 .
(الصفحة222)
و«الذكر» قد أطلق في القرآن كثيراً على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن الجائز أن يكون هو المراد منه هنا أيضاً ، ويكون سبيل تلك الآية سبيل قوله تعالى : {والله يعصمك من الناس}وليس ذكر الإنزال قرينة على كون المراد منه القرآن لقوله تعالى : {إنّا أنزلنا إليكم ذكراً رسولاً} .
وقد عرفت قيام القرينة الواضحة على كون المراد به في المقام هو الكتاب ، وانّه ليست آية الحفظ من المتشابهات بوجه ، والعجب منه (رحمه الله) مع كونه محدّثاً مشهوراً وذا عناية بالروايات المأثورة عن العترة الطاهرة ـ عليهم آلاف الثناء والتحيّة ـ ولو كانت رواتها كذّابين وضّاعين ـ كما سيأتي في البحث عن الروايات الدالّة على التحريف ـ كيف نقل آية الحفظ هكذا : «إنّا أنزلنا الذكر . .» وكيف حكي الآية التي استشهد بها على كون المراد بالذكر هو الرسول بالنحو الذي نقلنا عنه ، مع أنّ الآية هكذا : «قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً» وحينئذ فيسأل عن الوجه في عدم الاعتناء بالكتاب ، والتسامح في نقل ألفاظه المقدّسة وآياته الكريمة ، ولعمري أنّ هذا وأشباهه هو السبب في طعن المخالفين على الفرقة الناجية المحقّة وافترائهم عليهم بأنّهم لا يعتنون بالكتاب العزيز ، ولا يراعون شأنه العظيم وقولهم : إنّهم مشتركون معنا في ترك العمل بحديث الثقلين المتواتر بين الفريقين . فإنّ الطعن علينا والإيراد بنا بترك العترة الطاهرة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وعدم التمسّك بهم منقوض بعدم تمسّكهم بالكتاب الذي هو أيضاً أحد الثقلين بل هو الثقل الأكبر والمعجزة الخالدة الوحيدة للنبوّة والرسالة ، وكيف كان فلا إشكال في المقام في أنّ المراد بالذكر في آية الحفظ هو الكتاب الذي نزّله الله .
ولكنّه أورد على الاستدلال بها علدم التحريف بوجوه اُخر من الإشكال :
(الصفحة223)
الإيراد الأوّل :
انّه لا دليل على كون المراد من الحفظ فيها هو الحفظ عن التلاعب والتغيير والتبديل بل يحتمل :
أوّلاً : أن يكون المراد من الحفظ هو العلم فمعنى قوله تعالى : {وانّا له لحافظون}انّا له لعالمون فلا دلالة فيها حينئذ ـ على عدم التحريف بوجه ولا تعرّض لها من هذه الحيثيّة ، وقد ذكر هذا الاحتمال ، المحقّق القمّي (قدس سره) في كتاب «القوانين» .
وثانياً : انّه على تقدير كون المراد من الحفظ هو الصيانة ، لكن يحتمل أن يكون المراد هو صيانته عن القدح فيه وعن إبطال ما يشتمل عليه من المعاني العالية ، والمطالب الشامخة ، والتعاليم الجليلة ، والأحكام المتينة .
والجواب :
امّا عن الاحتمال الذي ذكره المحقّق القمّي (رحمه الله) فهو وضوح عدم كون الحفظ ـ لغةً وعرفاً ـ بمعنى العلم فإنّ المراد منه هو الصيانة ، وأين هو من العلم بمعنى الإدراك والاطّلاع ، ومجرّد الاحتمال إنّما يقدح في الاستدلال إذا كان احتمالاً عقلائيّاً منافياً لانعقاد الظهور للّفظ ، ومن الواضح عدم ثبوت هذا النحو من الاحتمال في المقام .
وامّا عن الاحتمال الثاني ، فهو أنّه إن كان المراد من صيانته عن القدح والإبطال هو الحفظ عن قدح الكفّار والمعاندين ، بمعنى انّه لم يتحقّق في الكتاب قدح من ناحيتهم بوجه ـ والسبب فيه هو الله تبارك وتعالى فإنّه منعهم عن ذلك ـ فلا ريب في بطلان ذلك ، لأنّ قدحهم في الكتاب فوق حدّ الإحصاء والكتب السخيفة المؤلّفة لهذه الأغراض الشيطانية كثيرة .
(الصفحة224)
وإن كان المراد انّ القرآن لأجل اتّصاف ما يشتمل عليه من المعاني بالقوّة والاستحكام والمتانة لا يمكن أن يصل إليه قدح القادحين ، ولا يقع فيه تزلزل واضطراب من قبل شبه المعاندين ، فهذا المعنى وإن كان أمراً صحيحاً مطابقاً للواقع إلاّ أنّه لا يرتبط بما هو مفاد الآية الشريفة ، ضرورة أنّ ما ذكر إنّما هو شأن القرآن ووصف الكتاب ، والآية إنّما هي في مقام توصيف الله تبارك وتعالى ، وانّه المنزل للكتاب العزيز ، والحافظ له عن التغيير والتبديل .
وبعبارة اُخرى : مرجع ما ذكر إلى أنّ القرآن حافظ لنفسه بنفسه لاستحكام مطالبه ، ومتانة معانيه ، وعلوّ مقاصده ، والآية تدلّ على افتقاره إلى حافظ غيره ، وهو الله الذي نزله ، فأين هذا من ذاك ، فتدبّر جيّداً .
الإيراد الثاني :
انّ مرجع الضمير في قوله : «وانّا له لحافظون» إن كان المراد به هو كلّ فرد من أفراد القرآن من المكتوب والمطبوع وغيرهما فلا ريب في بطلانه لوقوع التغيير في بعض أفراده قطعاً ، بل ربّما مزّق أو فرّق ، كما صنع الوليد وغيره .
وإن كان المراد به هو حفظه في الجملة كفى في ذلك حفظه عند الإمام الغائب ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ فلا يدلّ على عدم التحريف في الافراد التي بأيدينا من الكتاب العزيز ، والقائل بالتحريف إنّما يدّعيه في خصوص هذه الافراد ، لا ما هو الموجود عند محمّد وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .
والجواب :
إنّ القرآن ليس أمراً كليّاً قابلاً للصدق على كثيرين بحيث تكون نسبته إلى النسخ المتكثّرة كنسبة طبيعة الإنسان إلى أفرادها المختلفة ، وكانت لها أفراداً
(الصفحة225)
موجودة ، وافراداً انعدمت بعد وجودها ، أو يمكن أن توجد ، بل القرآن هو الحقيقة النازلة على الرسول الأمين التي قال الله في شأنها : {انّا أنزلناه في ليلة القدر}والقرآن المكتوب أو الملفوظ إنّما هو حاك عن تلك الحقيقة ، وكاشف عمّا اُنزل في تلك الليلة المباركة ، ومن المعلوم انّها ليست متكثّرة متنوّعة ، ومرجع حفظها إلى ثبوتها بتمامها من دون نقص وتغيير ، وكون الحاكي حاكياً عنها كذلك ، وهذا مثل ما نقول : إنّ القصيدة الفلانية محفوظة فإنّ معناها انّ الكتب الحاكية عنها أو الصدور المحافظة لها حاكية عنها بأجمعها ، وحافظة لها بتمامها كما لا يخفى .
الإيراد الثالث :
ما ذكره المحدّث المعاصر من أنّ آية الحفظ مكّية واللفظ بصورة الماضي ، وقد نزل بعدها سور وآيات كثيرة فلا تدلّ على حفظها ، لو سلّمنا الدلالة .
والجواب :
واضح ، فإنّ الناظر في الآية العارف بأساليب الكلام يقطع بأنّ الحفظ إنّما يتعلّق بما هو الذكر الذي هو شأن القرآن بأجمعه ، فكما أنّ صفة التنزيل صفة عامّة ثابتة لجميع الآيات والسور بملاحظة نفس هذه الآية الشريفة ، ولا يكاد يتوهّم عاقل دلالتها على اتصاف الآيات الماضية بذلك فكذلك وصف الحفظ والمصونية .
الإيراد الرابع :
وهو العمدة ، انّ القائل بالتحريف يحتمل وجود التحريف في نفس هذه الآية الشريفة ، لأنّها بعض آيات القرآن ، فلاحتمال التحريف فيه مجال ، ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال ، فكيف يصحّ الاستدلال بما يحتمل فيه التحريف على نفسه ، وهل هذا إلاّ الدور الباطل؟! .
(الصفحة226)
والجواب :
إنّ الاستدلال إن كان في مقابل من يدّعي التحريف في موارد مخصوصة وهي الموارد التي دلّت عليها روايات التحريف ، فلا مجال للمناقشة فيه; لعدم كون آية الحفظ من تلك الموارد على اعترافه ، ضرورة انّه لم ترد رواية تدلّ على وقوع التحريف في آية الحفظ أصلاً .
وإن كان في مقابل من يدّعي التحريف في القرآن إجمالاً ، بمعنى أنّ كلّ آية عنده محتملة لوقوع التحريف فيها ، وسقوط القرينة الدالّة على خلاف ظاهرها عنها ، فتارةً يقول القائل بهذا النحو من التحريف بحجّية ظواهر الكتاب ، مع وصف التحريف ، واُخرى لا يقول بذلك ، بل يرى أنّ التحريف مانع عن بقاء ظواهر الكتاب على الحجّية ، وجواز الأخذ والتمسّك بها ، ويعتقد أنّ الدليل على عدم الحجّية هو نفس وقوع التحريف .
فعلى الأوّل : لا مجال للمناقشة في الاستدلال بآية الحفظ على عدم التحريف ، لأنّه بعدما كانت الظواهر باقية على الحجّية ، ووقوع التحريف غير مانع عن اتّصاف الظواهر بهذا الوصف ، كما هو المفروض نأخذ بظاهر آية الحفظ ، ونستدلّ به على العدم كما هو واضح .
وعلى الثاني : الذي هو عبارة عن مانعيّة التحريف عن العمل بالظواهر ، والأخذ بها ، فإن كان القائل بالتحريف مدّعياً للعلم به ، والقطع بوقوع التحريف في القرآن إجمالاً ، وكون كلّ آية محتملة لوقوع التحريف فيها ، فالاستدلال بآية الحفظ لا يضرّه ، ولو كان ظاهرها باقياً على وصف الحجّية ، لأنّ ظاهر الكتاب إنّما هي حجّة بالإضافة إلى من لا يكون عالماً بخلافه ، ضرورة أنّه من جملة الأمارات
(الصفحة227)
الظنّية المعتبرة ، وشأن الأمارة اختصاص حجّيتها بخصوص الجاهل بمقتضاها ، وامّا العالم بالخلاف المتيقّن له فلا معنى لحجّية الأمارة بالإضافة إليه ، فخبر الواحد ـ مثلاًـ الدالّ على وجوب صلاة الجمعة إنّما يعتبر بالنسبة إلى من لا يكون عالماً بعدم الوجوب ، وامّا بالإضافة إلى العالم فلا مجال لاعتباره بوجه ، فظاهر آية الحفظ ـ على تقدير حجّيته أيضاً ـ إنّما يجدي لمن لا يكون عالماً بالتحريف ، والبحث في المقام إنّما هو مع غير العالم .
وإن كان القائل به لا يتجاوز عن مجرّد الاحتمال ، ولا يكون عالماً بوقوع التحريف في الكتاب ، بل شاكّاً ، فنقول مجرّد احتمال وقوع التحريف ، ولو في آية الحفظ أيضاً لا يمنع عن الاستدلال بها ، لعدم التحريف ، كيف وكان الدليل على عدم حجّية الظواهر والمانع عنها هو التحريف ، فمع عدم ثبوته واحتمال وجوده ، وعدمه كيف يرفع اليد عن الظاهر ، ويحكم بسقوطه عن الحجّية ، بل اللاّزم الأخذ به ، والحكم على طبق مقتضاه الذي عرفت أنّ مرجعه إلى عدم تحقّق التحريف بوجه ، ولا يستلزم ذلك تحقّق الدور الباطل ، ضرورة أنّ سقوط الظاهر عن الحجّية فرع تحقّق التحريف وثبوته ، وقد فرضنا أنّ الاستدلال إنّما في مورد الشكّ وعدم العلم ، ومن الواضح أنّ الشكّ فيه لا يوجب سقوط الظاهر عن الحجّية ، ما دام لم يثبت وقوعه ، فتدبّر جيّداً .
وقد انقدح ممّا ذكرنا تماميّة الاستدلال بآية الحفظ ، والجواب عن جميع الإشكالات ، سيّما الأخير الذي كان هو العمدة في الباب .
الدليل الثاني :
قوله تعالى في سورة فصّلت 41 ، 42 : {وانّه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من
(الصفحة228)
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} ولا خفاء في ظهوره في أنّه لا يأتي الكتاب العزيز الباطل ـ بجميع أقسامه ـ ومن شيء من الطرق والجوانب ، ضرورة أنّ النفي إذا ورد على الطبيعة المعرفة بلام الجنس أفاد العموم ، بالإضافة إلى جميع أنواعها وأصنافها وأفرادها ، فالباطل في ضمن أيّ نوع تحقّق ، وأيّ صنف حصل ، وأيّ فرد وجد ، بعيد عن الكتاب بمراحل لا يمكن له إتيانه والاتّصال إليه ، ومن الواضح أنّ «التحريف» من أوضح مصاديق الباطل ، وأظهر أصنافه ، فالآية تنفيه وتخبر عن عدم وقوعه وبعده عن الكتاب .
مضافاً إلى أنّ توصيف الكتاب بالعزّة يلائم مع حفظه عن التغيير والتنقيص ، كما أنّ قوله تعالى في ذيل الآية : {تنزيل من حكيم حميد} الذي هو بمنزلة التعليل للحكم بعدم إتيان الباطل الكتاب يناسب مع بقائه ، وعدم تطرّق التحريف إليه ، فإنّ ما نزل من الحكيم لا يناسبه عروض التغيير ، ويكون مصوناً من أن تتلاعب به الأيدي الجائرة ، ومحفوظاً من أن تمسّه الأفراد غير المطهّرة .
وقد أورد على الاستدلال بوجوه من الإشكال :
الإشكال الأوّل :
انّه قد ورد في تفسير الآية روايات دالّة على أنّ المراد منها غير ما ذكرنا ، مثل رواية علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال : «لا يأتيه الباطل من قبل التوراة ، ولا من قبل الإنجيل والزبور ، ولا من خلفه أي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله» ورواية مجمع البيان عن الصادقين (عليهما السلام) : «انّه ليس في اخباره عمّا مضى باطل ، ولا في إخباره عمّا يكون في المستقبل باطل» .
والجواب :
(الصفحة229)
أنّ اختلاف الروايتين في تفسير الآية ، وبيان المراد منها ـ ضرورة أنّه لا يكاد يمكن الجمع بينهما ، فإنّ الاخبار عمّا مضى لا يرتبط بالتوراة والإنجيل والزبور ، والاخبار عمّا يكون في المستقبل لا يلائم الكتاب الذي يأتي من بعده ـ دليل على عدم حصر الباطل في شيء من مفادهما ، وانّهما بصدد بيان المصداق ، ولا دلالة لهما على الحصر أصلاً ، وعليه فظهور الآية في العموم وعدم تطرّق شيء من أقسام الباطل وأفراده إليه واضح ، لا معارض له بوجه .
الإشكال الثاني :
التأمّل في صدق الباطل على ورود التحريف عليه ، خصوصاً بعد ملاحظة وحدة المراد منه فيما سبق القرآن أو لحقه ، إذ لا يتوهّم في الباطل الذي بين يديه ذلك فيكون ما في خلفه كذلك .
والجواب :
من الواضح أنّ كون التحريف من أظهر مصاديق الباطل ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، وتعلّق النفي بالطبيعة المعرفة يفيد العموم ـ على ما ذكرناـ ولا مجال لملاحظة وحدة المراد ، فإنّ الحكم لم يتعلّق بالافراد حتّى تلاحظ وحدة المراد ، بل بنفس الطبيعة في السابق واللاّحق ، كما هو غير خفيّ .
الإشكال الثالث :
انّه لا يظهر في شيء من الكتب الموضوعة في تفسير القرآن ، تفسير الآية بما ذكر ، ولا احتمله أحد من المفسِّرين ، وإليك نقل بعض كلمات أعلامهم :
قال الشيخ الطوسي (قدس سره) في محكي التبيان : «قوله تعالى : لا يأتيه الباطل . . .» قيل في معناه أقوال خمسة :
(الصفحة230)
أحدها : انّه لا تعلّق به الشبهة من طريق المشاكلة ، ولا الحقيقة من جهة المناقضة ، فهو الحقّ المخلص الذي لا يليق به الانس .
ثانيها : قال قتادة والسدّي : معناه لا يقدر الشيطان أن ينتقص منه حقّاً ولا يزيد فيه باطلاً .
ثالثها : معناه لا يأتي بشيء يوجب بطلانه ، ممّا وجد قبله ولا معه ، ولا ممّا يوجد بعده ، وقال الضحّاك : لا يأتيه كتاب من بين يديه يبطله ، ولا من خلفه ، أي ولا حديث من بعده يكذّبه ، وقال ابن عبّاس : معناه لا يأتيه من التوراة والإنجيل ، ولا من خلفه ، أي لا يجيء كتاب من بعده .
رابعها : قال الحسن : معناه لا يأتيه الباطل من أوّل تنزيل ، ولا من آخره .
خامسها : انّ معناه : ولا يأتيه الباطل في اخباره عمّا تقدّم ، ولا من خلفه ولا عمّا تأخّر» .
وقال السيِّد الرضي في محكي الجزء الخامس من تفسيره المسمّى بـ «حقائق التأويل» في تفسير قوله تعالى : بكلمة منه اسمه المسيح ـ بعد ذكر سرّ تذكير الضمير فيه وتأنيثه في قوله تعالى : {إنّما المسيح عيسى بن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم}ما لفظه :
«وإذا نظرت بعين عقلك بأنّ لك ما بين الموضعين من التمييز البيّن ، والفرق النيّر ، وعجبت من عمائق هذا الكتاب الشريف ، التي لا يدرك غزرها ، ولا يضب بحرها ، فإنّه كما وصفه سبحانه بقوله : {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} .
ومن أحسن ما قيل في تفسير ذلك انّه لا يشبه كلاماً تقدّمه ، ولا يشبهه كلام تأخّر عنه ، ولا يتّصل بما قبله ، ولا يتّصل به ما بعده ، فهو الكلام القائم بنفسه ،
(الصفحة231)
البائن من جنسه ، العالي على كلّ كلام قرن إليه وقيس به» .
وبالجملة : فتفسير الآية بما ذكر في الاستدلال مخالف لما يظهر من الفحول والرجال من مفسِّري العامّة والخاصّة ، وعليه فلا يبقى للتمسّك بها مجال .
والجواب :
انّا قد حقّقنا في أوّل مبحث أصول التفسير : انّ الأصل الأوّلي في باب التفسير ، وكشف مراد الله تبارك وتعالى من كتابه العزيز هو ظواهر الكتاب ، وانّ الاعتماد في باب التفسير عليها ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، وقول المفسِّرين لم يقم دليل على اعتباره ما لم يكن مبتنياً على تلك الاُصول ، وقد عرفت أنّ ظاهر الآية تعلّق النفي بطبيعة الباطل ، وانّ التحريف من أوضح مصاديقه ، ولا يعارض ذلك قول المفسِّرين ، إلاّ إذا كان مستنداً إلى بيان المعصوم (عليه السلام) الذي هو أيضاً من تلك الاُصول ، والظاهر عدم الاستناد في المقام ، وعلى تقديره فالروايات المستند إليها هي الروايات المتقدّمة ، وقد عرفت عدم دلالتها على حصر الباطل في مفادها ، والدليل عليه وجود الاختلاف بينها ، كما لا يخفى .
الإشكال الرابع :
نظيره من أنّه إن اُريد بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل جميع أفراده الموجودة بين الناس ، فهو خلاف الواقع ، للإجماع على أنّ ابن عفّان ، أحرق مصاحف كثيرة حتّى قيل : إنّه أحرق أربعين ألف مصحف ، ويمكن ذلك ضرورة لآحاد أهل الإسلام والمنافقين ، فليكن ما صدر من أولئك من التحريف في الصدر الأوّل من هذا القبيل ، وإن اُريد في الجملة فيكفي في انتفاء الباطل عنه انتفاؤه عن ذلك الفرد المحفوظ عند أهل البيت (عليهم السلام) .
(الصفحة232)
والجواب : عنه قد تقدّم في الأمر الأوّل والتكرار موجب للتطويل .
الدليل الثالث :
ما أفاده بعض الأعاظم في تفسيره المسمّى بـ «الميزان في تفسير القرآن» وحاصله : أنّ من ضروريّات التاريخ انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) جاء قبل أربعة عشر قرناً ـ تقريباًـ وادّعى النبوّة ، وانّه جاء بكتاب يسمّيه القرآن ، وينسبه إلى ربّه ، وكان يتحدّى به ويعدّه آية لنبوّته ، وانّ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي جاء به وقرأه على الناس المعاصرين له في الجملة ، بمعنى أنّه لم يضع من أصله بأن يفقد كلّه ، ثمّ يوضع كتاب آخر يشابهه في نظمه أو لا يشابهه ، ويشتهر بين الناس بأنّه القرآن النازل على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فهذه اُمور لا يرتاب في شيء منها إلاّ مصاب في فهمه ، ولا احتمله أحد من الباحثين في مسألة التحريف ، وإنّما المحتمل زيادة شيء يسير كالجملة أو الآية ، أو النقص أو التغيير في جمله أو آية في كلماتها أو إعرابها .
ثمّ إنّا نجد القرآن يتحدّى بأوصاف ترجع إلى عامّة آياته ، ونجد ما بأيدينا من القرآن ـ أعني ما بين الدفّتين ـ واجداً لما وصف به من أوصاف تحدّى بها .
فنجده يتحدّى بالبلاغة والفصاحة ما بأيدينا مشتملاً على ذلك النظم العجيب البديع ، لا يشابهه شيء من كلام البلغاء والفصحاء المحفوظ منهم ، والمرويّ عنهم من شعر ، أو نثر وأمثالهما .
ونجده يتحّى بقوله : {أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً} بعدم وجود اختلاف فيه ، ونجد ما بأيدينا من القرآن يفي بذلك أحسن الوفاء .
ونجده يتحدّى بغير ذلك ممّا لا يختصّ فهمه بأهل اللغة العربية كما في قوله
(الصفحة233)
تعالى : {قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً} .
ثمّ نجد ما بأيدينا من القرآن يستوفي البيان في صريح الحقّ الذي لا مريّة فيه ، ويهدي إلى آخر ما يهتدي إليه العقل من اُصول المعارف الحقيقيّة ، وكلّيات الشرائع الفطريّة ، وتفاصيل الفضائل الخلقية من غير أن نعثر فيها على شيء من النقيصة والخلل ، أو نحصل على شيء من التناقض والزلل ، بل نجد جميع المعارف على سعتها وكثرتها حيّة بحياة واحدة ، مدبّرة بروح واحد ، هو مبدأ جميع المعارف القرآنية ، والأصل الذي إليه ينتهي الجميع ويرجع ، وهو التوحيد ، فإليه ينتهي الجميع بالتحليل ، وهو يعود إلى كلّ منها بالتركيب .
ونجده يغوص في أخبار الماضين من الأنبياء واُممهم ، ونجد ما عندا من كلام الله يورد قصصهم ، ويفصّل القول فيها على ما يليق بطهارة الدين ، ويناسب نزاهة ساحة النبوّة .
ونجده يورد آيات في الملاحم ، ويخبر عن الحوادث الآتية في آيات كثيرة ، ثمّ نجدها فيما هو بأيدينا من القرآن .
ونجده يصف نفسه بأوصاف زاكية جميلة ، كما يصف نفسه بأنّه نور وانّه هاد ويهدي إلى صراط مستقيم ، وإلى الملّة التي هي أقوم ، ونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئاً من ذلك .
ومن أجمع الأوصاف التي يذكرها القرآن لنفسه انّه ذكر الله ، فإنّه يذكر به تعالى بما أنّه آية دالّة عليه حيّة خالدة ، وبما أنّه يصفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ، ويصف سنّته في الصنع والإيجاد ، ويصف ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه
(الصفحة234)
وأحكامه وما ينتهي إليه أمر الخلقة ، وتفاصيل ما يؤل إليه أمر الناس من السعادة والشقاوة والجنّة والنار .
ففي جميع ذلك ذكر الله وهو الذي يرومه القرآن بإطلاق القول بأنّه ذكر ، ونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئاً من معنى الذكر .
ولكون هذا الوصف من أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن عبّر عنه به في الآيات التي أخبر فيها عن حفظ القرآن عن البطلان والتغيير والتحريف كقوله تعالى : {انّا نحن نزّلنا الذكر وانّا له لحافظون} انتهى ما أفاده ملخّصاً .
وهو وإن كان غير خال عن المناقشة ، ضرورة أنّ ما أفاده إنّما يجدي لنفي الزيادة الكثيرة ، أو النقيصة المتعدّدة في مواضع متكثّرة ، كما يدّعيه القائل بالتحريف ، المستند إلى الروايات الكثيرة الدالّة عليه ، وامّا احتمال زيادة يسيرة أو نقيصة يسيرة كما فرضه في أوّل البحث ، فالدليل لا يثبت نفسه ، ولا يجدي لدفعه أصلاً ، أفيكفي هذا الدليل لإثبات انّه لم تسقط كلمة في «عليّ» بعد قوله : {بلِّغ ما اُنزل إليك من ربّك} فإنّه على كلا التقديرين ـ سواء كانت هذه الكلمة موجودة أم لم تكن ـ لا يختلّ شيء من أوصاف القرآن ، ولا يوجب نقصاً في التحدّي ، ولا خللاً في الجهات المتعدّدة التي يدلّ عليها القرآن من اُصول المعارف وكلّيات الشرائع ، وتفاصيل الفضائل ، ونقل القصص والإخبار بالملاحم وبالتالي كونه ذكراً الذي هو ـ كما اعترف به ـ أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن ، إلاّ انّ له مع ذلك صلاحية للتأييد ممّا لا ينبغي الارتياب فيه .
ثمّ إنّ هذه الاُمور الثلاثة الدالّة على عدم التحريف ممّا يمكن التمسّك بها من نفس الكتاب العزيز .
(الصفحة235)
الدليل الرابع :
الحديث المعروف المتواتر بين الفريقين ، الدالّ على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) خلّف الثقلين : كتاب الله والعترة ، وأخبر انّهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض ، وانّ التمسّك بهما موجب لعدم تحقّق الضلالة أبداً إلى يوم القيامة . وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف على عدم تحريف القرآن المجيد من وجهين :
الوجه الأوّل :
إنّ القول بالتحريف يستلزم عدم إمكان التمسّك بالكتاب ، مع أنّ الحديث يدلّ على ثبوت هذا الإمكان إلى يوم القيامة ، فيكون القول بالتحريف الملازم لعدم الإمكان باطلاً لمخالفته ، لما يدلّ عليه الحديث ، وعدم إمكان الجمع بينه وبينه فهاهنا دعويان لابدّ من إثباتهما :
الدعوى الاُولى :
استلزام القول بالتحريف ، لعدم إمكان التمسّك بالكتاب العزيز ، ولتوضيح الاستلزام وثبوت الملازمة نقول : إنّ الكتاب العزيز ـ كما تقدّم سابقاً في بعض مباحث الإعجاز ـ ليس الغرض من إنزاله ، والغاية المترتّبة على نزوله ، ناحية خاصّة وشأناً مخصوصاً ، وليس التعرّض فيه لخصوص فنّ من الفنون التي يختصّ كلّ منها بكتاب ، وكلّ كتاب بواحد منها ، بل هو جامع لفنون شتّى ، وجهات كثيرة فتراه متعرّضاً لما يرجع إلى المبدأ من وجوده وتوحيده ، وصفاته العليا ، وأسمائه الحسنى ، وأفعاله وآثاره ، ولما يرتبط بالمعاد من ثبوته وخصوصيّاته ، والسعادة والشقاوة ، والجنّة والنار ، وأوصافهما ، وأوصاف الداخلين فيهما وخصوصيّاتهم ، ولما يتعلّق بالأنبياء ، وعلوّ مقامهم ، ونزاهة ساحتهم ، وشموخ مقامهم ، وما وقع
(الصفحة236)
بينهم وبين اُممهم ، ولما يرجع إلى الفضائل الخلقيّة ، والمَلَكات النفسانيّة ، ولما يعود إلى بيان الأحكام العملية ، والشرائع الفطريّة ، ولغير ذلك من الجهات والشؤون .
والغرض الأقصى الذي بيّنه الكتاب هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وإيصالهم إلى المرتبة الكاملة من الإنسانيّة ، والدرجة العالية : المادّية والمعنويّة .
وعليه فمعنى التمسّك بمثل هذا الكتاب ـ الذي ليس كمثله كتاب ـ هو الاستفادة من جميع الشؤون التي وقع التعرّض فيه لها ، والاستضاءة بنوره الذي لا يبقى معه ظلمة ، والاهتداء بهدايته التي لا موقع معها للضلالة ، ولا يخاف عندها الجهالة ، فلو لم يكن ما بأيدينا من الكتاب عين ما نزل على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ونفس ما خلّفه في اُمّته ، وحرصهم على التمسّك به ، والخروج بسببه عن الضلالة فكيف يمكن التمسّك به إلى يوم القيامة ، وكيف يمكن انّ الضلالة منفيّة مؤبّدة ، فإنّ الكتاب الضائع على الاُمّة بسبب التحريف ، ودسّ المعاندين ـ ولا محالة كان الغرض من التحريف إخفاء بعض حقائقه وإطفاء بعض أنواره ـ لا يصلح أن يكون نوراً في جميع الاُمور ، وسراجاً مضيئاً في الظلمات كلّها ، ضرورة أنّه يلزم أن يكون التحريف ـ حينئذـ لغواً مع أنّه كان لغرض راجع إلى إخفاء مقام الولاية أو غيره من الاُمور المهمّة ، التي كان تعرّض الكتاب لها ، منافياً لغرض المحرّفين ، ومخالفاً لنظر المعاندين فلا يبقى ـ حينئذ ـ مجال لبقاء إمكان التمسّك بالكتاب مع وجود التحريف .
الدعوى الثانية :
دلالة الحديث الشريف على إمكان التمسّك بالكتاب العزيز ، ولا يخفى وضوح هذه الدلالة لو كان الحديث دالاًّ على الأمر بالتمسّك ، وإيجاب الرجوع إليه ،
(الصفحة237)
ضرورة اعتبار القدرة في متعلّق التكليف مطلقاً ـ أمراً كان أو نهياً ، فمع عدم إمكان التمسّك لا يبقى مجال لإيجابه والحكم بلزومه .
وامّا لو لم يكن الحديث بصدد الإلزام وجعل الحكم الإنشائي التكليفي ، ولم تكن الجملة الخبريّة مسوّقة لإفادة التكليف والإيجاد ، بل كانت في مقام مجرّد الأخبار ، والحكاية عن الواقع ، وانّ الأثر المترتّب على التمسّك بالثقلين هو رفع خوف الضلالة وارتفاع خطر الجهالة وعدم الابتلاء بها إلى يوم القيامة ، فدلالته ـ حينئذـ على إمكان التمسّك به لأجل الانفهام العرفي ، والإنسباق العقلائي ، فإنّ المتفاهم من مثل هذا التعبير في المحاورات العرفية ثبوت الإمكان في الشرط في القضية الشرطية الخبريّة ، مثال ذلك : انّك إذا قلت مخاطباً لصديقك : إذا اشتريت الدار الفلاني يترتّب عليه كذا وكذا» لا يفهم منه إلاّ إمكان الاشتراء ، ولا يعبّر بمثل هذه العبارة إلاّ في مورد ثبوت الإمكان ، ومع عدمه يكون التعبير هكذا : «إن أمكن لك الاشتراء» .
مضافاً إلى ثبوت خصوصية في المقام ، وهو كون الكتاب ميراثاً للنبيّ الذي يكون خاتم النبيّين ، ويكون حلاله وحرامه باقيين إلى يوم القيامة ، فهل يمكن أن يكون مع ذلك غير ممكن للتمسّك ، وهل يتّصف ـ حينئذ ـ بأنّه خلّفه النبي وكان غرضه من ذلك إرشاد الاُمّة ، وهداية الناس إلى طريق الهداية ، والخروج من الضلالة ، فعلى تقدير عدم دلالة مثل هذا التعبير على ثبوت وصف الإمكان في غير المقام ، لا محيص عن الالتزام بدلالته عليه في خصوص المقام للقرائن والخصوصيات الموجودة فيه .
فانقدح من جميع ذلك تمامية الاستدلال بالحديث الشريف من الوجه الأوّل ،
(الصفحة238)
الذي عرفت ابتناءه على الدّعويين الثابتتين .
نعم يمكن أن يورد على الاستدلال به من هذا الوجه شبهات ، لا بأس بإيرادها والجواب عنها ، فنقول :
الشبهة الاُولى :
انّه لا يعتبر في التمسّك بشيء أن يكون المتمسّك به موجوداً حاضراً ، وكان تحت اختيار المكلّف ، وهذا كما في التمسّك بالعترة ـ التي هي إحدى الحجّتين ، وواحد من الثقلين ـ فإنّه لا يعتبر في تحقّقه حياتهم ، فضلاً عن حضورهم ، وعدم غيابهم ، ضرورة ثبوت هذا الوصف لنا بالإضافة إلى أئمّتنا المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ مع عدم إمكان تشرّفنا إلى محضرهم ، في أعصارنا هذه ، وعدم الحضور ـ أيضاًـ لخاتمهم ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ فلا يعتبر في تحقّق التمسّك وجودهم ، فضلاً عن حضورهم ، ومثل ذلك يجري في التمسّك بالكتاب من دون فرق ، فالتحريف الموجب لضياعه على الاُمّة لا يستلزم عدم إمكان التمسّك به .
والجواب :
وضوح الفرق بين التمسّك بالعترة ، والتمسّك بالكتاب ، فإنّ التمسّك بالشخص ـ ولو مع حياته وحضوره ـ معناه اتباعه والموالاة له ، والإطاعة لأوامره ونواهيه ، والأخذ بقوله ، والسير على سيرته ، على وفقه ، ولا حاجة في ذلك إلى الاتّصال به ، والتشرّف بمحضره ، والمخاطبة معه ، بل يمكن ذلك مع موته ، فضلاً عن غيبته ، ومن هذه الجهة نحن متمسِّكون بهم جميعاً في زمن الغيبة ، وأيّ تمسّك أعظم من تعظيم الفقهاء الراوين للحديث ، والأخذ بقولهم ، اتّباعاً لما ورد في التوقيع الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب ، الدالّ على وجوب الرجوع في الحوادث
(الصفحة239)
الواقعة إلى رواة الحديث ، معلّلاً بكونهم حجّته وهو حجّة الله على الناس .
وامّا التمسّك بالكتاب; فهو لا يمكن تحقّقه مع عدم وجوده بين الاُمّة ، وكونه ضائعاً عليهم ، فكيف يعقل التمسّك به مع عدم العلم بما تضمّنه لأجل تحقّق النقيصة فيه على هذا لافرض ، فبين التمسّكين فرق واضح .
الشبهة الثانية :
انّه وإن كان يعتبر في التمسّك بالكتاب وجوده وثبوته ، إلاّ أنّ هذا الوصف ثابت للقرآن الواقعي ، لوجوده عند الإمام الغائب ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ وإن لم يمكن الوصول إليه عادة .
والجواب :
ظهر ممّا تقدّم أنّ الوجود الواقعي للكتاب لا يكفي في إمكان التمسّك به ، بل اللاّزم أن يكون باختيار الاُمّة وقابلاً للرجوع إليه ، والأخذ به ، والسير على هداه ، والاستضاءة بنوره ، والاهتداء بهدايته ، كما هو أوضح من أن يخفى .
الشبهة الثالثة :
انّ المقدار الذي تكون الاُمّة مأمورة التمسّك به ، هو خصوص آيات الأحكام ، لأنّها المتضمّنة للتشريع ، وبيان القوانين العمليّة ، والأحكام الفرعية ، ولا بأس بأن يكون الحديث دالاًّ على إمكان التمسّك بالكتاب بهذا المقدار ، فيدلّ على عدم التحريف بالإضافة إليه ، ولا ينفي وقوعه في الآيات الاُخرى غير المتضمِّنة للأحكام .
والجواب :
إنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس الغرض منه مجرّد بيان الأحكام
(الصفحة240)
والقوانين العمليّة ، بل الغرض منه الهداية ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور من جميع الجهات . ومن المعلوم انّ العمدة في تحصيل هذا الغرض المهمّ هي ما يرجع إلى الاُصول الاعتقاديّة ، ومسائل التوحيد والنبوّة والإمامة وأشباهها ، وحينئذ فكيف يسوغ القول بأنّ الغرض من الأمر بالتمسّك به هو التمسّك بخصوص آيات الأحكام العمليّة منها ، إذ ليس كتاباً فقهيّاً فقط .
وعليه فالتمسّك المأمور به هو التمسّك به من جميع الجهات التي لها مدخلية في السير إلى الكمال ، وحصول الخروج من الظلمات إلى النور ، وتحقّق الهداية ، ومحو الضلالة والجهالة ، فالاستدلال بالحديث على عدم وقوع التحريف في شيء من آياته تامّ لا شبهة فيه ولا ارتياب ، كما لا يخفى على اُولي الألباب .
الوجه الثاني :
انّ الظاهر من الحديث انّ كلاًّ من الثقلين حجّة مستقلّة ، ودليل تامّ في عرض الآخر وفي رتبته ، بمعنى عدم توقّف حجّية كلّ منهما على الآخر ، وعدم الافتقار إلى تصويبه وإمضائه ، لا بمعنى كون كلّ واحد منهما كافياً في الوصول إلى الكمال الممكن ، والخروج من الضلالة ، وارتفاع خوف الجهالة ، فإنّ هذا الأثر قد رتّب في الحديث على الأخذ بمجموع الثقلين ، والتمسّك بكلا الميراثين ، بل بمعنى كون الأثر وإن كان كذلك إلاّ انّه لا ينافي الاستقلال ، وتمامية كلّ منهما في الحجّية والدليليّة ، والغرض انّ الحجّة ليست هي المجموع ، بل كلّ واحد منهما من دون توقّف على الآخر ، ومن دون منافاة ومضادّة لترتّب الأثر والغرض على الأخذ بالمجموع ، والتمسّك به ، وهذا كما أنّ كلّ واحد من الأدلّة الأربعة المعروفة ـ الكتاب والسنّة والعقل والإجماع ـ دليل وحجّة مستقلّة في الفقه ، مع أنّ الاستنباط ، واستكشاف
|