|
|
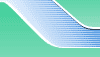 |
 |
صفحه 216 وقد عرفت قيام القرينة الواضحة على كون المراد به في المقام هو الكتاب ، وأ نّه ليست آية الحفظ من المتشابهات بوجه ، والعجب منه (رحمه الله) مع كونه محدّثاً مشهوراً وذا عناية بالروايات المأثورة عن العترة الطاهرة عليهم آلاف الثناء والتحيّة ولو كانت رواتها كذّابين وضّاعين ، كما سيأتي(1) في البحث عن الروايات الدالّة على التحريف ـ كيف نقل آية الحفظ هكذا : «إنّا أنزلنا الذكر...»(2) . وكيف حكى الآية التي استشهد بها على كون المراد بالذكر هو الرسول بالنحو الذي نقلنا عنه ، مع أنّ الآية هكذا : ( قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا* رَّسُولاً) (3) . وحينئذ فيُسأل عن الوجه في عدم الاعتناء بالكتاب ، و التسامح في نقل ألفاظه المقدّسة وآياته الكريمة ، ولعمري أنّ هذا وأشباهه هو السبب في طعن المخالفين على الفرقة الناجية المحقّة ، وإفترائهم عليهم بأنّهم لا يعتنون بالكتاب العزيز ، ولايراعون شأنه العظيم ، وقولهم : إنّهم مشتركون معنا في ترك العمل بحديث الثقلين المتواتر بين الفريقين ; فإنّ الطعن علينا والإيراد بنا بترك العترة الطاهرة ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ وعدم التمسّك بهم ، منقوض بعدم تمسّكهم بالكتاب الذي هو أيضاً أحد الثقلين ، بل هو الثقل الأكبر، والمعجزة الخالدة الوحيدة للنبوّة والرسالة . وكيف كان ، فلا إشكال في المقام في أنّ المراد بالذكر في آية الحفظ هو الكتاب الذي نزّله الله . ولكنّه اُورد على الاستدلال بها على عدم التحريف ، بوجوه اُخر من الإشكال : الإيراد الأوّل : أ نّه لا دليل على كون المراد من الحفظ فيها هو الحفظ عن (1) فى ص 269 ـ 295. (2) المصدر السابق. (3) سورة الطلاق 65: 10 ـ 11 . صفحه 217 التلاعب والتغيير والتبديل ، بل يحتمل : أوّلاً : أن يكون المراد من الحفظ هو العلم ، فمعنى قوله ـ تعالى ـ : (وَ إِنَّا لَهُ لَحَـفِظُونَ) : إنّا له لعالمون ، فلا دلالة فيها حينئذ على عدم التحريف بوجه ، ولا تعرّض لها من هذه الحيثيّة ، وقد ذكر هذا الاحتمال المحقّق القمّي في كتاب «القوانين»(1) . وثانياً : أ نّه على تقدير كون المراد من الحفظ هو الصيانة ، لكن يحتمل أن يكون المراد هو صيانته عن القدح فيه ، وعن إبطال ما يشتمل عليه من المعاني العالية ، والمطالب الشامخة ، والتعاليم الجليلة ، والأحكام المتينة . والجواب : أ مّا عن الاحتمال الذي ذكره المحقّق القمّي (رحمه الله) ، فهو وضوح عدم كون الحفظ ـ لغةً وعرفاً ـ بمعنى العلم ; فإنّ المراد منه هو الصيانة ، وأين هو من العلم بمعنى الإدراك والاطّلاع ؟! ومجرّد الاحتمال إنّما يقدح في الاستدلال إذا كان احتمالاً عقلائيّاً منافياً لانعقاد الظهور للّفظ ، ومن الواضح عدم ثبوت هذا النحو من الاحتمال في المقام . وأمّا عن الاحتمال الثاني ، فهو أنّه إن كان المراد من صيانته عن القدح والإبطال هو الحفظ عن قدح الكفّار والمعاندين ـ بمعنى أ نّه لم يتحقّق في الكتاب قدح من ناحيتهم بوجه ، والسبب فيه هو الله تبارك وتعالى ; فإنّه منعهم عن ذلك ـ فلا ريب في بطلان ذلك ; لأنّ قدحهم في الكتاب فوق حدّ الإحصاء ، والكتب السخيفة المؤلّفة لهذه الأغراض الشيطانيّة كثيرة . وإن كان المراد أ نّ القرآن لأجل اتّصاف ما يشتمل عليه من المعاني بالقوّة والاستحكام والمتانة ، لا يمكن أن يصل إليه قدح القادحين ، ولا يقع فيه تزلزل (1) قوانين الاُصول: 1 / 405 ، المقصد الثاني من الباب السادس ، قانون 2 . صفحه 218 واضطراب من قبل شبه المعاندين ، فهذا المعنى وإن كان أمراً صحيحاً مطابقاً للواقع ، إلاّ أنّه لا يرتبط بما هو مفاد الآية الشريفة ; ضرورة أنّ ما ذكر إنّما هو شأن القرآن ووصف الكتاب ، والآية إنّما هي في مقام توصيف الله تبارك وتعالى ، وأ نّه المنزل للكتاب العزيز ، والحافظ له عن التغيير والتبديل . وبعبارة اُخرى : مرجع ما ذكر إلى أنّ القرآن حافظ لنفسه بنفسه ; لاستحكام مطالبه ، ومتانة معانيه ، وعلوّ مقاصده ، والآية تدلّ على افتقاره إلى حافظ غيره ، وهو الله الذي نزّله ، فأين هذا من ذاك ؟! فتدبّر جيّداً . الإيراد الثاني : أنّ مرجع الضمير في قوله : ( وَ إِنَّا لَهُ لَحَـفِظُونَ) إن كان المراد به هو كلّ فرد من أفراد القرآن من المكتوب والمطبوع وغيرهما ، فلا ريب في بطلانه ; لوقوع التغيير في بعض أفراده قطعاً ، بل ربما مزّق أو فرّق ، كما صنع الوليد(1) وغيره . وإن كان المراد به هو حفظه في الجملة ، كفى في ذلك حفظه عند الإمام الغائب ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ فلا يدلّ على عدم التحريف في الأفراد التي بأيدينا من الكتاب العزيز ، والقائل بالتحريف إنّما يدّعيه في خصوص هذه الأفراد ، لا ما هو الموجود عند محمّد وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين (2) . والجواب : أنّ القرآن ليس أمراً كليّاً قابلاً للصدق على كثيرين ، بحيث تكون نسبته إلى النسخ المتكثّرة كنسبة طبيعة الإنسان إلى أفرادها المختلفة ، وكانت لها أفراد موجودة ، وافراد انعدمت بعد وجودها ، أو يمكن أن توجد ، بل القرآن هو الحقيقة النازلة على الرسول الأمين ، التي قال الله في شأنها : (إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ فِى (1) الأغاني: 7 / 49 ، آداب الدنيا والدين: 500 ـ 501 ، الكامل في التاريخ: 4 / 307 ، الجامع لأحكام القرآن: 9/350 ، فوات الوفيات: 4 / 257 ، خزانة الأدب: 1 / 328 ـ 329 . (2) فصل الخطاب الباب الثاني في ذكر أدلّة القائلين بعدم تطرّق التغيير مطلقاً ، الأوّل: 336 . صفحه 219 لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (1) والقرآن المكتوب أو الملفوظ إنّما هو حاك عن تلك الحقيقة ، وكاشف عمّا اُنزل في تلك الليلة المباركة ، ومن المعلوم أ نّها ليست متكثّرة متنوّعة ، ومرجع حفظها إلى ثبوتها بتمامها من دون نقص وتغيير ، وكون الحاكي حاكياً عنها كذلك ، وهذا مثل ما نقول : إنّ القصيدة الفلانية محفوظة ; فإنّ معناها أ نّ الكتب الحاكية عنها أو الصدور الحافظة لها حاكية عنها بأجمعها ، وحافظة لها بتمامها ، كما لا يخفى . الإيراد الثالث : ما ذكره المحدّث المعاصر من أنّ آية الحفظ مكّية ، واللفظ بصورة الماضي ، وقد نزل بعدها سور وآيات كثيرة ، فلا تدلّ على حفظها لو سلّمنا الدلالة (2) . والجواب : واضح ; فإنّ الناظر في الآية العارف بأساليب الكلام يقطع بأنّ الحفظ إنّما يتعلّق بما هو الذكر الذي هو شأن القرآن بأجمعه ، فكما أنّ صفة التنزيل صفة عامّة ثابتة لجميع الآيات والسور بملاحظة نفس هذه الآية الشريفة ، ولا يكاد يتوهّم عاقل دلالتها على اتّصاف الآيات الماضية بذلك ، فكذلك وصف الحفظ والمصونيّة . الإيراد الرابع : ـ وهو العمدة ـ أنّ القائل بالتحريف يحتمل وجود التحريف في نفس هذه الآية الشريفة ; لأنّها بعض آيات القرآن ، فلاحتمال التحريف فيه مجال ، ومع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستدلال ، فكيف يصحّ الاستدلال بما يحتمل فيه التحريف على نفسه ؟ وهل هذا إلاّ الدور الباطل؟! . والجواب : أنّ الاستدلال إن كان في مقابل من يدّعي التحريف في موارد مخصوصة ; وهي الموارد التي دلّت عليها روايات التحريف ، فلا مجال للمناقشة (1) سورة القدر 97 : 1 . (2) فصل الخطاب ، الباب الثاني في ذكر أدلّة القائلين بعدم تطرّق التغيير مطلقاً ، الأوّل: 337 . صفحه 220 فيه; لعدم كون آية الحفظ من تلك الموارد على اعترافه ; ضرورة أ نّه لم ترد رواية تدلّ على وقوع التحريف في آية الحفظ أصلاً . وإن كان في مقابل من يدّعي التحريف في القرآن إجمالاً ; بمعنى أنّ كلّ آية عنده محتملة لوقوع التحريف فيها ، وسقوط القرينة الدالّة على خلاف ظاهرها عنها . فتارةً: يقول القائل بهذا النحو من التحريف بحجّية ظواهر الكتاب ، مع وصف التحريف . واُخرى: لا يقول بذلك ، بل يرى أنّ التحريف مانع عن بقاء ظواهر الكتاب على الحجّية ، وجواز الأخذ والتمسّك بها ، ويعتقد أنّ الدليل على عدم الحجّية هو نفس وقوع التحريف . فعلى الأوّل : لا مجال للمناقشة في الاستدلال بآية الحفظ على عدم التحريف ; لأنّه بعدما كانت الظواهر باقية على الحجّية ، ووقوع التحريف غير مانع عن اتّصاف الظواهر بهذا الوصف ، كما هو المفروض ، نأخذ بظاهر آية الحفظ ، ونستدلّ به على العدم كما هو واضح . وعلى الثاني : الذي هو عبارة عن مانعيّة التحريف عن العمل بالظواهر والأخذ بها ، فإن كان القائل بالتحريف مدّعياً للعلم به ، والقطع بوقوع التحريف في القرآن إجمالاً ، وكون كلّ آية محتملة لوقوع التحريف فيها ، فالاستدلال بآية الحفظ لا يضرّه ، ولو كان ظاهرها باقياً على وصف الحجّية ; لأنّ ظاهر الكتاب إنّما هو حجّة بالإضافة إلى من لا يكون عالماً بخلافه ; ضرورة أنّه من جملة الأمارات الظنّية المعتبرة ، وشأن الأمارة اختصاص حجّيتها بخصوص الجاهل بمقتضاها . وأ مّا العالم بالخلاف المتيقّن له ، فلا معنى لحجّية الأمارة بالإضافة إليه ، فخبر الواحد مثلاً الدالّ على وجوب صلاة الجمعة إنّما يعتبر بالنسبة إلى من لا يكون عالماً بعدم الوجوب . وأمّا بالإضافة إلى العالم ، فلا مجال لاعتباره بوجه ، فظاهر صفحه 221 آية الحفظ ـ على تقدير حجّيته أيضاً ـ إنّما يجدي لمن لا يكون عالماً بالتحريف ، والبحث في المقام إنّما هو مع غير العالم . وإن كان القائل به لا يتجاوز عن مجرّد الاحتمال ، ولا يكون عالماً بوقوع التحريف في الكتاب ، بل شاكّاً ، فنقول : مجرّد احتمال وقوع التحريف ـ ولو في آية الحفظ أيضاً ـ لا يمنع عن الاستدلال بها لعدم التحريف ، كيف ، وكان الدليل على عدم حجّية الظواهر والمانع عنها هو التحريف ، فمع عدم ثبوته واحتمال وجوده ، وعدمه كيف يرفع اليد عن الظاهر ، ويحكم بسقوطه عن الحجّية ؟ بل اللاّزم الأخذ به والحكم على طبق مقتضاه ، الذي عرفت أنّ مرجعه إلى عدم تحقّق التحريف بوجه ، ولا يستلزم ذلك تحقّق الدور الباطل ; ضرورة أنّ سقوط الظاهر عن الحجّية فرع تحقّق التحريف وثبوته ، وقد فرضنا أنّ الاستدلال إنّما هو في مورد الشكّ وعدم العلم . ومن الواضح: أنّ الشكّ فيه لا يوجب سقوط الظاهر عن الحجّية ما دام لم يثبت وقوعه ، فتدبّر جيّداً . وقد انقدح ممّا ذكرنا تماميّة الاستدلال بآية الحفظ ، والجواب عن جميع الإشكالات ، لا سيّما الأخير الذي كان هو العمدة في الباب . الدليل الثاني : قوله ـ تعالى ـ : ( وَ إِنَّهُ لَكِتَـبٌ عَزِيزٌ* لاَّ يَأْتِيهِ الْبَـطِـلُ مِنبَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيم حَمِيد) (1) ، ولا خفاء في ظهوره في أنّه لا يأتي الكتاب العزيز الباطل بجميع أقسامه ، ومن شيء من الطرق والجوانب ; ضرورة أنّ النفي إذا ورد على الطبيعة المعرفة بلام الجنس ، أفاد العموم بالإضافة إلى جميع أنواعها وأصنافها وأفرادها ، فالباطل في ضمن أيّ نوع تحقّق ، وأيّ صنف (1) سورة فصّلت 41 : 41 ـ 42 . صفحه 222 حصل ، وأيّ فرد وجد ، بعيد عن الكتاب بمراحل لا يمكن له إتيانه والاتّصال إليه . ومن الواضح: أنّ «التحريف» من أوضح مصاديق الباطل ، وأظهر أصنافه ، فالآية تنفيه وتخبر عن عدم وقوعه، وبُعده عن الكتاب . مضافاً إلى أنّ توصيف الكتاب بالعزّة يلائم مع حفظه عن التغيير والتنقيص ، كما أنّ قوله ـ تعالى ـ في ذيل الآية : (تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيم حَمِيد) الذي هو بمنزلة التعليل للحكم بعدم إتيان الباطل الكتاب يناسب مع بقائه ، وعدم تطرّق التحريف إليه ; فإنّ ما نزل من الحكيم لا يناسبه عروض التغيير ، ويكون مصوناً من أن تتلاعب به الأيدي الجائرة ، ومحفوظاً من أن تمسّه الأفراد غير المطهّرة . وقد اُورد على الاستدلال بوجوه من الإشكال (1): الإشكال الأوّل : أنّه قد ورد في تفسير الآية روايات دالّة على أنّ المراد منها غير ما ذكرنا ، مثل : رواية علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال : «لا يأتيه الباطل من قبل التوراة ، ولا من قبل الإنجيل والزبور ، ولا من خلفه ، أي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله» (2) . ورواية مجمع البيان عن الصادقين (عليهما السلام) : «أنّه ليس في أخباره عمّا مضى باطل ، ولا في أخباره عمّا يكون في المستقبل باطل» (3) . والجواب : أنّ اختلاف الروايتين في تفسير الآية ، وبيان المراد منها ـ ضرورة (1) ذكر هذه الاشكالات صاحب فصل الخطاب في الباب الثاني في ذكر أدلّة القائلين بعدم تطرّق التغيير مطلقاً ، الثاني : 338 . (2) تفسير القمي: 2 / 266 ، وعنه تفسير كنز الدقائق: 9 / 212 ، والبرهان في تفسير القرآن: 4 / 792 ح9450 ، وبحار الأنوار: 17 / 209 ح12 و ج92 / 13 ح4 . (3) مجمع البيان: 9 / 24 ، وعنه تفسير كنز الدقائق: 9 / 212، والبرهان في تفسير القرآن: 4 / 792 ح9449 . صفحه 223 أنّه لا يكاد يمكن الجمع بينهما ; فإنّ الإخبار عمّا مضى لا يرتبط بالتوراة والإنجيل والزبور ، والإخبار عمّا يكون في المستقبل لا يلائم الكتاب الذي يأتي من بعده ـ دليل على عدم حصر الباطل في شيء من مفادهما ، وأ نّهما بصدد بيان المصداق ، ولا دلالة لهما على الحصر أصلاً . وعليه: فظهور الآية في العموم ، وعدم تطرّق شيء من أقسام الباطل وأفراده إليه واضح لا معارض له بوجه . الإشكال الثاني : التأمّل في صدق الباطل على ورود التحريف عليه ، خصوصاً بعد ملاحظة وحدة المراد منه فيما سبق القرآن أو لحقه ; إذ لا يتوهّم في الباطل الذي بين يديه ذلك ، فيكون ما في خلفه كذلك . والجواب : من الواضح أنّ كون التحريف من أظهر مصاديق الباطل ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ، وتعلّق النفي بالطبيعة المعرفة يفيد العموم على ما ذكرنا ، ولا مجال لملاحظة وحدة المراد ; فإنّ الحكم لم يتعلّق بالأفراد حتّى تلاحظ وحدة المراد ، بل بنفس الطبيعة في السابق واللاّحق ، كما هو غير خفيّ . الإشكال الثالث : أنّه لا يظهر في شيء من الكتب الموضوعة في تفسير القرآن ، تفسير الآية بما ذكر ، ولا احتمله أحد من المفسِّرين ، وإليك نقل بعض كلمات أعلامهم : قال الشيخ الطوسي(قدس سره) في محكي التبيان : قوله ـ تعالى ـ : ( لاَّ يَأْتِيهِ الْبَـطِـلُ . . .) قيل في معناه أقوال خمسة : أحدها : أ نّه لا تعلّق به الشبهة من طريق المشاكلة ، ولا الحقيقة من جهة المناقضة ; وهو الحقّ المخلص الذي لا يليق به الدنس . ثانيها : قال قتادة والسدِّي : معناه لا يقدر الشيطان أن ينقص منه حقّاً ولايزيد فيه باطلاً . ثالثها : أ نّ معناه لا يأتي بشيء يوجب بطلانه ممّا وجد قبله ولا معه ، ولا ممّا صفحه 224 يوجد بعده . وقال الضحّاك : لا يأتيه كتاب من بين يديه يبطله ، ولا من خلفه ; أي ولا حديث من بعده يكذبه . رابعها : قال ابن عباس : معناه لا يأتيه الباطل من أوّل تنزيله ، ولا من آخره . خامسها : أ نّ معناه لا يأتيه الباطل في إخباره عمّا تقدّم ، ولا من خلفه ولا عمّا تأخّر (1) . وقال السيِّد الرضي في محكيّ الجزء الخامس من تفسيره المسمّى بـ «حقائق التأويل» في تفسير قوله ـ تعالى ـ : ( . . .بِكَلِمَة مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ . . .) (2) ـ بعد ذكر سرّ تذكير الضمير فيه ، وتأنيثه في قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَـئـهَآ إِلَى مَرْيَمَ) (3) ـ ما لفظه : «وإذا نظرت بعين عقلك بانَ لك ما بين الموضعين من التمييز البيّن والفرق النيّر ، وعجبت من عمائق قعر هذا الكتاب الشريف الذي لا يدرك غورها ، ولاينضب بحرها ; فإنّه كما وصفه سبحانه بقوله : (لاَّ يَأْتِيهِ الْبَـطِـلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ) (4) . ومن أحسن ما قيل في تفسير ذلك : «إنّه لا يشبه كلاماً تقدّمه ، ولا يشبهه كلام تأخّر عنه ، ولا يتّصل بما قبله ، ولا يتّصل به ما بعده ، فهو الكلام القائم بنفسه ، البائن من جنسه ، العالي على كلّ كلام قُرن إليه وقيس به»(5) . وبالجملة: فتفسير الآية بما ذكر في الاستدلال مخالف لما يظهر من الفحول (1) التبيان في تفسير القرآن: 9 / 129 ـ 130 . (2) سورة آل عمران 3 : 45 . (3) سورة النساء 4 : 171 . (4) سورة فصّلت 41: 42 . (5) حقائق التأويل في متشابه التنزيل: 102 ، المسألة 10 . صفحه 225 والرجال من مفسِّري العامّة والخاصّة . وعليه: فلا يبقى للتمسّك بها مجال . والجواب : أنّا قد حقّقنا في أوّل مبحث اُصول التفسير(1) : أ نّ الأصل الأوّلي في باب التفسير ، وكشف مراد الله ـ تبارك وتعالى ـ من كتابه العزيز هو ظواهر الكتاب ، وأ نّ الاعتماد في باب التفسير عليها ممّا لا ينبغي الارتياب فيه . وقول المفسِّرين لم يقم دليل على اعتباره ما لم يكن مبتنياً على تلك الاُصول ، وقد عرفت(2) أنّ ظاهر الآية تعلّق النفي بطبيعة الباطل ، وأ نّ التحريف من أوضح مصاديقه، ولا يعارض ذلك قول المفسِّرين إلاّ إذا كان مستنداً إلى بيان المعصوم (عليه السلام) ، الذي هو أيضاً من تلك الاُصول ، والظاهر عدم الاستناد في المقام ، وعلى تقديره فالروايات المستند إليها هي الروايات المتقدّمة ، وقد عرفت عدم دلالتها على حصر الباطل في مفادها ، والدليل عليه وجود الاختلاف بينها ، كما لا يخفى . الإشكال الرابع : نظيره من أنّه إن اُريد بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل جميع أفراده الموجودة بين الناس ، فهو خلاف الواقع ; للإجماع على أنّ ابن عفّان أحرق مصاحف كثيرة، حتّى قيل : إنّه أحرق أربعين ألف مصحف ، ويمكن ذلك لآحاد أهل الإسلام والمنافقين ، فليكن ما صدر من أولئك من التحريف في الصدر الأوّل من هذا القبيل ، وإن اُريد في الجملة ، فيكفي في انتفاء الباطل عنه انتفاؤه عن ذلك الفرد المحفوظ عند أهل البيت (عليهم السلام) . والجواب عنه قد تقدّم في الأمر الأوّل ، والتكرار موجب للتطويل . الدليل الثالث : ما أفاده بعض الأعاظم في تفسيره المسمّى بـ «الميزان في تفسير القرآن» وحاصله : أنّ من ضروريّات التاريخ أ نّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) جاء قبل أربعة عشر قرناً تقريباً ، وادّعى النبوّة ، وأنّه جاء بكتاب يسمّيه القرآن ، وينسبه إلى ربّه ، (1) في ص 170 ـ 185 . (2) فى ص 221 ـ 222. صفحه 226 وكان يتحدّى به ويعدّه آيةً لنبوّته ، وأ نّ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي جاء به ، وقرأه على الناس المعاصرين له في الجملة ; بمعنى أنّه لم يضع من أصله بأن يفقد كلّه ، ثمّ يوضع كتاب آخر يشابهه في نظمه أو لا يشابهه ، ويشتهر بين الناس بأنّه القرآن النازل على النبيّ (صلى الله عليه وآله) . فهذه اُمور لا يرتاب في شيء منها إلاّ مصاب في فهمه ، ولا احتمله أحد من الباحثين في مسألة التحريف ، وإنّما المحتمل زيادة شيء يسير كالجملة أو الآية ، أو النقص أو التغيير في جملة أو آية في كلماتها أو إعرابها . ثمّ إنّا نجد القرآن يتحدّى بأوصاف ترجع إلى عامّة آياته ، ونجد ما بأيدينا من القرآن ـ أعني ما بين الدفّتين ، واجداً لما وصف به من أوصاف تحدّى بها . فنجده يتحدّى بالبلاغة والفصاحة ، ونجد ما بأيدينا مشتملاً على ذلك النظم العجيب البديع ، لا يشابهه شيء من كلام البلغاء والفصحاء المحفوظ منهم ، والمرويّ عنهم من شعر أو نثر وأمثالهما . ونجده يتحدّى بقوله : (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوافِيهِ اخْتِلَـفًا كَثِيرًا) (1) بعدم وجود اختلاف فيه ، ونجد ما بأيدينا من القرآن يفي بذلك أحسن الوفاء . ونجده يتحدّى بغير ذلك ممّا لا يختصّ فهمه بأهل اللغة العربيّة ، كما في قوله ـ تعالى ـ : (قُل لَّـئـِنِ اجْتَمَعَتِ الاِْنسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا) (2) . ثمّ نجد ما بأيدينا من القرآن يستوفي البيان في صريح الحقّ الذي لا مرية فيه ، ويهدي إلى آخر ما يهتدي إليه العقل من اُصول المعارف الحقيقيّة ، وكلّيات الشرائع (1) سورة النساء 4: 82 . (2) سورة الإسراء 17 : 88 . صفحه 227 الفطريّة ، وتفاصيل الفضائل الخلقيّة ، من غير أن نعثر فيها على شيء من النقيصة والخلل ، أو نحصل على شيء من التناقض والزلل ، بل نجد جميع المعارف على سعتها وكثرتها حيّة بحياة واحدة ، مدبّرة بروح واحد ، هو مبدأ جميع المعارف القرآنيّة ، والأصل الذي إليه ينتهي الجميع ويرجع ، وهو التوحيد ، فإليه ينتهي الجميع بالتحليل ، وهو يعود إلى كلّ منها بالتركيب . ونجده يغوص في أخبار الماضين من الأنبياء واُممهم ، ونجد ما عندنا من كلام الله يورد قصصهم ، ويفصّل القول فيها على ما يليق بطهارة الدين ، ويناسب نزاهة ساحة النبوّة . ونجده يورد آيات في الملاحم ، ويخبر عن الحوادث الآتية في آيات كثيرة ، ثمّ نجدها فيما هو بأيدينا من القرآن . ونجده يصف نفسه بأوصاف زاكية جميلة ، كما يصف نفسه بأنّه نور ، وأ نّه هاد يهدي إلى صراط مستقيم ، وإلى الملّة التي هي أقوم ، ونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئاً من ذلك . ومن أجمع الأوصاف التي يذكرها القرآن لنفسه أ نّه ذكر لله ; فإنّه يذكر به تعالى بما أنّه آية دالّة عليه حيّة خالدة ، وبما أنّه يصفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ، ويصف سنّته في الصنع والإيجاد ، ويصف ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وأحكامه وما ينتهي إليه أمر الخلقة ، وتفاصيل ما يؤول إليه أمر الناس من السعادة والشقاوة والجنّة والنار . ففي جميع ذلك ذكر الله; وهو الذي يرومه القرآن بإطلاق القول بأنّه ذكر ، ونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئاً من معنى الذكر . ولكون الذكر من أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن عبّر عنه بالذكر في الآيات التي أخبر فيها عن حفظه القرآن عن البطلان والتغيير والتحريف صفحه 228 كقوله ـ تعالى ـ : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَـفِظُونَ) (1)»(2) . انتهى ما أفاده ملخّصاً . وهو وإن كان غير خال عن المناقشة ; ضرورة أنّ ما أفاده إنّما يجدي لنفي الزيادة الكثيرة، أو النقيصة المتعدّدة في مواضع متكثّرة، كما يدّعيه القائل بالتحريف، المستند إلى الروايات الكثيرة الدالّة عليه . وأ مّا احتمال زيادة يسيرة أو نقيصة يسيرة كما فرضه في أوّل البحث ، فالدليل لا يثبت نفيه ، ولا يجدي لدفعه أصلاً . أفيكفي هذا الدليل لإثبات أ نّه لم تسقط كلمة «في عليٍّ» بعد قوله : (بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ) (3) ؟ فإنّه على كلا التقديرين ـ سواء كانت هذه الكلمة موجودة أم لم تكن ـ لا يختلّ شيء من أوصاف القرآن ، ولا يوجب نقصاً في التحدّي ، ولا خللاً في الجهات المتعدّدة التي يدلّ عليها القرآن من اُصول المعارف وكلّيات الشرائع ، وتفاصيل الفضائل ، ونقل القصص والإخبار بالملاحم ، وبالتالي كونه ذكراً ، الذي هو ـ كما اعترف به ـ أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن ، إلاّ أ نّ له مع ذلك صلاحيّة للتأييد ممّا لا ينبغي الارتياب فيه . ثمّ إنّ هذه الاُمور الثلاثة الدالّة على عدم التحريف ، ممّا يمكن التمسّك بها من نفس الكتاب العزيز . الدليل الرابع : الحديث المعروف المتواتر بين الفريقين ، الدالّ على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) خلّف الثقلين : كتاب الله والعترة ، وأخبر أ نّهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض ، وأ نّ التمسّك بهما موجب لعدم تحقّق الضلالة أبداً إلى يوم القيامة(4) . (1) سورة الحجر 15: 9 . (2) الميزان في تفسير القرآن: 12 / 104 ـ 106 . (3) سورة المائدة 5: 67 . (4) نصّ الحديث كما في بعض المصادر هكذا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يتفرّقا حتّى يردا عليَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ؟ ». سنن الترمذي: 5 / 663 ح3797 ، ورواه مسلم في صحيحه: 4 / 1492 ح2408 والحاكم في المستدرك على الصحيحين: 3 / 160 ح4711 وغيرهما، فليراجع كتاب الله وأهل البيت (عليهم السلام) في حديث الثقلين . وانظر بعض مصادر حديث الثقلين عند الإماميّة: كالكافي: 1 / 294 قطعة من ح3، وإرشاد المفيد: 1 / 233، وأمالي الصدوق: 500 ح686، وأمالي المفيد: 135 ح3، وأمالي الطوسي : 162 قطعة من ح268، ووسائل الشيعة: 27 / 33 ـ 34 ح9، وبحار الأنوار: 23/ 104ـ 166 ب7، وغيرها من كتب العامّة والخاصّة ، وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في ص172، وتأتي في ص248 و 288 . صفحه 229 وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف على عدم تحريف القرآن المجيد من وجهين : الوجه الأوّل : أنّ القول بالتحريف يستلزم عدم إمكان التمسّك بالكتاب ، مع أنّ الحديث يدلّ على ثبوت هذا الإمكان إلى يوم القيامة ، فيكون القول بالتحريف الملازم لعدم الإمكان باطلاً; لمخالفته لما يدلّ عليه الحديث ، وعدم إمكان الجمع بينه وبينه . فهاهنا دعويان لابدّ من إثباتهما : الدعوى الاُولى : استلزام القول بالتحريف ; لعدم إمكان التمسّك بالكتاب العزيز ، ولتوضيح الاستلزام وثبوت الملازمة نقول : إنّ الكتاب العزيز ـ كما تقدّم(1)سابقاً في بعض مباحث الإعجاز ـ ليس الغرض من إنزاله ، والغاية المترتّبة على نزوله ، ناحيةً خاصّةً وشأناً مخصوصاً ، وليس التعرّض فيه لخصوص فنّ من الفنون التي يختصّ كلّ منها بكتاب ، وكلّ كتاب بواحد منها ، بل هو جامع لفنون شتّى ، وجهات كثيرة ، فتراه متعرّضاً لما يرجع إلى المبدإ من وجوده وتوحيده ، وصفاته العليا ، وأسمائه الحسنى ، وأفعاله وآثاره ، ولما يرتبط بالمعاد من ثبوته (1) في ص106 . صفحه 230 وخصوصيّاته ، والسعادة والشقاوة ، والجنّة والنار ، وأوصافهما ، وأوصاف الداخلين فيهما وخصوصيّاتهم ، ولما يتعلّق بالأنبياء ، وعلوّ مقامهم ، ونزاهة ساحتهم ، وشموخ مقامهم ، وما وقع بينهم وبين اُممهم ، ولما يرجع إلى الفضائل الخلقيّة ، والمَلَكات النفسانيّة ، ولما يعود إلى بيان الأحكام العمليّة ، والشرائع الفطريّة ، ولغير ذلك من الجهات والشؤون . والغرض الأقصى الذي بيّنه الكتاب هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وإيصالهم إلى المرتبة الكاملة من الإنسانيّة ، والدرجة العالية : المادّية والمعنويّة . وعليه: فمعنى التمسّك بمثل هذا الكتاب ـ الذي ليس كمثله كتاب ـ هو الاستفادة من جميع الشؤون التي وقع التعرّض فيه لها ، والاستضاءة بنوره الذي لاتبقى معه ظلمة ، والاهتداء بهدايته التي لا موقع معها للضلالة ، ولا يخاف عندها الجهالة ، فلو لم يكن ما بأيدينا من الكتاب عين ما نزل على النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ونفس ما خلّفه في اُمّته ، وحرّضهم على التمسّك به ، والخروج بسببه عن الضلالة . فكيف يمكن التمسّك به إلى يوم القيامة ؟ وكيف يمكن أ نّ الضلالة منفيّة مؤبّدة ؟ فإنّ الكتاب الضائع على الاُمّة بسبب التحريف ، ودسّ المعاندين ـ ولا محالة كان الغرض من التحريف إخفاء بعض حقائقه وإطفاء بعض أنواره ـ لا يصلح أن يكون نوراً في جميع الاُمور ، وسراجاً مضيئاً في الظلمات كلّها ، ضرورة أنّه يلزم أن يكون التحريف حينئذ لغواً ، مع أنّه كان لغرض راجع إلى إخفاء مقام الولاية أو غيره من الاُمور المهمّة ، التي كان تعرّض الكتاب لها منافياً لغرض المحرّفين ، ومخالفاً لنظر المعاندين ، فلا يبقى حينئذ مجال لبقاء إمكان التمسّك بالكتاب مع وجود التحريف . الدعوى الثانية : دلالة الحديث الشريف على إمكان التمسّك بالكتاب العزيز ، ولا يخفى وضوح هذه الدلالة لو كان الحديث دالاًّ على الأمر بالتمسّك ، وإيجاب الرجوع إليه ; ضرورة اعتبار القدرة في متعلّق التكليف مطلقاً ، أمراً كان أو نهياً ، صفحه 231 فمع عدم إمكان التمسّك لا يبقى مجال لإيجابه والحكم بلزومه . وأمّا لو لم يكن الحديث بصدد الإلزام وجعل الحكم الإنشائي التكليفي ، ولم تكن الجملة الخبريّة مسوقة لإفادة التكليف والإيجاب ، بل كانت في مقام مجرّد الإخبار والحكاية عن الواقع ، وأ نّ الأثر المترتّب على التمسّك بالثقلين هو رفع خوف الضلالة وارتفاع خطر الجهالة ، وعدم الابتلاء بها إلى يوم القيامة ، فدلالته حينئذ على إمكان التمسّك به لأجل الانفهام العرفي ، والانسباق العقلائي ; فإنّ المتفاهم من مثل هذا التعبير في المحاورات العرفيّة ثبوت الإمكان في الشرط في القضيّة الشرطيّة الخبريّة . مثال ذلك : أ نّك إذا قلت مخاطباً لصديقك : «إذا اشتريت الدار الفلاني يترتّب عليه كذا وكذا» لا يفهم منه إلاّ إمكان الاشتراء ، ولا يعبّر بمثل هذه العبارة إلاّ في مورد ثبوت الإمكان ، ومع عدمه يكون التعبير هكذا : «إن أمكن لك الاشتراء» . مضافاً إلى ثبوت خصوصيّة في المقام ; وهو كون الكتاب ميراثاً للنبيّ الذي يكون خاتم النبيّين ، ويكون حلاله وحرامه باقيين إلى يوم القيامة ، فهل يمكن أن يكون مع ذلك غير ممكن للتمسّك ؟ وهل يتّصف حينئذ بأ نّه خلّفه النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وكان غرضه من ذلك إرشاد الاُمّة وهداية الناس إلى طريق الهداية ، والخروج من الضلالة ؟ فعلى تقدير عدم دلالة مثل هذا التعبير على ثبوت وصف الإمكان في غير المقام ، لا محيص عن الالتزام بدلالته عليه في خصوص المقام; للقرائن والخصوصيّات الموجودة فيه . فانقدح من جميع ذلك تماميّة الاستدلال بالحديث الشريف من الوجه الأوّل ، الذي عرفت ابتناءه على الدعويين الثابتتين . نعم ، يمكن أن يورد على الاستدلال به من هذا الوجه شبهات (1) لا بأس (1) أشار إلى بعضها في فصل الخطاب ، الباب الثاني، الأمر الخامس: 340ـ 341 . صفحه 232 بإيرادها والجواب عنها ، فنقول : والجواب : وضوح الفرق بين التمسّك بالعترة ، والتمسّك بالكتاب ; فإنّ التمسّك بالشخص ـ ولو مع حياته وحضوره ـ معناه اتّباعه والموالاة له ، والإطاعة لأوامره ونواهيه ، والأخذ بقوله ، والسير على وفقه وعلى سيرته ، ولا حاجة في ذلك إلى الاتّصال به ، والتشرّف بمحضره ، والمخاطبة معه ، بل يمكن ذلك مع موته ، فضلاً عن غيبته ، ومن هذه الجهة نحن متمسِّكون بهم جميعاً في زمن الغيبة ، وأيّ تمسّك أعظم من تعظيم الفقهاء الراوين للحديث ، والأخذ بقولهم ، اتّباعاً لما ورد في التوقيع الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب ، الدالّ على وجوب الرجوع في الحوادث الواقعة إلى رواة الحديث ، معلّلاً بكونهم حجّته وهو حجّة الله على الناس (1) . (1) نصّ الحديث هكذا : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، كمال الدين: 484 قطعة من ح4، الغيبة للطوسي: 291 قطعة من ح247 ، الاحتجاج: 2 / 543 قطعة من الرقم 344 ، وعنها وسائل الشيعة: 27/140 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب11 ح9، وبحار الأنوار: 53/181 قطعة من ح10. وفي منتخب الأنوار المضيئة: 228 ، والخرائج والجرائح: 3 / 1114 قطعة من ح30 عن ابن بابويه . وفي كشف الغمّة: 2 / 531 عن إعلام الورى: 2 / 271 . وفي بحار الأنوار: 2 / 90 ح13 وعوالم العلوم: 3 / 410 ح10 عن الاحتجاج . وفي ج78 / 380 ح1 عن الدرّة الباهرة: 47 . صفحه 233 وأمّا التمسّك بالكتاب; فهو لا يمكن تحقّقه مع عدم وجوده بين الاُمّة ، وكونه ضائعاً عليهم ، فكيف يعقل التمسّك به مع عدم العلم بما تضمّنه لأجل تحقّق النقيصة فيه على هذا الفرض ، فبين التمسّكين فرق واضح . الشبهة الثانية : أنّه وإن كان يعتبر في التمسّك بالكتاب وجوده وثبوته ، إلاّ أنّ هذا الوصف ثابت للقرآن الواقعي ; لوجوده عند الإمام الغائب ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ وإن لم يمكن الوصول إليه عادة . والجواب : ظهر ممّا تقدّم أنّ الوجود الواقعي للكتاب لا يكفي في إمكان التمسّك به ، بل اللاّزم أن يكون باختيار الاُمّة وقابلاً للرجوع إليه ، والأخذ به ، والسير على هداه ، والاستضاءة بنوره ، والاهتداء بهدايته ، كما هو أوضح من أن يخفى . الشبهة الثالثة : أنّ المقدار الذي تكون الاُمّة مأمورة بالتمسّك به ، هو خصوص آيات الأحكام ; لأنّها المتضمّنة للتشريع ، وبيان للقوانين العمليّة ، والأحكام الفرعيّة ، ولا بأس بأن يكون الحديث دالاًّ على إمكان التمسّك بالكتاب بهذا المقدار ، فيدلّ على عدم التحريف بالإضافة إليه ، ولا ينفي وقوعه في الآيات الاُخرى غير المتضمِّنة للأحكام . والجواب : أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّه (صلى الله عليه وآله) ليس الغرض منه مجرّد بيان الأحكام والقوانين العمليّة ، بل الغرض منه الهداية وإخراج الناس من الظلمات |